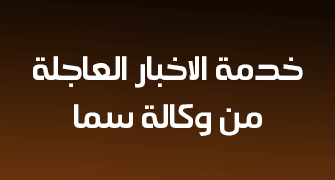في سجل فرنسا مشهد سيبقى في ذاكرة الفلسطينيين أبد الدهر لأمة شيعت ياسر عرفات الذي هو أبو الفلسطينيين في جنازة لا تقيمها عادة إلا لوداع أبطالها وقادتها الى مثواهم الأخير، وفي سجل فرنسا انه ما كان لهذا القائد العظيم ان يختار وهو بين الحياة والموت سوى هذه الأمة العظيمة نفسها كما قال عنها شارل ديغول، لكي يسلم نفسه الى اطبائها لحظة الشدة العسيرة. وفي سجلها هذه الجمهورية التي يمكن وصفها بأم التنوير انها كرمت هنا في غزة قبل سنوات الشاعر معين بسيسو تلميذ شاعرها الكبير ارغون، وان محمود درويش عاش ردحاً طويلاً من زمن المنفى في مدينتها عاصمة الأضواء باريس وكتب فيها العام 1988 قصيدته الشهيرة «أيها المارون بين الكلمات العابرة»، وعن هيلين الفرنسية بائعة الخبز.
في السجل الفرنسي جزء من الميراث الثقافي لأجيال ممتدة على مدى الكون من مثقفي العالم والبشرية منذ القرن الثامن عشر الى الآن، وبينهم اجيال من المثقفين العرب والفلسطينيين. فهذه امة لم يكن الجمال فقط حرفتها وصنعتها: العطور الباريسية التي تحاكي أسماؤها اسماء فرسان قصتها الشهيرة «الفرسان الثلاثة»، ولكنها هي التي منحت أوروبا والعالم ذوقه الجمالي والفني، بحيث كان من المعتاد استخدام الارستقراطية الروسية زمن القيصرية في بلاطات قصورها الرطانة الفرنسية.
هل كنا لنعرف العقد الاجتماعي والديمقراطية ونظام التعليم الحديث لولا جان جاك روسو؟ وهل كنا لنعرف قدسية احترام الرأي الآخر لولا فولتير؟ وهل كنا لنتعرف على عظمة الثورة وجمالها لولا «كومونة باريس» وتحطيم سجن الباستيل؟ وحيث الثورة الفرنسية الى يومنا هذا هي الثورة المرجعية التي تعود إليها كل الثورات لمعاينة مرجعيتها. الثورة التي تشكل نقطة التحول الكبرى بين النظام الإقطاعي القديم والثورة الصناعية البرجوازية ونشوء الدولة القومية الحديثة.
أوليس الى هناك اتخذ محمد علي الكبير باني الدولة المصرية الحديثة مرسلا البعثات التعليمية، ولكي نتعلم نحن ايضا كيف تعاود الحضارة سيرها الجديد من الغرب هذه المرة، بعد ان كان يقول فولتير: إنه يتوجب ان نتجه بنظرنا الى الشرق لنتعرف على الخطى التي سارت عليها الحضارة. تماما بنفس القدر الذي نتجه فيه بأنظارنا صوب حضارة الاغريق القدماء لكي نتعرف على الحكمة والفلسفة، والأسئلة الاولى التي طرحها مفكرون عباقرة عن الوجود والإجابات التي توصلوا اليها. كما نعرج في هذا المسار الى الامة الألمانية المحاربة لكي نتعرف الى هذا المزيج من ابتكار الايدولوجيات القومية والراديكالية الثورية الأممية، والطريق التي سار عليها بسمارك لتوحيد امة كانت مفككة والتغلب على ضعفها.
لقد قامت اوروبا الحديثة على أكتاف ثلاث قوى عظمى تمكنت بفعل تفوقها من السيطرة على العالم في غضون حقبة التوسع الاستعمارية، وان هذه القوى هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ولكن لأن تميزت فرنسا بتفوقها الثقافي وجاذبيتها وانفرادها بالظهور كراعية وممثلة للمسيحيين الكاثوليك في العالم، فإن تفوق بريطانيا تمثل أساسا بقوة اساطيلها البحرية ودسائس ساستها، فيما تكمن قوة ألمانيا بتفوق تقاليدها الحربية منذ عهد بسمارك ومولتيكة العجوز.
ولكن هنا عند هذا المنعطف التاريخي من انخراط فرنسا في هذا التنافس للسيطرة الرأسمالية على العالم، وهي سيطرة لم تكن عند مستهل هذه الحقبة صامتة بل عنيفة وصاخبة ومتوحشة، والتي بدأت مقدماتها في الحملة النابليونية على مصر وأوروبا لاحقاً، ولكنها تكرست فعليا مع احتلال الجزائر وشمال إفريقيا العام 1830، في نفس التوقيت تقريبا الذي كتب فيه ستاندال روايته الشهيرة «الأحمر والأسود». فإن فرنسا تظهر منذ هذا الحين كدولة مجافية ومتنكرة لتقاليدها وثقافتها ورسالتها التاريخية الى العالم، التي خطها في القرن الثامن عشر كوكبة من الفلاسفة والعباقرة المفكرين أمثال روسو وديدرو وفولتير ومونتسكيو، ولاحقاً شعراء امثال بودلير وآرغون الى جانب مثقفين أمثال البير كامي وسارتر وروجيه غارودي اندرية مالرو وماكسيم رودنسون وجاك بيرك وريجيس دوبري. بحيث بدا كما لو ان فرنسا تضحي بهذا الإرث التنويري الذي ما يزال ينير للعالم طريقه الى الحرية والإخاء والمساواة ومبدأ العدالة التاريخية، نظير ان تمثل هذا الدور الذي كان يضعها منذ أزمة الشرق الاولى زمن محمد علي والي مصر مع الغرب كذيل للامبريالية، وبقية القصة معروفة بعيد الحرب العالمية الأولى بإعادة تقطيع بلاد الشام واقتسامها مع بريطانيا وإزالة فلسطين عن الخارطة.
إن الوجه الآخر لفرنسا الذي يتمثل هنا على شكل تعارض وجهي معبد جانوس، انما هي الصورة القبيحة لشبان مغاربة وجزائريين وتونسيين يجري تجنيدهم عنوة ووضعهم في مقدمة الصفوف ليكونوا «حشو مدافع» خلال الحرب العالمية الأولى، وجيش احتلال لا يتورع عن ارتكاب مجازر ضد شعب اعزل في بنزرت في تونس والجزائر، ولا يتردد في القيام بعملية دنيئة باغتيال المهدي بن بركة المثقف والمناضل المغربي وإخفاء جثته، والمشاركة مع إسرائيل وبريطانيا في عدوان غاشم على مصر العام 1956، وان تكون المزود الأول بالسلاح بما في ذلك بناء المفاعل النووي لإسرائيل الى جانب طائرات الميراج القاذفة، التي كان لها الدور الرئيس في حسم اسرائيل حربها العدوانية على العرب العام 1967.
لقد كان سجلاً من التعارض والذي لم يحل الى الآن، ولكننا الآن اذ نقف نحن الفلسطينيين، ضحايا السياسات الامبريالية بالرغم من جراحنا مع فرنسا، في جرحها، لأننا نقف بالأساس مع ارثها الانساني الثقافي كمنارة للحضارة. فإن المسألة المطروحة اليوم على الجمهورية الفرنسية هي فلسفية أكثر منها امنية تحل بالوسائل النمطية، وهي مسألة لا تتعلق بفرنسا وحدها وإنما بأوروبا على وجه الاجمال، وهذه المسألة تتعلق أساسا بالقدرة على امتلاك الجرأة والشجاعة للكشف عن الخطأ الكبير، أساس المشكلة المعاد تفجرها على ضفتي المتوسط بين الشرق والغرب.
وكان ريجيس دوبري آخر ممثل لتلك الكوكبة من مثقفي فرنسا الثوريين، هو الذي طرح السؤال المفتاح في كتابه «الزمن والسياسة»، اذ قل لي عن أي أزمة نشأت أقل لك ما هو وضعك ومن انت؟ فعن اي ازمة يصدر الوضع الفرنسي الآن؟ وحيث تخطئ السياسات كما هي اخطاء البشر والزمن يعاقب. والراهن ايضا عن أية أزمة ينشأ التطرف الإسلامي؟ ان لم يكن عن هذا التطرف الرأسمالي الغربي الذي لم يؤد في وقت ما الى تحطيم العقل التنويري في الغرب ولكن في تحطيم الشرق بالمثل. الشرق الجنوب اليوم الذي يرمز الى تحطيمه قوارب الموت في رحلة الهجرة إلى الشمال، وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية. إذا كان هذا الشرق لم يجد امامه من بديل آخر في البحث عن هويته الثقافية والسياسية، غير هذا الخيار بعد فشل العلمانية العربية من لدن علمانية الغرب. التي وان نجحت هناك في اقصاء الكنيسة وفصل الدين عن الدولة، إلا ان الدولة الجمهورية التي نشأت عن هذا الفصل كانت دولة متوحشة ومنافقة بعلاقتها مع الشرق، وفي إخفاء مصالحها الحقيقية تحت زيف من ادعاءات مبادئ العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان.
وبحيث نجحت هذه الدولة في خدمة الرأسمالية والترويج لبضاعتها التجارية، ولم يستطيع تلامذتها العلمانيون في الشرق ليبراليين وماركسيين وقوميين الترويج لبضاعتهم الثقافية المنقولة عن الغرب. وهذه هي الأزمة التي تطل كشبح اليوم على العلاقة بين الغرب والشرق، وحيث تميزت هذه العلاقة دوما بالمنافسات او الصراعات المزدهرة، بحيث يمكن ان يرى فشل الدولة هنا كفشل للسياسات التي أدارها الغرب بنفس القدر حين يأتي بعد السيطرة الصامتة للرأسمالية، غزو الهجرة الصامتة من ريف العالم الى المدينة من الاطراف الى المركز، وحين يبدو في قلب اخطاء هذه السياسات السكوت الطويل على مظلومية الفلسطينيين وفتح باطن دولة العراق وسوريا.
ولكن لأن بقيت فرنسا هي الأكثر انجذاباً نحو الالتصاق بتقاليدها بنظر الشرق، حتى حينما لا تخفي مصالحها المناقضة لهذه التقاليد، فإن المأساة الفرنسية إنما تكمن في هذا التذبذب في انعدام الحسم بالانحياز الى ثقافتها، وبحيث يمكن ان تلام هنا لخطها المتشدد والمغالي أكثر من الغرب نفسه الممثل بأميركا وبريطانيا، من مسألة الحجاب على سبيل المثال، الأمر الذي يضعها كما لو انها تتصرف بعقلية العلمانيين الأتراك أكثر مما تقتفي علمانيتها هي نفسها.
ولكن جرأة وشجاعة ديغول في الانسحاب من الجزائر وجرأة جاك شيراك في الصداقة مع عرفات، وحتى جرأة فرنسوا هولاند في التصويت مؤخراً في مجلس الأمن لصالح فلسطين، انما هي التي تطرح أسئلة أخيرة ان كان طرف آخر يستغل هذا الشقاق او الأزمة لكيما يعاقب فرنسا، وحيث دوماً نطرح السؤال في فلسطين عن المستفيد الأكبر، وحيث دوماً هنا في هذه الحالة ليس سوى إسرائيل التي هي الطرف الوحيد المستفيد اليوم بعد الانقلاب الأوروبي عليها.
خبر : نحن وفرنسا ....حسين حجازي
السبت 10 يناير 2015 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT