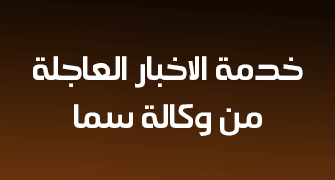سيُكتب الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2024 عندما تدخل المعارضة المسلحة العاصمة دمشق، ويغادر منها الرئيس المغضوب عليه شعبياً بلاده إلى وجهة غير معلومة، علامةً فاصلةً بين تاريخين لسورية وللمحيط حولها. فمن جانب، سقطت سورية «المفيدة»، وتبدأ مرحلة سورية «الجديدة» التي يصعب توقُّع ما سيجري فيها في الأيام المقبلة. حقبة كاملة سقطت بأخطائها الكارثية وتنازلاتها وتحالفاتها، وبدأت حقبة أخرى يسعى الكثيرون لاستشراف ما الذي ستحمله للشعب السوري ولجيرانه ولحلفائه السابقين وحلفائه الجدد. وما يُصعّب المهمة ذلك الحجم الهائل من الضبابية بشأن سرعة السقوط وانهيار المنظومة الأمنية بشكل لافت، وكيف يفكر القادة الجدد بشأن المستقبل، وكيف سيتعاملون مع رموز الجيش السابق والسياسة والمجتمع، وكيف سيستقبلون اللاجئين السوريين إن أرادوا العودة إلى بلدهم، والأهم كيف تفكر الجارة الكبرى تركيا في مستقبل سورية عموماً، ومستقبل الأكراد بصفة خاصة.
«سورية المفيدة» التي انزوت تاريخياً ومعنوياً، عبَّرت عن رؤية استراتيجية للرئيس الأسد قوامها الاكتفاء بالسيطرة الأمنية الصارمة على مناطق خفض التصعيد التي اتفقت عليها روسيا وتركيا وإيران عام 2017، وما أُضِيفَ إليها عام 2020 بخاصة حلب وريفها، وكانت تشكل ما يقرب من 60 في المائة من مساحة البلاد، يقابلها خروج مناطق أخرى من عباءة السيادة السورية، سواء لسيطرة الفصائل المسلحة في إدلب، أو قوات سورية الديمقراطية (قسد) في المناطق الكردية ذات الإدارة الذاتية وبحماية عسكرية أميركية.
هذا الاكتفاء رافقته «لا مبالاة» هائلة بجهود المصالحة السياسية مع الفصائل المعارضة سياسياً وعسكرياً، والتي تضمنها القرار الدولي 2254، أو تلك الأفكار التي خرجت من اجتماعات دول آستانة الثلاث، واستهدفت إعادة هيكلة النظام السوري بتدرُّج، ولم تجد أي تفاعل إيجابي من الأسد وحكومته. وكما رافقته إشاعة ثقافة الخوف لمن ظل تحت سيطرة الأمن السوري الباطش، والاستناد إلى أن هناك حلفاء إقليميين ودوليين يقدمون الدعم والحماية للحكومة والرئيس الأسد شخصياً، وانتظار لحظة زمنية قد تتوسع فيها «سورية المفيدة».
التغيير الميداني المأمول من قِبل المنظومة السورية الحاكمة سابقاً، حدث بالفعل، لكنه جاء في الاتجاه العكسي، بدأ بتداعيات «طوفان الأقصى» في غزة ثم لبنان بخاصة «حزب الله»، وتعثر التطبيع السوري - التركي، وانشغال كل من إيران وروسيا في حروبهما الخاصة. وكلها متغيرات كانت تستدعي رؤية مختلفة لسورية «المفيدة»، لكنها غابت عن عقول وبصائر المنظومة الحاكمة، في حين وجدتها الجارة تركيا لحظة لتغيير واقع سورية من منظور المصلحة التركية، وبَدْء مرحلة سورية «الجديدة» التي تراعي حجم الدعم والمساندة التي قُدِّمت بالفعل للمنتصرين. ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تلاه من تخلِّي الجيش السوري عن كثير من المحافظات والأقاليم تقدمت الجماعات المسلحة، منها السورية ومنها الأجنبية، مدعومة بتكتيكات عسكرية احترافية ذات صبغة تركية ظاهرة وغير مُنكرة، حيث أصبحت العاصمة دمشق، مركز الشرعية، مطوَّقة من جوانب عدة، ومع سرعة سقوط محافظات عدة بيد تلك المجموعات المسلحة، صار سقوط دمشق أمراً طبيعياً، ما أدى إلى مغادرة حاكمها ليلاً، بعد أن فقد دعم كل من ساندوه سابقاً، وفقْد دعم حاضنته الشعبية التي عانت كثيراً من أسلوب حكمه الأمني والإقصائي. ومع سقوط دمشق، خطت سورية بقديمها وجديدها خطوة واسعة المدى نحو حالة جديدة، يصعب في اللحظة الراهنة تصوُّر كامل ملامحها السياسية والأمنية.
المعضلة الكبرى في التحول الدرامي في سورية، أنه تَحَقَّقَ على أكتاف معارضة مسلحة مدعومة خارجياً، بعضها يحمل آيديولوجيات غير مرغوبة من قِبل المحيط الإقليمي، بل مرفوضة تماماً. والكل ينتظر خطواتها الأولى لحكم سورية، وكيف ستحاسب الماضي بعناصره البشرية والعملية، وكيف ستفتح أبواب التغيير السلمي الرشيد، وهو انتظار وترقُّب لا يخفي قدراً من القلق مما سيحمله المستقبل. فعلى الرغم من تعاون الفصائل المسلحة لإسقاط منظومة الأسد السياسية والأمنية، فإنها ذات تطلُّعات متباينة بشأن المستقبل السوري، ما بين دولة مؤسسات توفر الأمن والحرية لكل السوريين من دون استثناء، وتحمي سيادة البلاد وكل شبر فيها، وتعمل على خروج كل أجنبي من أراضيها، وهناك آخرون يتطلعون لاستنساخ دولة الخلافة الداعشية التي تمتد إقليمياً ولو بعد حين، بعد التمكن من سورية وأهلها.
هذا التباين في العقائد والتطلعات بين المنتصرين، وهم موزعون على أربع مجموعات رئيسية، أبرزها «هيئة تحرير الشام» التي تضم 5 فصائل كبرى، و«الجبهة الشامية» وتتضمن 5 فصائل أخرى، والقوة المشتركة، وتضم مجموعتين بارزتين عشائرياً، ما يطرح احتمال التضاد وربما اللجوء إلى السلاح لحسمه وليس بالتوافق والحوار. الأمر يثير القلق حول انقسامات محتملة تؤدي إلى تقسيم البلاد، في وقت لم تتخلص فيه من العناصر الأجنبية بتنظيماتها المختلفة. ومعروف أن بعض تلك الفصائل المسلحة موسومة بالإرهاب في كثير من الدول؛ ما يضع بدوره قيوداً على الاعتراف بحكومة جديدة تسيطر عليها عناصر ورموز موسومة بالإرهاب.
في الجوار المباشر، توجد قيود ومخاطر عدة، أبرزها ما يتعلق بتسوية الخلافات في الرؤى والمصالح بين القطبيْن الإقليمييْن المؤثريْن مباشرة على الوضع السوري، ونقصد إيران وتركيا، بخاصة أن التصنيف الذي يروج له البعض لمنتصر ومنهزم أو متراجع ليس بعيداً عن الواقع. فضلاً عن مواقف إسرائيل المتأهبة للحصول على حصة من سورية الجديدة ربما تكون في شكل سيطرة على شريط حدودي داخل الأرض السورية، ليصبح بمثابة خط دفاع أول، يصد أي تغييرات غير محسوبة من فصائل المعارضة إن أحكمت سيطرتها على البلاد، وصار لها الحكم والسلطة.