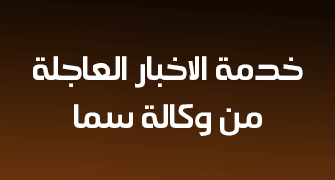قبل نحو أسبوعين، بلغتنا الأخبار عن إصابة ابن عمتي الخمسيني في شمال قطاع غزة، وتحديداً في منطقة «مشروع بيت لاهيا»، وكان يجلس أمام باب بيته، الذي رفض أن ينزح منه إلى الجنوب كما فعل كلّ أهل البيت، ويبلغون قرابة الخمسين شخصاً، حيث توجه أخوته وعائلاتهم وكذلك زوجته وأولاده وأحفاده إلى مدينة خان يونس، فيما أعلن رفضه القاطع لترك البيت المكوّن من عدّة طوابق، وأعلن انه سيعيش ويموت في هذا البيت.
كان بعيد النظر، ربّما، ويعرف ما سيؤول إليه حال النازحين من تشرّد في الخيام، وجوعٍ، وذل، ولذلك آثر البقاء بين سقف وأربعة جدران، وكلما اشتد به الحال من عسر في العثور على طعام كان يقضي يومه ويسد جوعه بأقل القليل، وبينما يقضي يومه بين جنبات البيت الواسع الذي فرغ من سكانه استمر في تتبع الأخبار، ومرّ عليه عام بأكمله، وهو على هذه الحال، لا يربطه بأهله وأحبته سوى مكالماتٍ قليلة، وربّما لم يكن يدور بخلده أن الحال سيطول، أو لعله كان يتوقع أنهم سيعودون إلى البيت قريباً، ولكن ذلك لم يحدث.
مرّ عام وشهر وبضعة أيام على هذه المقتلة التي تزداد جنوناً يوماً بعد يوم، وكأن صمت العالم يعطي إشارة للعدو المتوحش ان يتغول أكثر في دمنا، ويخوض في لحمنا، بحيث ازداد توحشاً وحرصاً على إخلاء مناطق شمال غزة لتحقيق مخططاته، ولكن ابن عمتي، الذي يقاربني سناً، رفض ان يترك منطقة «مشروع بيت لاهيا»، رغم أوامر الإخلاء المتكررة التي تلقاها السكان من خلال مكبرات الصوت، وإلقاء المنشورات والتحذيرات، التي تطلقها الطائرات المسيرة الصغيرة والتي تعدّ واحدة من أدوات القتل التي تغتال الأرواح، وتطلق التحذيرات، بل إنها وصلت إلى درجة أن تنادي أشخاصاً بعينهم بأسمائهم الكاملة، كنوع من التجبّر، وكي يستشعر الناس الخطر أكثر، فيقررون النزوح من شمال غزة.
بلغتنا أخبار الإصابة الخطرة التي لحقت به، وكانت الأنباء تتوالى بعد ذلك عن سوء وضعه الصحي، وعن وحدته هناك، حيث لا أحد من أهله حوله سوى صديق واحد ظلّ ملازماً له حتى آخر لحظة، وهنا تتجلى الصداقة في أسمى معانيها، فرغم الجوع والخوف والقهر والذل لم يتخلَ عن صديقه، وحال كل منهما أشد قسوة من الآخر، ولكن هذه هي صفات اللاجئ ابن مخيم جباليا الذي يتربى على النبل والشهامة والأصالة، فقد ظلّ يلازمه حتى اللحظات الأخيرة، وحيث قضى نحبه في المستشفى، بعد أن عاني لأيام طوال من إصابته البليغة بعد قصف المنزل المجاور لبيته، وربّما رحل، وهو يشعر بالاطمئنان انه افتدى بيته بروحه، وأن بيته وبيت والديه لا يزال قائماً، وعهده مع هذا البيت ظلّ حتى آخر رمق في حياته.
ابن عمتي الذي رحل عن ثلاثة وخمسين عاماً، رفيق الصبا والطفولة، فقد كنّا نلعب سوياً في بيتنا في خان يونس، أو في بيتهم في مخيم جباليا، حتى انتقلوا مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى ما يعرف بـ»مشروع بيت لاهيا»، وهو مشروع إسكاني كان الهدف منه إفراغ مخيم جباليا، وتقليل الكثافة السكانية فيه، في محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي لأكثر مخيمات القطاع الثمانية كثافة سكانية، والمعروف بأنه مخيم الثورة والصمود، واندلعت منه شرارة انتفاضة الحجارة في العام 1987.
عندما بلغني خبر إصابته البليغة، تذكرتُ كم كان شخصاً مهذباً وخجولاً، وقد أحسن والداه تربيته، وعلى الرغم من قرابتنا، إلا أنه لم يحاول أن يرفع رأسه يوماً لينظر في وجهي، فكان دائماً ما يقرأني السلام والتحية وهو مطرق الرأس.. أكنّ احتراماً كبيراً له ولبقية أخوته الشباب، الذين هم أبناء عمتي، التي رغم أنها لم تتلقَ تعليماً مدرسيّاً، إلا أنني أشهد لها بحسن تربية أولادها.
كنتُ دائماً أفخر بهم، حين يذكرهم الجيران والمعارف من حولهم بحسن السيرة، ولم أكن أتخيل أن النهاية ستأتي هكذا سريعاً، لأن لقاءات قليلة، وهي مناسبات عائلية، كانت تجمعنا بعد وفاة أبي وشقيقته التي هي أم هذا الوحيد، ولكننا حرصنا ان نُديم الصلة والقرابة والنسب مع أولادها، حتى جاءت الحرب اللعينة، وقلبت كل شيء.