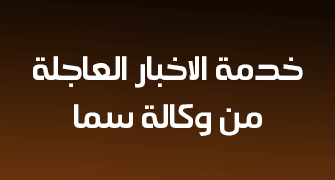يهدي أحمد رفيق عوض روايته التاسعة «الحياة كما ينبغي» (٢٠٢٢) إلى «أشجار البلاد وأهلها» ويواصل فعل تحرير فلسطين عبر الكتابة الروائية وشغفه، مثل روائيين كثر في العقود الأخيرة، بتفاصيل المكان، وهذا ما افتقده النثر الفلسطيني تقريباً منذ بداياته وحتى رواية إميل حبيبي «اخطية» (١٩٨٥)، التي عدت فيما اطلعت عليه بداية لسلسلة من الروايات التي نهج أصحابها شكلاً من أشكال المقاومة هو الدفاع عن صلة الفلسطيني بالمكان الذي حاولت الصهيونية أن تبرهن للعالم أنه «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض».
طبعاً لا ننكر في جنس القصة القصيرة قصص محمد نفاع. حقاً إن جمال الحسيني في «على سكة الحجاز» (١٩٣٢) وغسان كنفاني في «العاشق» كتبا عن أرض مأهولة وشعب مقاوم، ولكن التركيز على التفاصيل ظهر بقوة في «اخطية» وفي قصص نفاع.
منذ ١٩٩٣ وعودة عدد كبير من كتاب المنفى بدأت تفاصيل المكان تظهر.
مريد البرغوثي «رأيت رام الله» وفاروق وادي «منازل القلب» ومحمود شقير «ظل آخر للمدينة» وأكرم هنية «شارع فرعي في رام الله» وأسعد الأسعد في «دروب المراثي» وصافي صافي في «زرعين» وغيرهم وغيرهم كتبوا عن رام الله والقدس وزرعين ومؤخراً أحمد رفيق عوض عن قريته يعبد وجارتها عرابة والمدينة القريبة منهما جنين ومخيمها، ولا يكتفي أحمد بوصف المكان؛ بيوته وسهوله وشوارعه، إذ يكتب أيضاً عن أشجاره على غرار محمد نفاع المتميز في الكتابة عن الأرض ونباتاتها.
كما ذكرت فإن أحمد يهدي روايته إلى «أشجار البلاد وأهلها» ويبدأ كل مقطع من مقاطعها الثلاثة والعشرين باسم شجرة يكون لها حضور في المقطع الذي أدرج تحتها وغالباً ما تكون هناك صلة بين العنوان والمقطع إذ تسهم الشجرة غالباً بفعل مقاومة كما أهل البلاد، فثمة شجرة تحمي المقاوم من الانكشاف وتوفر له مظلة الاختباء، وثمة شجرة تطعمه من ثمرها حين يعز الطعام فلا يجد المقاوم ما يأكله، وهذه الأشجار تفاجئ أحياناً رجل المخابرات الإسرائيلي أبو السعيد فيكتشف من خلال شغف الفلسطينيين بالأشجار أنه لم يعد يعرفهم ويتساءل عن سبب الشغف، وأحياناً يغدو مثلهم يحب شرب الشاي بالميرمية ما يدفع المسؤولين عنه إلى التساؤل إن أخذ يتعاطف معهم ويتماثل في طريقة حياته مع حياتهم، وهذا يسبب له المشاكل، وتمثل الضحية والتماهي معها، لكثرة اختلاطه بها اختلاطاً ناجماً عن ملاحقتها، فكرة أساسية في الرواية لم تظهر من قبل ظهورها في هذه الرواية.
ربما هنا نتذكر رواية الكاتب الإسرائيلي (ديفيد غروسمان) التي ترجمت إلى العربية «ابتسامة الجدي» وضابط المخابرات فيها.
تختلف صورة القرية الفلسطينية وأهلها عن صورتهم في رواية سابقة للكاتب «قدرون « (١٩٩٥) اختلافاً كلياً، فالصورة السابقة سلبية تماماً والصورة الجديدة إيجابية بالكامل، وهذا ولا شك يدفع قارئ الروايتين للاجتهاد، وقد لا يجد مشقة في الحصول على إجابة يطمئن إليها، فما شهدته فترة الاحتلال الإسرائيلي في ٧٠ القرن ٢٠ من هدوء وتوجه للعمل في المصانع الإسرائيلية أعقبه انتفاضة فمرحلة سلام فانتفاضة ثانية فهدوء مشوب بالحذر تتخلله أحداث أشبه بانتفاضات قصيرة، وفي فترات الانتفاضات يشهد المجتمع الفلسطيني حالة من التكاتف والتعاطف وتصبح صورته مختلفة عن صورته في فترات الهدوء والاسترخاء.
إن «الحياة كما ينبغي» تؤرخ لفترة اشتباك مع المحتل عاشتها قرية الكاتب يعبد وعاشتها مدينة جنين ومخيمها.
يمكن إدراج الرواية عموماً ضمن الأدب الفلسطيني المقاوم بالمفهوم الذي شاع لأدب المقاومة، وقد قرأنا نماذج منه في أدبيات نهاية ٧٠ القرن ٢٠ وبداية ثمانينياته حيث كتب غريب عسقلاني رواية «الجوع « (١٩٧٩) وزكي العيلة قصصه «الجبل لا يأتي» (١٩٨٠).
إن مناخ هذه الأعمال الثلاثة وأعمال أخرى يبدو واحداً على الرغم من المسافة الزمنية التي تفصل بينها.
يقاوم الفلسطيني المحتل فيحاصر مخيمه وتحاصر قريته وتقتحم بيوته ويحطم أثاثها ويعتقل أبناؤه ولا يرضخ. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يقرأ المرء في الرواية عن المجتمع الإسرائيلي واختلافه يقرأ ما قرأ شبيهاً له في روايات تلك المرحلة وهنا أخص قصة سميح القاسم الطويلة «الصورة الأخيرة في الألبوم» (١٩٧٩) حيث يتعالى اليهودي الغربي الاشكنازي على اليهودي الشرقي.
إن والد روتي في قصة القاسم يكره السفارديم ويتعالى عليهم، وزوجة أبو السعيد الاشكنازية تتعالى عليه هو اليهودي الشرقي وتكون مخبرة عليه تنقل تفاصيل حياته إلى المسؤولين عنه، وكما انتهت قصة القاسم بانتحار روتي تنتهي رواية أحمد بقتل أبو السعيد زوجته وانتحاره، ولكن الفلسطيني في رواية أحمد لا يبحث عن مخرج في الرحيل إلى خارج فلسطين كما فعل أحد شخوص قصة سميح، وإنما يصمد في أرضه منتمياً إلى المقاومين في المخيم.
«الحياة كما ينبغي» هو العنوان فكيف ينبغي أن تكون عليه الحياة؟
يقدم لنا راشد المحمود ما وجب أن يكون عليه، وهو خريج جامعي عمل موزعاً للمواد الغذائية حين عزت الوظيفة وحدث مرة أن احتج على معاناة الفلسطينيين على حاجز من حواجز الاحتلال فألصقت به تهمة محاولة طعن جندي إسرائيلي وهكذا قدم إلى المحاكمة وسجن خمس سنوات، وحين خرج، ومع أنه تزوج وأنجب راضخاً لرغبة والديه، قرر مقاومة الاحتلال، فالحياة ينبغي أن تكون كما قرر «أحب خياري هذا، أحب حياتي هكذا، أحب هذا المخزن وهذا الكانون وهذه البندقية، هذه حريتي، بالضبط، هذه حريتي».
أحمد رفيق عوض و"الحياة كما ينبغي"..عادل الأسطة
الأحد 28 أغسطس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT