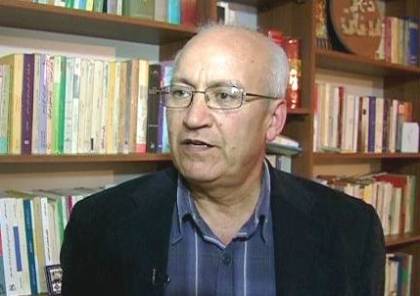مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بيرزيت أهم مؤسستين لإنتاج المعرفة بحسب رئيس جامعة بيرزيت بشارة دوماني، الذي افتتح مؤتمر مؤسسة الدراسات بعنوان «الثقافة الفلسطينية اليوم، تعبيرات وتحديات وآفاق». مدخل إنتاج المعرفة يسمح بالتوقف عند علاقة السياسي بالثقافي، وقبل ذلك يحدد عناوين المعرفة الممثلة بالكتاب والفنون الأدائية والبصرية والعمارة والأدب وغير ذلك. إنتاج المعرفة عبر الكتاب لا يزال وسيلة أساسية في البناء المعرفي وفي تشكيل العقل الواعي النقدي. وعندما تحدث دوماني عن إنتاج المعرفة كان يعني ما يقول، فقد صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 25 كتابا خلال عامي الجائحة. هذا العدد اذا ما أُضيف له المجلات الفصلية الثلاث، التي تتضمن محاور ودراسات لا تقل أهمية عن الكتب، فإن الرصيد المعرفي المنتج ينوف عن الأربعين كتاباً، بينها مجلدان يحويان كتباً ومقالات وبعض مخطوطات محمد روحي الخالدي، ومجلد دليل إسرائيل في العام 2020، ومجلد الفن الفلسطيني المعاصر، ومجلد «لفتا سجل شعب».
انتاج المعرفة في عالم يعتمد في تطوره العلمي والاقتصادي والثقافي على المعرفة التي فجرتها الثورة الرقمية واحدثت تحولات هائلة فيها، اصبح من أهم التحديات التي تواجه الشعوب وتحديداً الشعوب التي تعاني من الاستعمار والاحتلال والاستبداد والتخلف. المشكلة لا تزال قائمة في بلداننا العربية منذ عصر النهضة وحتى الآن. مشكلة التعاطي مع المعرفة واستخداماتها في مجال التغيير والتطوير، وفي بناء وعي تحرري يزيل العوائق المفروضة على العقل، ويؤسس قاعدة وحاملاً للتحرر. المشكلة الأساس في الاطلاع على المعارف أولاً وقبل تحديد حجم الاستخدام الخلاق لها. المؤتمر المشترك بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وجامعة بيرزيت، والمميز في موضوعاته المطروحة على بساط البحث لم يثر اهتمام ولا فضول المستوى السياسي الأول والوسيط بفروعه الرسمية والمعارضة الذي لم يحضر ولم يشارك عبر الزووم، مع أن المستوى السياسي في امس الحاجة لمعرفة خطاب آخر غير خطابهم، ومعرفة رؤى وأفكار من خارج الصندوق المغلق، فضلاً عن أهمية سماعهم للأسئلة وللنقد الموجه لهم بعد الإخفاق السياسي شديد الوطأة.
مقاطعة السياسيين لـ 33 ورقة متنوعة يعني انهم «ختموا» السياسة وليسوا بحاجة الى المزيد والجديد، في الوقت الذي يحتلون فيه مركز صناعة القرار، ويقودون السفينة الى المجهول. لا يمكن تسمية الانقطاع بين منتجي المعرفة وبين مستهلكي المعرفة ومن بينهم المستوى السياسي الأول والوسيط، إلا بالتثبيت على وعي الماضي الذي انقضى بخطابه وأدواته وأفكاره وأساليب ترجمته. لا يمكن تسمية ذلك إلا بعدم تحمل المسؤولية في أبسط أشكالها وصورها وهي التسلح بزاد المعرفة. قد يبرر السياسيون الإحجام عن المشاركة في هذا المؤتمر وفي مؤتمرات سابقة لأطراف متعددة الانتماءات، بأن مؤسساتهم تنتج المعرفة التي يحتاجونها وكفى. هذا التبرير لا يصمد طويلاً عند الاطلاع على المنتج المعرفي والفكري الهزيل وعلى المؤسسة التي تنتجه والبنية الشائخة المؤسسة على معايير الولاء وتغليب المصلحة الذاتية على المصلحة العامة. في كل الأحوال لا يمكن التغاضي عن أي منتج معرفي مهما كان مختلفاً سواء ظهر في الخندق المعادي او صدر عن معارضين من أوساط النخبة الثقافية والمعارضة الداخلية. إن تجاهل المنتج المعرفي له صلة بغياب الحوار والسجال والمنافسة والتجديد وتعاقب الأجيال، وتكريس بنى منفصلة عن مصالح المواطنين، وله علاقة باعتماد معايير الولاء كمقياس أول.
ولا يقتصر غياب التداول والتفاعل مع المنتج المعرفي على الطبقة السياسية الرسمية والمعارضة. فقد كشف مؤتمر مؤسسة الدراسات وجامعة بيرزيت عن إحجام جهاز التدريس الجامعي والطلبة -باستثناءات قليلة -عن الحضور والتفاعل مع المنتج المعرفي. وعندما يتكرر الإحجام عن المشاركة في مؤتمرات وندوات وأنشطة سابقة داخل الحرم الجامعي وخارجه. فهذا يفسر انفصال مكونات النخبة الاكاديمية عن بعضها البعض، يفسر خواء الحياة الثقافية والفكرية داخل الحرم الجامعي رغم وجود كفاءات منتجة للمعرفة، ويفسر الصراع الفئوي بين الكتل الطلابية التي تتحول في بعض الأحيان الى جماعات تحاول ان تفرض سلطتها، متجاوزةً بذلك مكانةَ ودور الجامعة كمنارة لاحتضان الفكر التحرري الديمقراطي والتنويري والحق في الاختلاف وفي ممارسته، ومكان تزول داخله كل القيود المفروضة على العقول.
ما سبق، يطرح أهمية إنتاج معرفة، يتحول منتجوها من خلال السجال والعصف الفكري المتراكم الى رافعة للإنجاز وللتحرر الوطني والاجتماعي وللديمقراطية، وتتحول الجامعة الى منارة يعاظم فيها الأكاديميون/ات والطلبة انتاج المعرفة.
طرح عددٌ لا بأس به من المشاركين في مؤتمر الثقافة المذكور مجموعة من السرديات كانت بمثابة إضاءات في غاية الأهمية. ومن أكثرها جذباً رحلة بحث الفنان عبد الرحمن قطناني ابن مخيم شاتيلا عن هويته من خلال الفن مستخدماً ألواح الصفيح والكرتون والأواني القديمة والخرق البالية، في ما يشبه هندسة تراكمية لمعاناة المهجرين. ويصل الى نتيجة يقول: أنا أنتمي الى يافا موطن جدي وليس للمخيم. البحث عن الحرية كان يعني البحث عن الجذور، عن الهوية بعيداً عن المفاهيم الموروثة.
وتحدث علي مواسي عن مجتمع هبة القدس الذي أنتج زخماً من التعبيرات الثقافية ضمن حقول ووسائط متعددة، وقد توقف عند مغزى النشيد الساخر ( إن أن ) دبور وشاب جديد. النص الغنائي الذي يعبر عن بلاغة الغضب واللامعقول لكنه يقدم وحدة أولاد القدس وتكون فيه الجماعية محل احتفاء وتمرد. وتوقف أيضاً عند فيلم «رمال» الذي استطاع أثناء الهبة والعدوان على غزة إنتاج محتوى فيلمي مدته دقيقة واحدة و24 ثانية، تصدر معظم منصات التواصل الاجتماعي. الفيلم يقدم المستوطن كآلة لا تنطق، ويسمح فقط للفلسطيني بالتحدث والتفوق الإنساني. أراد مواسي القول إن الصراع مع الاحتلال يخلق أدوات المقاومة التي تتنوع ويكون تأثيرها أشد في استقطاب الرأي العام والتغلب على ماكينات الدعاية الإسرائيلية والداعمة لها. وكانت الرسالة التي قدمت أثناء هبة القدس «آن للنكبة أن تنتهي». للحديث بقية
ملاحظات على مؤتمر الثقافة..مهند عبد الحميد
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT