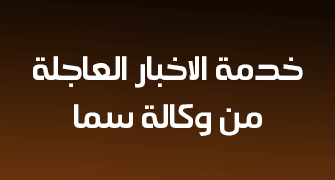كان إبريق الشاي على الفحم عماد سهرتنا التي تمتد إلى عمق الليل، وموسى يدخن بلا انقطاع، والسيد رحمه الله يشع وجهه حباً وطيبة ونوراً، وترتسم على تجاعيد وجهه وراحتيه قصص زمان وحاضر لا تمل من سماعها بل تطلب المزيد.
أجمل ما في السهرة أنه لا يخطر ببالك أن تنظر إلى ساعتك لمعرفة الوقت، لأن الوقت تسقط أهميته في هذا الجو البديع، وفي حضور هذه الصحبة البهيجة. على يمين البيت المبني حديثاً، يلتصق بناء صخري قديم مهجور، هو بيت العائلة القديم. وكانت والدة موسى وإخوته يحثونه على إصلاحه وتجديده ليكون بيته الذي يقيم فيه عند زيارته للضيعة. لكن انشغاله في بيروت والإعلام والسياسة كانت تفقده الحماس ليقوم بذلك. بعد عامين رأيت صورة جميلة على صفحة موسى في موقع فيس بوك للبيت وقد تم ترميمه وتحديثه، بجهد خاص من السيد رحمه الله ولمسات فنية من موسى، واتفقت مع موسى أن أقضي فيه عطلة قصيرة الصيف القادم مع زوجتي منال، التي رحلت عن دنيانا فجأة وقبل أن يأتي الصيف! مع نسمات صيفية مشبعة برائحة الصنوبر والميرمية، قبل أن يرتفع أذان العصر في جامع عيناتا، ردد المؤذن عبارات مديح للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد علمت أن السيد محمد حسين فضل الله كان قد اعترض على ذلك وحاول أن يثني الناس عن ذكر الإمام علي في الأذان للصلاة، لكن دعوته كانت صرخة في واد، إذ رغم مكانته وعلمه ووزنه رحمه الله، إلا أن ما توارثه الناس يبقى أقوى أحياناً مما يدعو إليه الإصلاحيون. وقد أخبرني موسى بطرفة يتداولها العامة تقول: أن رجلاً اعترض على إضافة جملة "وأشهد أن علياً ولي الله" إلى الأذان فرد عليه المؤذن: يا زلمة نحنا بنحاول نشوف كيف بدنا نفوت الحسين بعد على الأذان، بتقلي نحذف علي؟! وعلى ذكر الأذان، كنت أجلس ذات يوم (بعد وجبة غداء فاخرة صنعتها السيدة الفاضلة أم رامي زوجة صديقي) في شرفة المنزل في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، وامتد بنا الحديث إلى وقت الغروب، فأطرق موسى مستمعاً بشغف للأذان وسألني: هل تعرف من هو صاحب هذا الصوت؟ قلت له أجل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومن لا يطرب لجمال صوته الخالد... حل المساء، واستأذنت بالمغادرة، فأصر موسى على أن يوصلني بسيارته إلى مكان إقامتي في الحمراء، وكانت السيارة في موقف السيارات تحت البناية، وهو مكان ضيق يتسع بالكاد لسيارات سكان البناية، الأمر الذي يشكل لصديقي معاناة بالغة في اصطفاف السيارة والخروج بها من هذا الإزدحام.
ويندر أن يتجنب موسى إحتكاك سيارته بالجدران أو بالسيارات الأخرى عند الدخول والخروج من الموقف، فاختار السلامة هذه المرة، وألقى لي بالمفتاح طالباً أن أتولى إخراج السيارة من مكانها الضيق، وهكذا كان. لكن معاناة سيارة صديقي لم تتوقف عند احتكاكها كل يوم بسيارات الجيران أو الجدران، فقد حضر موسى ذات يوم إلى الدوام في الفضائية التي يعمل بها حالياً، ولم يجد مكاناً يوقف فيه سيارته المرسيدس الأنيقة، إلا مساحة صغيرة في الشارع ملاصقة لحاوية قمامة كبيرة! وبعد ساعات الدوام الطويلة، خرج موسى ليجد سيارة البلدية التي تفرغ الحاويات، قد أزاحت الحاوية من مكانها، فخدشت المرسيدس في أكثر من مكان، وكسرت مرآتها! في هذا المكان الذي جمعنا لبرهة من الزمن، كان لي مكتب فسيح مساحته أضعاف المكان الذي يجلس فيه موسى.
وحدث أن اتصلت به مراسلة إحدى الفضايات اللبنانية لتجري معه مقابلة لتقريرها الذي تعده عن أوضاع الخادمات الفلبينيات والأريتيريات والسيرلانكيات. والسبب في اختيار موسى لإجراء المقابلة هو أنه مؤلف رواية رائعة عنوانها: (سيرلنكيتي الفلبينية). فكلمني طالباً أن تكون المقابلة في مكتبي ليكون هناك مدى للكاميرا، فرحبت.
كانت المراسلة الشابة ترتدي قميصاً خفيفاً بفتحة عنق واسعة تجعله ينزلق عن معظم ظهرها ومساحة لا بأس بها عن منطقة الصدر أيضاً. وكان يعلو كتفها وشم (تاتو) يمتد حتى منتصف ظهرها.
لم أغادر مكتبي وبقيت في مكاني أواصل عملي، لكن أثناء تسجيل المقابلة لفت انتباهي الوشم، وليس ما كان يدور من اسئلة وأجوبة. بعد انتهاء المقابلة، وانصراف المراسلة، سألني موسى: كيف كانت المقابلة؟ هل كانت إجاباتي مفهومة ومقنعة؟! قلت له: ما رأيك أنت فيما قلت؟ فأجاب: بصراحة لقد شتت (التاتو) انتباهي...فقلت له: وهذا ما حدث لي أيضاً!