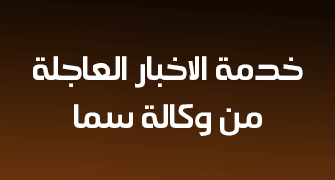كتب يوسف الشايب:
"لم تكن زائفة مثل أي امرأة تضع مولودها، كان الرمان بلل ساقيها، وكان ثوبها مدبغاً بدم الولادة. لقد وقفت وهي تتكئ على ريحها الصلب دون أن تتمايل، ووجهت فاها إلى السماء ... للمخيم والمدينة قائلة: يا أهل البلد رشيقة جابت ولد" .. هذه واحدة من القصص المحورية لكتاب "مكان مؤقت"، سيرة عدنان ضميري، الصادر حديثاً عن "طباق للنشر والتوزيع" في رام الله.
وسرد ضميري حكاية "يا أهل البلد رشيقة جابت ولد"، بقوله: أمي فلاحة من طولكرم وأصلها من كفر زيباد تزوجت العام 1943 في الضمايرة القريبة إلى قيسارية، ولكنها كانت في لواء حيفا، وتقع على شاطئ البحر أو على خد الموج .. والداي رحمهما الله أنجبا اثنتين من البنات في عامين متتاليين 1944 و1945، وفي نيسان من العام 1948 هجّروا من "الضمايرة"، فعادت أمي إلى طولكرم، وبالنسبة لها لم تعتبرها تهجيراً على عكس والدي، لكن المفارقة أن العصابات الصهيونية حاولت قصف "ماتور" الماء في طولكرم فجاءت القذيفة في "حاكورة القص" فاستشهد شقيقتاي الاثنتين جراء هذا القصف، كانت إحداهما في سن الثالثة، والأخرى تبلغ من العمر عاماً ونصف العام.
وتابع ضميري الحكاية: بعد سنوات أنجبت أمي ابنتين أخريين، فالمجتمع والمحيطون، وبكل قسوة، أطلقوا عليها لقب "رشيقة أم البنات" .. عندما جاءها المخاض "على لوح الزينكو" في المخيم، في الثالث من آب للعام 1954، أبلغتها المرحومة أم محمد القابلة (الداية) بأن المولود ذكر .. تقول أمي إنها وقفت، وهي "تشر دماً"، وقفت على رجلها العرجاء، وصاحت بأعلى الصوت "يا أهل البلد رشيقة جابت ولد"، ومن هنا بدأت الحكاية التي حين قصصتها قبل سنوات للشاعر د. المتوكل طه، شجعني على توثيق هذه الحكاية وغيرها من حكايات سيرية شكلت مجموع هذا الكتاب .. أتذكره كان يقول لي "إنت واحد مجرم .. اكتب هذا الحكي"، وهو ما كان في "مكان مؤقت".
"أتذكر أبناء جيلي ونساء الحارة في المخيم ينادينني عدنان ابن رشيقة، لم أكن أخجل من الاسم، ومن بعض العادات في الأرياف أنهم يغضبون إذا ما عرفت أسماء أمهاتهم أو أخواتهم، حتى أن بعضهم لا يكتب اسم البنت في بطاقة الدعوة للزواج أو الخطوبة، وعندما تصدر بطاقة دعوة الزواج باسم الأم للنساء يكتبون عليها حرم فلان ولا يعلنون اسم الأم".
في حكاياته الذاتية يعود ضميري إلى ما رواه له والده وعمته عن "الضمايرة" المهجرة، وزيارته الأولى لها في العام 1983، حين أبهره شجر الكينا، مسترجعاً طرائف الشعر الشعبي الذي حفظه صغيراً من سليم، وشهامة احمد الجبر الذي عرفته المنطقة كشيخ عرب وقائد عشيرة، استشهد في طولكرم بعد أن أطلق عليه مجهول النار قرب المقبرة الغربية في طولكرم، وهو عائد إلى بيته مساء في كانون الثاني 1948.
ويعرج على مرحلة "الإعدادية"، حيث "لم تكن الكهرباء وصلت إلى المخيم"، فيدرس مع سميح رجا وأحمد شحادة وغسان البديري، على نور أعمدة الكهرباء في شوارع المدينة، مستعيداً من ذاكرته المتقدة شاي الأمهات، والمقعد رفيق خلف على ألواح الخشب عجلاتها (البيليا)، وحيدر العياط السبعيني يلوح بمنديله بعد برمه في الدبكة الشمالية بين الشباب، وكومة البطيخ في عريشة "أبي فخري".
وكان لشقيق البنات (أخو البنات) مهمات أخرى في المخيم حيث لا حمامات ومراحيض في البيوت .. "كان في كل حارة مرحاض عام للرجال وآخر للنساء قريبان، وأخو البنات هو من يرافق أخته في الليل إلى المرحاض، يحمل إبريق الماء المصنوع من التنك بـ"بعبوزته" الطويلة، وينتظرها بعيداً حتى تنتهي" .. يغني في الطريق إلى بيت الراحة كي يطرد الكلاب الضالة وجن القتيلة التي يعتقد أهل الحارة أنه يظهر في الليل قريباً من دار "عذبة" (أم حسين)، وقرب دار أم حاتم سبيتان صديقة والدته.
لا ينسى ضميري توثيق "سنة الثلجة"، وفريق "السمران"، أي فريق كرة القدم في مخيم طولكرم، و"الحمّام الجماعي"، و"عيادة الوكالة"، و"شجرة الكينا"، وحكايات المدرسة وأزقة المخيم، والبيارة، وبيت الطين، و"مطعم الوكالة"، و"البقجة"، والدنانير العشرة، وماتور الماء، وصولاً إلى حرب العام 1967، ورحلة المعتقل.
ومن آثار رحلة الاعتقال، سطر ضميري ما أسماه "عقد القران المأسور"، ليصف: لمحتها من بعيد على شبك الزيارة الذي يخفي تقاسيم الوجوه، ويظهر مثل كرّاس الهندسة في الصفوف الأساسية، تنظر باهتمام إلى أخيها محمود في الجهة الأخرى من الشبك، لم أرَ تفاصيل وجهها في هذا الغباش الذي يسيّج الضوء كنور شمعة خافت لكنه كاف لنرى الطريق إلى القلب، وأغادر سقف الغرفة والخيال المضمخ بالفضيحة الداخلية.
وبعد حين ... "بعد الزيارة التي امتد فيها إصبعها من الشبك لأزنّرها بخاتم الخطوبة بعيداً عن أعين الحرّاس الذين قد يمنعون عملية من هذا النوع (تمس الأمن) بعرفهم، مددت إصبعي لتضع فيها خاتم الرباط المقدس، وبالكاد أدخلت إصبعي من ثقب الشبك الصغير، فلم تنبس شفتاها ولا شفتاي بحرف، بل تحجرت الكلمات قبل وصولها حافة الشفة، لينقذ الموقف دمعة سقطت من عينها التي خطف الأطفال براءة صدقهم منها، سقطت لتعانقها دمعتي من خلف الشبك، الذي شكل (لوج) منصة العروسين بلا زغاريد وبلا غناء"، فكانت الخطوبة على شبك الزيارة في السجن، تلتها موجة من الرسائل.
تحدث ضميري عن مرحلة ما بعد الاعتقال، وعمله كحلاق تتلمذ في السجن على يد الأسير سعدي المحتسب، وكيف "كان الزبون الذي كنت أتوقع منه أن يدفع خمسة شواقل مثلاً، يدفع عشرة شواقل، وكأنه يتضامن مع هذا السجين الذي تحرر من اعتقاله وضاقت عليه السبل فأراد أن يساندوه، ولو ببضعة شواقل إضافية"، حتى بات مع الوقت صالون الحلاقة مكاناً "يجتمع فيه أبناء الحي والأصدقاء".
ولم يغفل الضميري في "سيرة الجنرال .. المخيم والاعتقال" الحديث عن تجربته في مجالس الطلبة، والمناظرات ما بين الكتلة الوطنية أوائل الثمانينيات وهي الذراع الطلابي لفصائل منظمة التحرير في مواجهة الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة الإخوان المسلمين، وتسلمه لاحقاً رئاسة مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في تشرين الثاني من العام 1982، كما لم يغفل الحديث عن "المسلخ" أو "سجن الفارعة"، فعمله في الصحافة التي أتاحت له مساحة داخل القدس، حين عمل في المكتب الفلسطيني للخدمات الصحافية وكان يمثل وكالة الأنباء الفلسطينية في الوطن.
وما بين اعتقال وآخر، واصل ضميري سرد سيرته عبر حكاياته وحكايات الآخرين من الأسرى، أو من عمل معهم أو التقاهم خلال عمله الصحافي، أو حين اعتقل لعدة أشهر دون تهمة، وخضع للسجن الإداري بتهمة الانتماء لحركة فتح، هو الذي عثر بين أوراقه لاحقاً على مقالة لصديقة زهير الدبعي يتحدث فيها عن ابنه حسين، وكيف فقد النطق بعد "اعتقالي أمامه، وهو يصرخ وجنود الاحتلال يقومون بتعصيب عينيّ وتكبيل يديّ، ويقذفونني في الشرفة".
سريعاً تنقل ضميري للحديث عن مؤتمر مدريد، وحلم الدولة، والأمن والإعلام، وانتفاضة الأقصى، وعن الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والأرض، ووالده، والرئيس محمود عباس، ليؤكد "لم أكن أكتب قصائد أو خواطر أو خربشات، إلا بعد أن أخفي مسدسي ونياشين الجنرال، وأتسلل إلى الكلمات كما الفدائي في دوريته عبر النهر، للوصول إلى الضفة الأخرى المحتلة والمغتصبة، بكل ثقوبها التي تشرّ دماً وزنابق وصبّاراً وكثيراً من القمح والسمسم والريحان، واصفاً كتابه بـ"مرويتي، أو مرافعتي إلى التاريخ، أقدمها بمحض إرادتي، لأنني أؤمن بأن كلاً منا لديه قصة تصلح لأن تكون حكاية تشبه حياتنا الفلسطينية الشائكة والمربكة والقاسية، والمليئة بالأمل أيضاً".