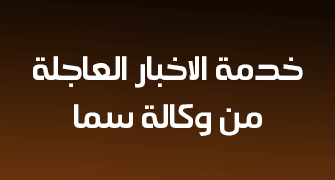في نهايات الأعوام يكثر الحديث عن الأمنيات ويتم تحليل الماضي في محاولة للوصول لبدايات الحاضر الجديد، مثل من يقف على جسر يحاول أن يلتقط مشهد النهر والضفة في آن. وفي نهايات الأعوام تغزونا رياح الغد كأنها تحمل لنا بشارات مرغوبة، وتحمل بعيداً عنا مخاوف مقلقة، لكننا عميقاً في داخلنا ننظر للخلف نحاول الإمساك بتفاصيل العام الذي مضى، لأننا مجبولون على الحنين، وعلى اللايقين. وفي نهايات الأعوام يكثر الحديث عن الحصاد وعن الثمار الكثيرة التي حملتها أشجار الشهور المنقضية، وعن الخيبات والفشل، وعن العجز والتراجع، فنحن دائمو البحث عن العبارات المناسبة للتعبير عما حدث، فيما عيوننا تشخص في الأفق تحاول فك طلاسم الغد.
وفي السياسة يظل هذا الحديث صحيحاً، غير أنه أبعد شيء عن الصحيح؛ من باب «أبغض الحلال». لأننا في السياسة عادة ما نشعر بعجز عن فهم ما يجري. أو كأن البحث عن هذا الفهم هو دليل عجز، لأن الأساس أن نفهم من الأساس. لأن الفهم ليس بحاجة لبحث حتى نجده. وفي السياسة لابد أن يكون ما جري موضع تحليل الجميع الذي شارك فيه أو كان مادته، لكن أيضاً، في السياسة، نكون الأعجز عن القيام بعمليات البحث. ليس لأننا لا نرغب في ذلك، أو نحن راغبين عنه، ولكن لأن ثمة في جوهر السياسة قوة طردية تجعل أي اقتراب من التخوم محاولة اختراق غير مرغوبة.
وقراءة الواقع، تعكس الكثير من حالة الإرباك تلك. حالة تشعر الفرد بأنه غريب في عالم مألوف. إنه الإحساس الأكثر قسوة حين يتعلق الأمر بوجودنا كأفراد. فأنت تشعر أنك غريب في عالم غريب عنك، يبدو هذا مألوفاً رغم قسوته. فانت تعشر بأنك غريب في مدينة لا تعرف فيها أحداً، فتُعمل كل طاقاتك وجهدك من أجل أن تتحرر من هذا الإحساس أو من أجل أن لا تعود غريباً فتّكون أصدقاء ومعارف حتى تزول حالة «الغربة: تلك. أما أن تشعر أنك غريب في عالم مألوف بالنسبة لك فهذا سياق لا تقدر على الفكاك منه. عالم تعرف كل تفاصيله، كل شيء فيه، لكنك في الوقت ذاته تشعر بغربة قاتلة. حالة الإرباك تلك لا تنبع فقط من حالة الشعور بالغربة تلك، ولا من عجزك عن الفهم، بل من حالة الإلتباس التي تميز المشهد والسياق العام الذي تعيشه والذي تحاول أن تفهمه. فأنت في مهمة مركبة. من جهة تحاول أن تعيش عالمك وأن تكون جزءاً منه، ومن جهة أخرى تحاول أن تفهمه، تسعى لأن تكون جزءاُ من عملية خلقه. بالطبع لابد من أن تتنازل عن جزء في سبيل تحقيق الجزء الآخر، فأنت لا تقدر أن تفهم وتعيش في نفس اللحظة. وعليه تصبح، بطريقة أو بأخرى، مسؤولاً عن حالة العجز التي تعيشها، بل أنت سبب بطريقة أو بأخرى لها. وتصبح استدامتها ناجمة عن قصورك الذاتي لأنك تصبح عاجزاً عن وقف عجزك. يشبه هذا مقولة ألبير كامو بأن الإنسان ليس مذنب تماماً فهو لم يبدأ التاريخ، وهو ليس بريء تماماً طالما أنه يكمله. وصناعة العجز ضمن هذا الفهم تصبح مسؤولية الفرد بقدر ما هي مسؤولية السياق العام الي أنتج العجز ذاته. إنه السياق الواسع الذي تهمين عليه المؤسسة الرسمية بما تضمه من نظام سياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي، عادة ما يكون الفرد ضحيته. لكن إلى جانب ذلك فإن العجز وليد عدم المقدرة على رفض العجز ذاته والبحث عن مخرج يكون عنواناً لهذا الفرض.
أساس الدراما كما عرّفها أرسطو كان العجز الذاتي للبطل. البطل غير القادر على إدراك عجزه هو سر نجاح بناء الشخصية الدرامية، بل هو عنصر التشويق الذي يأتي لنا بغير المتوقع في البناء الدرامي. نحن بطريقة أو بأخرى شخصيات في رواية ما أو مسرحية ما، على الأقل أسمها دراما أو مسرحية الحياة. البطل لا يكون مكتملاً. والكتّاب غير الموهوبين هم فقط من يبحثون عن البطل المكتمل. البطل الذي لا يخطئ والذي يقوم بكل شيء. العجز بالمعني الفني جزء من الكمال الفني. فتردد هاملت وعدم مقدرته على اتخاذ قرار أساس قوة شخصية هاملت، كما أن إصرار أوديب على تجاوز النبوءة هو سبب وقوعه في شركها.
لكننا ليسنا كذلك. فنحن شخوص حقيقية في عالم حقيق. ونحن لسنا مثل هاملت أو الملك لير أو أوديب أو أبو الخيزران نحاول تجاوز واقعنا. نحن حتى لا ندرك عجز هذا الواقع، ولا ندرك مقدار مساسه بتفاصيلنا. نحن منشغلون بمحاولة الإفلات من موجه، وتجنب المزيد من الانهيارات حتى بتنا نتمنى أن يظل واقعنا كما هو لا يتغير فيه شيء، لأننا لسنا واثقين إلى أي اتجاه يمكن أن يتغير أو ما هي مآلات هذا التغير، وإلى اين سيصل. بتنا مرعوبين من أي تغير لأننا نخاف من أن يقود إلى واقع أكثر سوءاً، وأن يكون أكثر ألما. وصرنا ندعو إلي بقاء الحال.
يشبه هذا حالنا عندما نضحك كثيراً. وقتها نخاف من الغم والحزن الذي سيتلو هذا الضحك. ويظل أساس كل ذلك هو التخلص من عجزنا، والبحث عن القوة الكامنة فينا، إنها القوة القادرة على الواقع رغم كل قسوته. فالفرد رغم كل ذلك هو جوهر التغير المنشود، والواقع هو عامل متغير بطبيعته. لكن هذا لا يتحقق دون أن ندرك هذه القوة ونعرف سر تغيير هذا الواقع.
في نهايات الأعوام رغم كل هذا يظل التفكير في الماضي وفي البحث عن المستقبل مشروعاً، بل ربما هو الشيء الوحيد الذي نجيد فعله فيما يذهب عام في سرمدية الأبد ويأتي عام آخر مثل زهرة تفوح رائحتها للتو.
خبر : في البحث عن مخرج ...د.عاطف أبو سيف
الإثنين 11 يناير 2016 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT