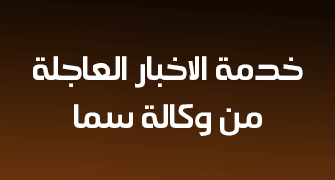كتب يوسف الشايب:
وجد د. إيهاب بسيسو، أن رواية «مصائر: كونشيرتو الهولوكوست والنكبة»، جديد الروائي الفلسطيني المقيم في بريطانيا ربعي المدهون، أن الأخير في مشروعه الروائي عادة ما يستخدم عناوين تحمل الدهشة لرواياته التي تطرح رؤى مغايرة .. وقال، وهو يقدم للرواية في حفل إطلاقها بمتحف محمود درويش بمدينة رام الله، أول من أمس: في روايته السابقة «السيدة من تل أبيب» قدم أسلوباً لافتاً ومتفرداً في التعامل مع النص السردي لفكرة العودة بعد سنوات أُخرى من الغياب، والتعرف على المكان، وهو في تلك الرواية غزة التي هاجر منها قبل النكسة، أما «مصائر» الرواية فتتبع بذكاء وحرفية سردية مصائر فلسطينية متعددة، وتتضمن عمقاً ملحوظاً، و»الكونشيرتو» هنا، وهو نوع من الموسيقى السيمفونية، تقنية لهذا العمل، وكأن «كونشيرتو» الحدث لا يزال متواصلاً، ولم ينقطع.
وأضاف بسيسو، وهو يقدم للرواية، قبل الحوار مع المدهون: الرواية تحمل مفردات الحنين، ولكنه ليس الحنين الذي اعتدنا عليه في السرد الفلسطيني، بمعنى الحنين الذي يعود إلى البدايات، أي ما قبل النكبة، محاولاً استئناف الحياة التي قطعت وبترت بفعل الحدث السياسي، وهو في هذه الرواية النكبة .. الحنين في «مصائر» ربعي المدهون، هو الحنين الفعّال أو المتفاعل، فالكاتب لا يتوقف فقط أمام المكان، بل يفتح أسئلة المصير، والبقاء، والهجرة، وغيرها أمام هذا المكان، في رحلة عودة إلى ما قبل النكبة، بتقنية سردية أراد لها أن تحمل حركات «الكونشيرتو».
وتابع بسيسو في تحليله للرواية: حركات «الكونشيرتو» تبدأ بالحركة الأولى أو الافتتاحية، عبر شخصية إيفانا الفلسطينية الأرمنية، مروراً بابنتها جولي من الضابط البريطاني الذي أحبته وتزوجته فترة الانتداب البريطاني، وهاجرت معه مع بدء ملامح النكبة إلى بريطانيا، إضافة إلى زوجة وليد دهمان، وهو نفس الشخصية الروائية التي كانت من الشخصيات المحورية بل لربما بطل رواية «السيدة من تل أبيب»، ووليد دهمان نفسه، في رحلة إلى الجذور، وبالتحديد إلى عكا، حيث كتبت إيفانا وصيتها بحرق جثتها ونثر نصف رمادها في فضاء لندن، والنصف الآخر في فلسطين، فما كان أمام وليد دهمان وزوجته جولي إلا عشرة أيام، هي الفترة الزمانية للرواية، قبل أن ينتقل الفضاء المكاني إلى مدن متعددة في الجغرافيا الفلسطينية: حيفا، وعكا، والقدس، ويافا، وغزة، والمجدل عسقلان، بل ويتجاوز الجغرافيا الفلسطينية إلى مونتريال في كندا، ليعكس تعدد «مصائر» الفلسطينيين.
وأكد بسيسو: لا يخفى على القارئ لرواية ربعي المدهون الجديدة، تأثره بإيميل حبيبي، سواء في السيرة الشخصية أو الذاتية، أو حتى في بعض اللمحات الساخرة، من خلال اللوحات السردية التي نسجها، وهذا يؤكده إلى الباقين هنا، ويذكرنا بما أراد له حبيبي أن يكون وصية خالدة، حين نقش على شاهد قبره «إيميل حبيبي .. باق في حيفا»، وهذا يحيلنا إلى جزء إضافي من المصائر التي أراد لها المدهون أن تتداخل في إيقاع موسيقي، فوظف حركات «الكونشيرتو» في السياق الروائي، ولكنه لم يكن لينجز هذا العمل الروائي المميز دون معرفة واضحة بالثقافة الموسيقية.
وختم مقدمته بالقول: هناك تفاصيل لا يمكن إغفالها، ونحن نتحدث عن الرواية، حيث قدم لوحات نقدية، وإن كانت عاجلة ومقتضبة ولكنها ذكية للانقسام الفلسطيني، ومنها حديثه عن عائلة دهمان، وكيف انقسمت إلى «فتحاويي الدهامنة»، و»حمساويي الدهامنة»، في حين أراد الروائي المدهون لنصه الجديد أن يكون مفتوحاً على معاني الحنين والذاكرة والعودة بتعدد صورها، واصفاً «مصائر» بالتجربة الروائية المميزة التي تنحت سرداً خاصاً ومغايراً حول فلسطين والنكبة، وهي رواية ذكية مغامرة جريئة ومحرضة على الأسئلة، ولا تركض خلف الشعار.
مفهوم الحنين
وبدأ الحوار مع الروائي ربعي المدهون بسؤاله عن مفهوم الحنين في رواية «مصائر»، فأجاب صاحبها: تناول موضوع الحنين بالطريقة التي وردت في رواية «مصائر»، جاء للخروج من الحالة التي اعتدنا عليها في التعاطي مع الأمور في هذا الإطار، ولكسر مفهوم الارتباط بالحنين التقليدي، والخروج من حالة البكاء على ما كان، وإعادة توظيف المكان، بعد مساءلة المكان الذي ترك أصحابه، ومساءلة أصحاب المكان الذين تخلوا عنه، وإعادة رسم الصورة مجدداً بشكل واقعي، وأكثر فهماً للقضية والمشاعر الإنسانية، ومشاعر الفلسطيني نفسه الذي يعود إلى بيته، ويتعرف عليه بخجل شديد جداً، مع أنه صاحب البيت .. حاولت الخروج بشكل آخر من الحنين المغلف ببلاغة لغوية تنقل القارئ إلى عالم آخر غير معتاد عليه، وهذا النوع من الحنين هو ما ينبغي أن نتعاطى معه بصورة فنية، وفي إطاره الفني الأدبي.
إيفانا الأرمنية الفلسطينية
وحول إيفانا الأرمنية الفلسطينية التي تزوجت من ضابط بريطاني قبل النكبة، وأنجبت منه جولي، وسافرت رفقته إلى بريطانيا عند وقوع النكبة، أجاب المدهون: في الرواية لم أحاكم إيفانا، بل هي من حاكمت نفسها، عندما قررت أن تطهر ماضيها، وتمحو من تاريخها هذه «الخيانة»، أي ارتباطها بالضابط البريطاني حين كانت في سن المراهقة، وهو ما وجدت فيه لاحقاً نوعاً من الخطيئة عملت على التخلص منها.
وأضاف: اختيار «إيفانا» كونها فلسطينية أرمنية له اعتبارات عديدة، فقد شعرت أنه من الضروري جداً، وخصوصاً في عكا، إعادة الاعتبار للأرمن الفلسطينيين كجزء من النسيج المجتمعي لعكا ما قبل النكبة، ولا أدري إن كان الأدب الفلسطيني تناول الأرمن الفلسطينيين في عمل أدبي روائي من قبل، وكذلك لاشتراك الفلسطينيين والأرمن بذات المأساة، فنحن تعرضنا لمذبحة وهم تعرضوا لمذبحة واليهود تعرضوا لمذبحة، وفي الرواية قررت التعاطي مع هذه المذابح.
الشخصيات الهامشية
وانطلاقاً من شخصية «الست معارف»، تحدث المدهون عن الدور الأساسي لشخصياته الروائية الثانوية، وقال: «الست معارف» شخصية ثانوية في الرواية، ولكني في رواياتي أتعامل مع الشخصيات الثانوية دون تهميش، فهي تقوم بدور أساسي ومحوري، ولو كان حضورها غير طاغ .. شخصياتي الروائية الثانوية دائماً أحرص على أن تكون بمستوى الشخصيات الأساسية والرئيسية، فـ»الست معارف» التي تحفظ تاريخ المدينة، وتعممه على السياح، وتقولها صراحة «من الأفضل أن نوزع المعلومات على السياح مجاناً من أن يشتروها من اليهود بمصاري»، وهي امرأة خفيفة الظل وموسوعية في آن، وتلعب دوراً محورياً كبقية شخصيات الرواية الهامشية.
مشروع في ثلاث روايات
وحول مشروعه الروائي، قال المدهون: في رواية «السيدة من تل أبيب»، كانت الفكرة الأساسية تقوم على تقديم مشهد بانورامي لغزة في لحظة زمانية معينة، وهذا برز في الفصول الأخيرة، منذ الوصول إلى معبر بيت حانون، إضافة إلى معالجة العلاقة الإنسانية ما بين الفلسطيني واليهودي، بعد نزع كل ملامح الصراع عنهما، ووضعهما أمام إنسانيتهما، ثم اختبار تصرفاتهما بعد أن عايشها الصراع بمفاهيمه وخلفياته.
وأضاف: مشروعي يقوم على الخروج بثلاث روايات، ولو قدر لي أن أعيش لأكمل الرواية الثالثة، تقدم مجتمعة صورة مغايرة أو مشهدا بانوراميا آخر لـ»فلسطينيي الـ48»، ومن هنا جاءت فكرة شخصية «باقي هناك» في رواية مصائر، هذا الرجل الذي يمثل الحالة التي عانى منها أهلنا في مناطق الـ48، والذين كانوا يعانون من قطيعة عربية، بحيث لا يقبلون استقبالهم، وعانوا من نظرة العديد من الفلسطينيين السلبية تجاههم كونهم هم «من بقوا مع اليهود» .. برأيي، وهو ما أريد أن أقوله روائياً، أن هؤلاء هم أساس البقاء، وهم البقاء نفسه، ومن هنا جاءت التسمية «باقي هناك» لشخصية رئيسية في الرواية، وليس فقط من باب التأثر بإيميل حبيبي، مع أنني لا أنكر هذا التأثر بشكل أو بآخر، لكن الأساس هو فكرة هذا البقاء.
وتابع: ما يهمني في مشروعي الروائي، النظر في كل الموضوعة الفلسطينية، من مبتدئها حتى منتهاها، في محاولة لإعادة الباقين في مكانهم (فلسطين الـ48) في السياق الحقيقي الذي ينبغي أن يكونوا فيه، فهم «الباقون هنا»، ولذلك ليس مصادفة أن يكون الإهداء إلى «باقي هناك» في المكان المتخيل، و»باقي هناك» في الواقع وفي الرواية.
وأكد: هذا المشروع تطلب مني جولة واسعة في مناطق الـ 48، لأقدم تعبيراً صادقاً عن المأساة الفلسطينية بصورة شاملة، وليس بحالات فردية، على عكس مسار غسان كنفاني في روايته «عائد إلى حيفا» .. أريد في رواياتي أن أغطي كافة المسارات دفعة واحدة، وأن أعالج المأساة الفلسطينية بشموليتها، ولهذا قمت برحلاتي العديدة، لأجل وضع شخوصي في مساراتها الحقيقية، وإعادة إحياء الجغرافيا الفلسطينية، ليست تلك الجغرافيا التي نبكي او نتباكى عليها، بل تلك الجغرافيا التي أردتها أن تخرج بصورة فنية مختلفة، لعلني أتمكن من رسم الشوارع التي تكاد تمحى أسماؤها كما ملامحها من جديد، وإعادة المكان إلى ما كان عليه، فمن يقرأ «مصائر» لا يشعر بالمهاجر ومن ترك أرضه، بل بفلسطين ما قبل العام 1948، دون الدخول في التفاصيل المملة أو اليومية.
التفاعل مع المكان
وحول التفاعل مع المكان، أشار المدهون إلى أنه لا يستطيع الكتابة كما يكتب الآخرون حول الواقع المعاش .. وقال: لكني أعتقد أن أملك قدرة في المزج ما بين الواقع والمتخيل، وهو ما يمنحني فرصة أكبر للعمل بفعالية أكثر في المساحة التي أزعم بأنني قادر على السير فيها بالمفهوم الروائي.
وأضاف: حين زرت حيفا لأول مرة، لم أشعر بالوجود اليهودي فيها، وكأنما أعيد زرع نفسي في المكان الذي كنت فيه ذات يوم، وهذا ينطبق على بقية المناطق، وخاصة المجدل عسقلان مسقط رأسي، والتي هي بالنسبة لي قصة درامية عجيبة غريبة، فعندما تذهب لتبحث عن طفولتك ولا تجدها، فهو أمر في غاية الصعوبة.
واعترف المدهون: القدس كانت من أصعب الأماكن التي تناولتها في الرواية، فأنا أمام مكان تاريخي لا تعرف حقيقة كيف تمسك به أو تحيط به، خاصة أنه كان عليّ أن أتعامل مع هذه المدينة البانورامية بمعانيها الوطنية والتاريخية والدينية وبكل ما يرافق ذلك من حنين، بعين وروح من لم يعش فيها، بل ويزورها لأول مرة منذ عقود، مع أنها كانت تشكل ذاكرته أو جزءاً منها، وكأنه يقف فجأة وجهاً لوجه أمام هذه المدينة بكل ما فيها من زخم متنوع وعميق، وعليه أن يزرع أبطاله فيها، مستذكراً الحكاية التي حدثت معه، ووثقها في الرواية، حول الجندي الإسرائيلي من أصول أثيوبية، والذي منعه من دخول الحرم القدسي ما لم يقرأ الفاتحة، مستهجناً أن يقوم هذا الإفريقي الغريب باختبار انتمائه للمكان بقراءة سورة الفاتحة، في مشهد وصفه بالغريب، والذي يعبر عما آلت إليه القدس.
متحف المحرقة
وحول زيارة بطل الرواية وليد دهمان لمتحف المحرقة (ياد فاشيم)، المتخيل منها والواقعي، والتي وصفها بسيسو بالجريئة، أجاب المدهون: باختصار هي محاكمة من نوع خاص، وكأنني أقول لليهود أنتم لديكم متحف المحرقة، ولكن ماذا لدينا نحن؟ .. هل نعترف بضحاياكم، وما موقفنا من هؤلاء الضحايا؟.. بصورة شخصية وفنية أيضاً، أحببت أن أختبر هذا الشعور مباشرة .. أنا كاتب وروائي، وعندما أريد أن أقدم عملاً فنياً عليّ أن أتجرد من كل الاعتبارات سواء السياسية أم الدينية أم الأيديولوجية أم الشخصية وغيرها، وهذا يمنحني حرية التصرف بالنص إلى الحد الأبعد.
وأضاف: كانت الفكرة من زيارة المتحف تتعلق بالاختبار، فزرت المتحف، وهي الجزء الحقيقي المتعلق بهذا الفصل من الرواية، ولكن عندما أقف أسفل قبة المتحف التي تحمل أسماء وصور ضحايا المحرقة النازية، وتصعد بشكل هندسي إلى السماء بالتدريج، وأصعد منها لأرى غسان كنفاني، وياسر عرفات، وجميع شهدائنا أعلى هذه القبة، هنا ينطلق المتخيل ويصعد من الواقع، فعندما استدرت كانت الفكرة هي كيف يمكن للفلسطيني أن يرى الضحايا بعين الضحايا ... صحيح أنني قلت في الرواية أن وليد دهمان بكى على ضحايا النازية، وبكى عليهم لأنه يتاجر باسمهم، فخرج ليرى بعين الضحايا اليهود ضحايا دير ياسين.
وتابع: المفاجأة كانت أن هناك في المتخيل متحفا فلسطينيا للشهداء أكثر جمالاً، وأكثر أهمية، وفي موقع صاعد على الجبل، عندما تطل عليه تجد النجمة الثمانية التي اعتمدناها رمزاً ذات يوم، لتجد متحفاً راقياً وبتقنيات حديثة يخلد ذكراهم، وهي تقنيات غير متوفرة الآن، للدلالة على أن هذا المتحف قد يكون في المستقبل، في مكان وزمان غير محددين.
وفي ذات الإطار رد المدهون على بعض منتقديه من الحضور، بما أسموه برسم حالة من المساواة أو الموازنة ما بين محرقة النازي لليهود، وجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، ما أثار حالة من الجدل نابعة عن اختلاف القراءات وتعددها بين الجمهور نفسه، وبين عدد منهم وتأويل نص المدهون، بالقول: لم أقل أن الأديب لا علاقة له بالصراع وتداعياته المستمرة، ولكن أقول أنه عندما يكتب يحيّد مشاعره تلك المتعلقة بهذا الصراع، ويحاكمه فنياً ... لا أكتب سياسة، ولا أكتب أيديولوجيا، بل أكتب فناً بصيغة راقية، مذكراً بعبارة اعتبرها أساسية في هذا الإطار، وردت في الرواية، وهي «ما الفرق بين الحرق بالغاز عند الألمان والقتل بالرصاص .. ما الفرق بين الحرق بالغاز والحرق بالصواريخ في غزة» .. كنت دقيقاً جداً في معالجة هذه القضية بالتحديد، وهذا ليس من باب الدفاع عما قدمته في الرواية، فكل جملة في النص الروائي الذي قدمته في «مصائر» موزونة بدقة، فما أردت قوله أن لا فرق بين محارق الغاز النازية وبين قتل أطفالنا.
وشدد: الكاتب إن لم يكن جريئاً، وقادراً على طرح الأسئلة التي لا تطرح، وتقديم الجديد الذي لم يقدم، من الأفضل ألا يكتب .. هناك من الكتاب لديهم خمس عشرة رواية أو يزيد، ولكنهم لم يقدموا شيئاً .. لست من هواة اللهو في الكتابة، لأنني ببساطة أقدم ما أريد، وأؤكد أن على الكاتب ألا يضع نصب عينه أية حواجز، أو حسابات أيديولوجية أو سياسية، أو أن يتملكه الخوف والرعب عند الكتابة .. عندما أكتب أقدم الحد الأقصى من قدراتي الفنية، وقد أنجح وقد أفشل، وهذا الأمر يحدده النقاد، أما أن أخضع لأية مخاوف، فهو أمر غير وارد بل ومرفوض، لأنني حينها لن أقدم ما أريد، ولهذا السبب أقتحم العمل الروائي بكل جرأة .. رغم تحفظاتي على بعض ردود الفعل الغاضبة والحادة إزاء هذه الجزئية من الرواية، إلا أنني أشعر بالسعادة لأنني نجحت بعملي في استثارة مشاعرهم، ولو عبروا عنها بالغضب، فمن حق القارئ أن يحاكم النص كيفما يشاء، ومهما بلغت درجة القسوة فعلى الكاتب أن يتعامل معها بصدر رحب .. لن أتخلى عن جرأتي، وأعتقد أن استفزاز قرائي دليل على نجاح العمل في جزئية ما، لنعاني سوياً من طرح هذه الأسئلة وغيرها التي اشتملت عليها رواية «مصائر».
حوار في المجدل عسقلان
وقدم المدهون رفقة الممثلة المسرحية ميساء الخطيب، من خلف الكواليس، مقطع حوار وليد دهمان، بطل الرواية، مع والدته المقيمة في غزة، عند وصوله إلى مسقط رأسه، الذي لم يجد أيا من معالمه، بشكل مسرحي أو شبه مسرحي مؤثر، كما هو النص، الذي كان يفيض في صفحتين (54 و55) بمشاعر عولجت بتقنيات فنية من الصعب أن تمتنع أمامها دموع العين من الانهمار على الوجنتين، قبل أن يقوم بمهر روايته بتوقيعه لجمهور متحف محمود درويش، بعد أن عزف لأكثر من ساعة «كونشيترو» روائياً مبدعاً بامتياز.
خبر : المدهون يعزف "كونشيرتو" الـ "مصائر" في متحف محمود درويش
الجمعة 28 أغسطس 2015 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT