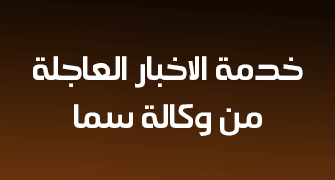كثيرة هي التفاصيل، والتي قد تشكل أسبابا تأخذنا نحو التشبث بها تفسيرا وتبريرا لواقع تضربه أزمة عاتية، هي نفسها، أي محاولة التفسير، ما يدفعنا إلى رد التفاصيل إلى الأصول وعدم الاكتفاء بالظاهري مهما كان عظم تأثيره، في محاولة الاقتراب من الأسئلة الكبري ومثالها، لماذا تعثر المشروع الوطني؟ ولماذا حقق المشروع الصهيوني انتصارا آخر؟ ولماذا وكيف جرى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية التي لم يكد شملها يلتئم إلا قليلاً؟ ولماذا انقسم الفلسطينيون سياسيا وجغرافيا، ولماذا فشلوا في تحقيق مصالحة قد تعيد بعضا من اعتبار لقضيتهم الوطنية؟ إن العودة إلى الأصول القريبة نسبيا، في مساحة تفرضها متطلبات كتابة مقال، أراها واجبة منهجيا، حتى لا نتوه في زحمة التفاصيل والفرعيات والنتائج، على حساب الكليات والأسباب والأصول. إن هذا التأسيس قد يكون محاولة لخلخلة، ولو قليلا، لما يبدو إنحرافا في الوعي أو قدرية مفرطة في تفسير الظواهر، طمعا في تفكيك أزمة عميقة، أظنها لو استمرت على ما هي عليه، سوف تفقدنا المبادرة بلا رجعة وتزيدنا انكشافا على انكشاف، وتباعدا أكثر من أي وقت مضى، بيننا وبين حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف، جوهر المشروع الوطني.
المثير أننا اعتقدنا واهمين، ان توصيف الحالة وتشخيصها مسألة إجماع لا اختلاف، وأن المشكلة تكمن في غياب الإرادت وحسب في استحضار للاحتلال وسياساته ودون إجهاد في بحث المقدمات ونتائجها في ظل عامل الزمن الذي يعيد إنتاج النتائج، مقدمات جديدة وحقائق أشد وطأة وتأثيرا، مؤزما ما هو مأزوم. وأحسب أن الدلالات والمعاني والمآلات، لحقائق لا اختلاف عليها، مختلف عليها، لم يعمل العقل فيها كما تستحق، في محاولة تعريف ما بدا أنه معرف. إنني أزعم ان ذلك فعل تأسيسي لتفسير الصيرورة ولتلمس طريق قد يعيد الاعتبار لقضية الفلسطينيين أرضا وشعبا فيما تبقى من وقت، لو كان هناك متسع من وقت.
قبل أن تحتل اسرائيل الضفة والقطاع في العام 1967، كان القطاع يخضع للإدارة المصرية والضفة الغربية بما فيها القدس كانت قد أصبحت جزءا من الممكلة الاردنية الهاشمية، ولم يكن هناك أي نوع من التواصل بينهما، إلى أن احتلت إسرائيل كليهما وأعيد توحيدهما مرة أخرى ولكن هذه المرة تحت الاحتلال وبفضله. استمر ذلك حتى العام 1994 وهو العام نفسه الذي شهد توقيع اتفاق اوسلو، والذي وعد من خلاله الفلسطينيين بوحدة أراضيهم، وللمفارقة، فإنه هو العام ذاته الذي يمكن القول وبكل ثقة، أنه قد أرسى القواعد الأساسية للفصل التدريجي بين الضفة والقطاع و"تصحيح خطأ" هو أقرب إلى كونه "ناتج عرضي" عن احتلال تلك الأراضي، يعترف به الاسرائيليين، عندما أتاحوا للفلسطينين في كلا المنطقتين إمكانيات التواصل فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين اخوانهم في الداخل الفلسطيني من جهة ثانية، وهو ما كان له دلالات ومفاعيل بالغة الأهمية على قضيتهم ونضالهم، ولاسيما إعادة اكتشاف الذات وترميم الهوية الوطنية الجامعة. كان لا بد من تصويب ذلك "الخطأ" وذلك بإعادة الأمور إلى مربعها الأول كما كانت عليه عشية الخامس من حزيران 1967، بل في حالة أشد مأساوية بفعل ديناميات "الحكم" تحت الاحتلال وما آل اليه من انقسام أفقي وعامودي أصاب الفلسطينيين في مقتل.
في اليوم الاول لاحتلالها قطاع غزة، أصدر القائد العسكري للمنطقة الجنوبية البلاغ العسكري (رقم 1)، أعلن بموجبه القطاع منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منها أو العودة اليها، وبقي ذلك الإجراء قائماً حتى نهاية الستينات، عندما منحت قوات الاحتلال سكان القطاع تصريحاً عامّاً سمح بموجبه لهم بالخروج منه، والملفت أنها لم تلغ البلاغ العسكري المشار اليه، بل استندت إليه في في منح التصريح العام. وهو ما يعني أن التصريح العام لم يكن الا استثناء لما هو أساس واصيل في العقيدة الأمنية الاسرائيلية من تقييد وتحكم في حركة الأفراد والبضائع. وبقى أصل العلاقة هو التقييد، واستثناءه هو السماح لسكان القطاع بالخروج منه وفقا لما يقرره القائد العسكري، وهو ما كان في سنوات الانتفاضة الأولى حيث جرى سحب التصريح العام مرة وإلى الأبد.
لقد سعت قوات الاحتلال من خلال السماح بخروج سكان القطاع منه إلى تحقيق أربعة، على الأقل، من الأهداف الأمنية والاقتصادية، يمكن إيجازها فيما يلي:
1- دفع سكان القطاع، ولاسيما الشباب منهم، لبيع قوة عملهم في سوق العمل الاسرائيلي، كإجراء وقائي، تجنبا لامكانية التحاقهم بحركة المقاومة المتصاعدة في القطاع، حيث شكل تسهيل خروج السكان لسوق العمل الاسرائيلي حلا "لمشكلة أمنية" شكلت كابوسا وأرقاً مدركاً لقوات الاحتلال.
2- تنظيم ربط القطاع بدولة الاحتلال وزيادة اعتماديته عليها، قسرا، لاسيما ربطه اقتصاديا بها، حيث لم يتح العمل في السوق الاسرائيلي والتبادل التجاري الآخذ في النمو الذي فرض على القطاع، في أي عملية لتراكم رأس المال في الأراضي المحتلة، بل على العكس من ذلك، فإن دورة رأس المال كانت تبدأ وتنتهي بتراكم فائضها في دولة الاحتلال وهو من بين الأسباب التي ساهمت في النمو الذي حققه الناتج المحلي الاسرائيلي الذي وصل إلى 17% في العام 1972. فما يتقاضاه العامل في سوق العمل الاسرائيلي يعود به إلى القطاع لينفقه في شراء متطلبات أسرته من البضائع الإسرائيلية التي شكلت ما يزيد عن 90% من واردات القطاع. ذلك كله منع أي امكانية لنشوء اقتصاد حقيقي تحت الاحتلال في ظل إصدار جملة من الأوامر العسكرية والقرارات الإدارية التي قيدت الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع وقضت على أي ممكنات لنشوء صناعة وطنية حقيقية.
3- بالنظر إلى أن الأرض كانت ولاتزال عنوان الصراع مع المشروع الصهيوني، فإن دفع الفلسطينيين المزارعين والمشتغلين في الزراعة من السكان نحو بيع قوة عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، يعني دفعهم من الناحية الموضوعية لترك أراضيهم ومزارعهم التي لم تعد تؤمن متطلبات ما يحتاجونه بفعل عملية الاستيلاء المنظم على الأراضي والقيود الصارمة التي فرضتها قوات الاحتلال على استخدامها واستهلاك المياه وحركة التصدير والاستيراد. ساهمت تلك السياسة في تقليص مساحة الأراضي المزروعة في القطاع من 198 ألف دونم عام 1968، لتصل إلي 173.800 ألف دونم، عام 1994 وهو ما أدى إلى تدني نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي من 28.1% في العام 1967 إلى 16.1% في العام 1994.
4- ترافق دفع السكان نحو سوق العمل الاسرائيلي مع حاجة الاقتصاد الإسرائيلي، الذي شكلت الانشاءات والزراعة قوامه الأساسي في نهاية الستينات وحتى أواخر الثمانينات، وهما اللذان كانا بحاجة ماسة إلى قوة العمل الفلسطينية الرخيصة. فالقرار وأن كان أمنيا فإنه كان اقتصادياً في جوهره، دفعت إليه حاجة اقتصاد دولة تمر في عملية متواصلة من البناء. واستمرت تلك الحاجة حتى أواخر الثمانيات حيث انتقل الاقتصاد بنيوياً إلى إقتصاديات التكنولوجيا المتطورة ولاسيما الصناعات العسكرية وصناعة الماس والتي لم يعد للعمالة الفلسطينية الرخيصة وغير المدربة مكان فيها. وتشير الاحصائيات إلى أنه منذ بداية الثمانيات تراجعت مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد الاسرائيلي مقابل الصناعة المتطورة في الناتج المحلي الإجمالي من 6.1 عام 1980 لتصبح 2.3% في مطلع التسعينات، لتشكل الصناعات التكنولوجية المتطورة ما نسبته 43.6 % من الإنتاج المحلي الصناعي.
شهدت حركة الأفراد والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة يسرا وسلاسة في الحركة بينهما من جهة وبينهما وبين باقي الأراضي الفلسطينية في الداخل من جهة أخرى. وأتاحت تلك الحركة للفلسطينيين ترميم ما تعرضت له هويتهم الوطنية من تعرية، وأعادت حقيقة أنهم يخضعون للاحتلال نفسه تصحيح العلاقة بينهم وهي التي تعرضت لإهتزازات بفعل التطورات التي رافقت وتلت نكبة فلسطين، وقد بقيت الحال على ما هي عليه حتى اندلاع الانتفاضة الأولى في ديسمبر من العام 1987حيث سحبت قوات الاحتلال تصريحها العام للسكان، وفرضت قيوداً على حرية الحركة ولكنها لم تمس بشكل جوهري بالوحدة الفعلية بين المنطقتين ولا استمرار حركة الأفراد والبضائع بينهما، وإن كانت قد أعادت تنظيمها بشكل جديد وأكثر صرامة.
......يتبع