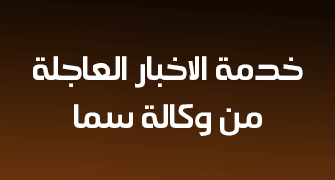"إذا ماتت الأمُّ، نزَل ملَكٌ من السماء، يقول: يا ابن آدم؛ ماتت التي كنَّا نكرمك لأجلها؛ فاعمل لنفسك نكرمْك". (حديث)
كثيرةٌ هي الأحاديث والكلمات والأغاني والأشعار التي عشنا نسمعها عن الأم "ست الحبايب" ومكانتها في السياقات الدينية والتربوية والاجتماعية والأخلاقية في حياتنا، ولكننا مع كل اجتهاداتنا للأخذ بها في أنماط وأدبيات حياتنا، فإننا لم نكن ندرك حقيقة تلك العظمة وتجليات فضائلها التي تحظى بها الأم، وبالشكل الذي ينبغي، إلا عندما ترتحل بجسدها وتغيب مشاهدها وأنفاسها وهمساتها من حياتنا، حينئذ نبدأ بوجعٍ وألم في تأمل الكلمات وتذكر دلالات المعاني التي كانت ترددها، ولكنها كانت - في زمن الطفولة والشباب - تمر بلا إمعان أو تدبر. اليوم، وقد افتقدنا مشاهدها، فإن ذكريات الصحبة والجوار وحكمة وصاياها الغالية التي اكتسبتها من تجربة حياتها ما تزال تعيش معنا وتلاحقنا بقوة من حين لآخر، كما أننا نروي بعضاً منها لأولادنا وأحفادنا وكل من جاء بعدنا.
اليوم، السادس عشر من إبريل تمر بنا الذكرى الثالثة لرحيل أمي، حيث أخذت الذكريات والكلمات التي عشنا نسمعها في سياق الوصايا والتحذيرات تعاودنا من جديد.
يا الله.. لقد دبَّ نبض الروح في الكلمات التي كانت تمر علينا سابقاً مرور الكرام.. نعم؛ اليوم تتجلى المقولات بمذاقات أخرى: فعلاً؛ "الأم مدرسة"، نعم؛ "لولاكي يا أمي ما كان ميلادي"، نعم؛ "الجنَّة تحت أقدام الأمهات"، نعم؛ "السعادة أمي، والحزن غيابها"، نعم؛ "البركة تحل بحضورها وتبتعد مع رحيلها".
عاشت أمي بعد رحيل أبي (رحمه الله) قرابة العقدين من الزمن، وكانت زيارتها لنا في أمريكا تؤنسنا في الغربة، وتمنحنا شيئاً من دفء الشوق والحنين. وبعد أن عدنا واستقر بنا المقام في أرض الوطن، كانت تجمعنا جلسات ومناسبات اجتماعية نتذاكر فيها سنوات الطفولة والمخيم والحرمان. صحيح؛ كانت أشغالنا قد تعاظمت وقلت ساعات الفراغ لنسمع الكثير من أحاديثها، ولكنَّ طفولتنا التي ترعرعت في أحضانها لم تنس "حكايا وخراريف ما قبل النوم"، ولم تغب عن مشاهدها تلك الحالة الفريدة لأم تعودنا على رؤيتها تصحو في الصباح الباكر قبل الجميع لتهيئ لنا طعام الإفطار قبل الذهاب للمدرسة، والتأكد من أن كل شيء على ما يرام، ويصاحبنا دعاؤها لنا بالتوفيق والنجاح.
في شبابي، كنت أشاهدها دينمو البيت وعمود خيمتنا، حيث تعمل بطاقة وجهد عشر نسوة من بنات اليوم، لا تتذمر ولا تشكو ولا تتعذر، بل ماكينة تعمل على مدار الساعة بلا كلل أو ملل: تطهو وتخبز وتغسل، وتجلب الماء يومياً من أماكن بعيدة، وممرضة دائمة الحضور إذا اشتكى أحد منا بالسهر والحمى.
في الحقيقة، كانت أمي (رحمها الله) هي الأكثر حضوراً في مشهد النهار، وعند المساء يعود أبي، والذي تظهر على وجهه الكثير من ملامح الكد والتعب، فلا تتركه أمي حتى يتناول طعامه ويرتوي، ويأوي بعد ذلك للفراش ليتقوى على وعثاء وشقاء عمل الغد.
خلال سنوات عملي في أمريكا، أقامت معي أمي لبعض الوقت، وجاءت فترة كنت فيها اتعهد بنات أخي اللتين التحقتا بمدرسة إسلامية في ولاية ميرلاند على بعد أكثر من ساعة من مكان إقامتي، حيث كنت أنهض في الصباح لأخذهم إلى منطقة يتجمع بها الطلاب بانتظار باص المدرسة.
في فترة توصيلي لهم والعودة للبيت لأتجهز للعمل، والتي كانت تستغرق ذهاباً وإياباً حوالي 45 دقيقة، كنت أجد أمي (رحمها الله) قد أعدت لي طعام الإفطار أشبه بوجبة الغداء، وتقول لي: "كل يامَّه انت بتتعب.. طول اليوم شغل.. تنجى وكل ودير بالك على حالك وشبابك". كانت ابتسامتي لكلماتها تخفي عيوناً رطبتها الدموع.
لقد كانت أمي من ذلك الجيل الذي نسميه "نسوان زمان" و"جمل المحامل" من ماجدات فلسطين، التي تعمل ليل نهار لتدير مشروع الستر والاستقرار والتوازن داخل البيت، وهي تتدبر أمور حياة العائلة في حدود ما كان يوفره الوالد (رحمه الله) من مال قليل يساند ما كنا نتلقاه من مواد تموينية كانت تزودنا بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
نعم؛ كان البيت في المخيم مكوناً من غرفتين وساحة صغيرة (قاع الدار)، وكنا نصطف عند النوم محشورين في غرفة واحدة لا تزيد أبعادها عن 3 أمتار في 3، والسعيد منا من كان موقعه بالجوار منها.
قبل أن تغادرنا إلى الرفيق الأعلى، كنا نشعر بأن سنوات عمرها التي قاربت التسعين عاماً، وأيامها المثقلة بأوجاع المرض لن تطول، وكان إخوتي يتفاوتون بعملية الرعاية والاهتمام بها، ولكنَّ الكل كان يسعى جهده - بحسب ماله ووقته – للقيام بما نعتبره في ديننا وقيمنا وأعرافنا "برُّ الوالدين".
ونظراً لأننا كإخوة كنا متوزعين بين مكانين في حي "تل السلطان"، فكانت تحرص في فترة العصر إلى المغرب أن تقضيه في بيت العائلة، والذي يبعد حوالي 400 متر عن سكنى أخي الذي تقيم عنده في "برج الأندلس"، حيث لم يمنعها عدم القدرة على المشي، فكانت تستعين بـ"الكرسي المتحرك".
في يوم وفاتها، كنت قد عدت من عملي قبيل المغرب، وكانت زوجتي قد سبقتني إلى بيت أخي (أبو النعمان)، حيث تقيم أمي أغلب الوقت، وقد راودها إحساسٌ بأن عمر أمي قد دنا، فأشارت عليَّ بالقدوم لرؤيتها. ذهبت إلى هناك، وكانت صامتة وتنظر بتفحص في وجوه كل من حولها، وكأنها تلقي علينا نظرة الوداع.
أمسكت القرآن، وأخذت أقرأ عليها سورة ياسين، وهي تنصت ولا تتكلم، فقط كانت عيونها هي من تطيل في وجهي النظر. شعرت بالارتياح لتلك النظرات، وودَّعتها لكي أعود إلى البيت، حيث كان تعب العمل قد أخذ مني كل عافية أو قدرة على السهر. وقبل أن أصل البيت بأمتار قليلة، رنَّ جرس الهاتف، وإذا بها زوجتي، تقول لي بكلمات حزينة وباكية: "عليك بالعودة فقد أعطاك الله عمر والدتك رحمها الله".
شعرت بشيء من الارتياح لتلك الساعة التي قضيتها إلى جانبها، وتمتمت: لكل أجل كتاب، لقد أذن المولى لها بالرحيل، لقد أنجزت المهمة على أكمل وجه، وكان الكل والحمد لله بارَّاً بها.
بعد أن انتهت أيام العزاء، جاءت مواجع الذكريات، ولكننا حمدنا الله أن أعطاها هذا العمر المديد لتعيش بيننا، وإن كانت قد عايشت استشهاد اثنين من أبنائها، وظلت غيبة الآخرين بعيداً في أمريكا والجزائر حسرة توجعها، ولم تكن الاتصالات الهاتفية برغم كثرتها لتروي ظمأ أمٍ قضت حياتها ترعى صغارها، الذين فرقتهم المنافي وابتلعتهم
/رغم تواجدهم في حضرة الغياب.
نعم؛ كانت أمي سنديانة البيت، تعلمت منها الجد والاجتهاد، وأخذت من أبي الهيبة والعزة والكرامة والجرأة في قول الحق ونصرة الضعفاء.. فلأمي التي طاب غرسها بهذا العطاء الوافر من البنين والبنات، وما شكلوه من "حالة فلسطينية" لم تتأخر ولم تبخل، بل تسابقت كغيرها على تقديم غالي المهج والأرواح، فكان من بينهم الشهداء (شريف وأشرف)، وكان منهم من يستحق الفخر به من المناضلين داخل ربوع الوطن وخارجه.
لأمي - كما لأبي - فضل كل ما بلغناه أنا وإخوتي من عروةٍ وثقى وعلمٍ ومكانةٍ تُرجى، ولروحيهما الطاهرة منَّا الدعاء: (ربِّ ارحمهما كما ربياني صغيراً).