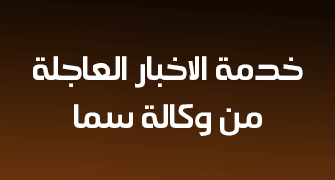ومرت ليلةٌ أخرى، وليست ليلةً أخيرة من القصف على غزة، وكانت ليلةً طويلة، ليس لكونها من ليالي الخريف التي يطول فيها الليل ويقصر النهار، ولكنها كانت ليلةً طويلة بالخوف والترقب والتساؤل: مَن التالي؟ أو ما التالي؟
قالوا عن غزة إنها سجنٌ كبير، ولكن لم يقولوا ماذا يفعل السجناء داخل السجن؟ والإجابة اكتشفتُها في تلك الليلة، وهي أن السجناءَ أقوياء، ويعيشون حياتهم الطبيعية ونسوا أنهم في سجن أو تناسَوْا، ويدافعون عن وجودهم أحياء بكل ما أوتوا من قوة، وأن السجناء يتواصلون مع العالم، وأن الموتَ بالنسبة لهم شيءٌ عادي، قد يمرُّ أو لا يمر، فلا شيء يهم،
إن مر فسوف يحصد بعض الأرواح في طريقه، وسينعى الناعون مَن صعدت أرواحُهم إلى السماء، ولكن الحياة سوف تستمر، سوف يستيقظ الجميعُ في الصباح ويتفقدون أطرافَهم ويراقبون أنفاسَ مَن حولَهم ويتساءلون: هل ما زلنا على قيد الأمل؟
في غزة يولد الصغار كباراً، ويعيش الكبار بحكمة الشيوخ، وتصبح أدنى المتطلبات أمنيات، فنفرحُ حين تعود الكهرباء، ونفرح حين تصل المياه كل ثلاثة أيام ونملأ الخزانات، ونفرحُ حين يرتقي الشهداءُ لأنهم الناجون، ولأنهم الأكرمُ منا جميعاً.
نفرح أفراحنا الصغيرة ونحن نودع موتانا، نلمح البراءة في وجوههم التي لم تعد تفتح عيونها، ونلمح ابتسامتهم لأنهم رحلوا إلى عالم آخر بأسرع مما توقعوا، وتركوا كل شيء يخبر عنهم، ويذكر الأحبة منهم، ولا أحد ينسى أحداً، فأمام كل بيت قذيفة، وخلف كل حجر حكاية جدار كان يضم عائلة لم يبق منها أحد.
تكتشف أن غزة لا تموت ولا تعيش، فهي ما بين مستشفى الشفاء ومقبرة الشهداء، وبأنها لا تغرق ولا تجلس على الشاطئ في أمان واسترخاء، رغم أن الجميع يتمنى أن يبتلعها البحر، ولكن البحر يقف حائراً من أين يبدأ، من قلوب رجالها الأشداء، من جبروت النساء الحرائر، من صوت الأطفال الذي يملأ الأزقة والطرقات، لا يعرف كيف يبتلع غزة، اسمها الصغير وفعلها الكبير، ولا يدري كيف يبتلعها، وماذا يبتلع خلفها ليتجرعها، لأنها ستقف شوكة في حلقه كما تقف شوكة في حلق كل من يفكر أن ينهيها ويزيلها عن الخريطة، هل فكرتم مرة بحجمها على الخريطة، هل هي نقطة، أم أكبر بقليل؟ هل أمعنتم النظر لكي ترونها؟ لكنكم في ليلة القصف على غزة رأيتموها جيدا، لأنها غزة تكبر حين تشاء، وتصغر حين يضغط عليها الجوع والفقر والحاجة.
بعد أن بلغتُ من العمر ستة وأربعين عاماً وأقتربُ من العام السابع بعد الأربعين أكتشفُ أنني واقعة في حبها، أستمع للأخبار فأكتشف أماكن لا أعرفها تتعرض للقصف، فأقرر أن أزورها حين ينتهي القصف وتنكشف الغمة، أعرف أن هذه جولة من العدوان سوف تنتهي، وسننفض الغبار عن كوابيسنا ونمضي، وسوف اذهب لأقف فوق تلة وأشاهد البحر والسهل والخضرة والناس التي تتحرك لكي لا تموت، والناس في غزة يا رفاق تصنع كل شيء لكي لا تخبرَ أحداً أن الموتَ قد اعتاد طريقَها.
كم طفلاً يولد كل يوم في غزة؟ وحتى الكبار لا يموتون بسهولة، وكأنهم يصرون أن يبقَوا ليشحذوا همةَ الصغار، وحكاياتُهم يتركونها في الآبار وينابيع الماء، ويرسمونها على الرمال ولا ريحَ تمحوها، فلا ريحَ تجرؤ أن تمحوَ قصةَ بطولة.
غزةُ يا رفاقُ حبيبتي، أعترفُ وأُقر، وقد كنتُ ملأتُ الدنيا صراخاً بأنني أريد أن أغادرها. وصوتُ العصافير فوق شجرة الرمّان هذا الصباح بعد انتهاء القصف وتوقُّف جولة الحرب القصيرة لمن أتركُه؟ أخبروني لمن أتركُ هذا الصوتَ الجميل الذي ينعش قلبي، أيُّ صوتٍ سيُنعش قلبي غيره، لو تركتُ غزة؟ أيُّ بلاد ستكونُ أكثرَ حناناً على قلبي غيرها؟
أُحبكِ يا غزة، اعترافٌ متأخر أو مكتشَف، لا أدري، ولكنني سأعلّم أولادي أن يُحبّوها أكثر، كلما تألمنا سنحبُّها، وكلما انقشعت غيمةُ الحقد عنها سنراها أجمل، وهل هناك أجملُ من وجهكِ يا غزة؟
البحرُ فيكِ له ألفُ حكايةٍ معي، والشوارع والأزقة التي سِرتُ فيها سنواتِ عمري كلها، تعرفني وتقودُني ولا أمرُّ فيها بل تمرُّ بي، هل فكرتم كيف تمر الشوارعُ بالإنسان؟ إنها تمرُّ بي حباً وحنيناً، وشوقاً وإخلاصاً ووفاءً، لأنها غزة، فهي تنادي من يتركها، وتطارده بلعنة إلى الأبد: عُد يا ولد، مهما ابتعدتَ عنها فلا مالَ ولا جاهَ يعوضكَ عن صوت العصفور فوق شجرة الرُّمّان في صباح جديد بعد ليلةِ قصفٍ دامية.
ليلة القصف على غزة...سما حسن
الخميس 15 نوفمبر 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT