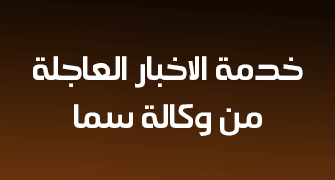منطق الأشياء يقول إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مام يُسمى قانون «الدولة القومية» الذي ينص على «يهودية» الكيان الإسرائيلي، ويحوّل الأقلية العربية عملياً إلى مواطنين من الدرجة الثانية، كان متوقعاً.
كل الخطوط البيانية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، كانت تسير بهذا الاتجاه. كلها من دون استثناء.
حتى الكلمات الدبلوماسية المنتقاة بعناية في نص «إعلان بلفور»، التي تبخر معناها قبل صياح الديك، تبدو اليوم أشبه بمزحة ثقيلة لا صلة لها بالواقع. بعد 122 سنة من «حلم» تيودور هرتسل، صار «الحلم» شيئاً آخر.
الشعب المقهور والمشرّد في رياح الدنيا الأربعة ما عاد مقهوراً.
هذه الصفة باتت تنطبق على شعب آخر تطوّع المستر بلفور بتذكر «مصالحه» بكلمات مهذبة تبين لاحقاً أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، عندما قال: «تنظر حكومة صاحبة الجلالة بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهوديّ، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم بوضوح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر».
فترة الانتداب البريطاني، التي شهدت جملة من التدابير والأحداث... من «قانون الأراضي» إلى تسارع وتيرة الهجرة اليهودية والتصدّي لـ«ثورة 1936»، كانت حقاً فترة «تمهيد الأرض» للكيان القوي الاستعلائي الذي نراه اليوم.
المخطّط كان واضحاً في حينه، كما اتضح لاحقاً في عدة محطات ومفاصل، لكن الجانب العربي - بل، وحتى الفلسطيني - ما كان مستعداً لمعرفة كُنه هذه المخطّط وإمكانات القوى الداعمة له. ومن ثم، بمزيج من القراءات الخاطئة والرهانات العبثية والانقسامات الانتحارية والاعتماد على مَن لا يستحقون الاعتماد عليهم، تراكمت النكسات وضاع مزيد من الأراضي، وتزايدت أعداد المستوطنين... وازداد أيضاً عنصر التطرّف في صفوفهم.
جيل المستوطنين الأوائل الذي كان كثرة فيه من المزارعين والنقابيين والرومانسيين غادر بيئات اضطهدته وظلمته، واستقر في مستوطنات تعاونية وجماعية زراعية... في معظم الأحيان اشترتها الوكالة اليهودية ومؤسسات صهيونية استغلت قوانين التملك الانتدابية.
صحيح كانت هناك مرارة تفجّرت في «ثورة 1936»، وظهرت بوادر قلق حقيقي من مدّ الهجرات اليهودية والاستحواذ على الأراضي نتيجة لتطبيق قوانين تمنع «المالك الغائب» من استغلال أرضه، وبالتالي تشجعه على بيعها، لكن ذلك الوضع لا يُقارن بما أخذ يحدث في العقود التالية، ولا سيما، بعد إعلان دولة إسرائيل... ومن ثم تحوّلها إلى قوة عسكرية ضاربة ونووية.
كبار أعيان دمشق وبيروت وغيرهما من مدن بلاد الشام، الذي تملكوا إبان العهد العثماني أجزاء واسعة من فلسطين، اضطروا إلى بيع أراضيهم وممتلكاتهم التي ما عاد بمقدورهم الإقامة فيها واستغلالها. وبطبيعة الحال، كانت الجهة الجاهزة للشراء الوكالة اليهودية ومعها أسرة روتشايلد وغيرها من الجهات الصهيونية الاستيطانية. هذه العملية لا تختلف كثيراً عما حصل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما بوشر بخصخصة المرافق الحكومية السوفياتية... فيومها، كانت الجهة الجاهزة للشراء، والمُتخمة بالأموال والمتعجّلة على تصفية «التركة السوفياتية»، المجموعات المالية الغربية التي أخذت تستحوذ على تلك المرافق... مباشرة أو عبر وسطاء وواجهات محليين صاروا بين ليلة وضحاها من كبار أثرياء العالم.
وبمرور الوقت، أصبح «جيل» إسرائيليي الحروب الإسرائيلية - العربية بالتدريج أكثر كراهية لبحر عربي مُحبط وشبه يائس... يهدّده قومياً وديموغرافياً. وتزايد الكره مع ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة بعد نكسة 1967، فصار هذا «الجيل» مُشككاً في إمكانية التعايش وأقل ثقة بمثاليات اليسار، تماماً كما تراجع اليسار الفلسطيني والعربي لاحقاً على الجانب الآخر من خطوط الأسلاك الشائكة.
مع انهيار الطروحات اليسارية إسرائيلياً وعربياً... تعزّزت مواقع «البديل الديني» الإلغائي، وهرب قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين إلى أحضان «الجنرالات»، وصارت جماعات الاستيطان الصهيوني من قماشة أخرى أشد تعصباً وجشعاً... وإلغاء.
وفي المقابل، مع انهيار طروحات «حرب التحرير الشعبية» وتلاشي التنظيمات الفلسطينية القادرة على التحاور مع ما تبقى من اليسار الإسرائيلي - بشيء من الصدقية - أنتج كل من كامب ديفيد واجتياح لبنان عام 1982، ثم انهيار الشيوعية السوفياتية، مقاومة جديدة ترفع شعارات إسلامية وتستفيد من دعم تيارات إقليمية جديدة، بدءاً من إيران وانتهاء بتركيا...
ما عادت شروط اللعبة عربية. حتى نظام دمشق، الرافع زوراً شعارات عروبية لم يؤمن بها يوماً، صارت مهمته توسيع الخرق الفلسطيني... تارة بحجة «الصمود والتصدي»، وطوراً كحاضنة لقوى إسلامية استغلها لإضعاف القيادة الفلسطينية والمزايدة عليها، وحرمانها حتى من الفرص المتناقصة لإبرام صفقة سلام شبه مقبول.
المناخ الدولي في هذه الأثناء كان يتحوّل أيضاً لمصلحة الجناح المتطرف في إسرائيل. وبينما غدا الليكود والشراذم المتطرفة قوى السلطة الطبيعية، على أنقاض القوى والتنظيمات العمالية التي أسهمت في بناء إسرائيل، أراح الانتصار في «الحرب الباردة» واشنطن من ادعاء حياد كاذب في رعايتها الاحتكارية المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبعد تكرارها في غابر الأيام لازمة «توازن القوى في الشرق الأوسط» أضحت تتحدث علناً عن «ضمان استمرار التفوق الإسرائيلي»...
«يهودية الدولة» نتيجة حتمية لانتصارات اليمين والتيارات العنصرية و«النيوفاشية» في كل مكان.
أصلاً كيف لا تكون دولة قامت على أساس الدين «دولة دينية» بالكامل... إذا كانت الدول الأعرق والأكبر في أوروبا، ومعها الولايات المتحدة «ابنة» الحضارة الأوروبية، ما عادت تتحرّج أو تخجل من رفع شعارات دينية وعنصرية؟ّ
لماذا نستغرب أن تهرب دولة صغيرة، أسهمت في تكوينها النفسي والاجتماعي عوامل الخوف التاريخي وحب البقاء وتفرّد الهوية، إلى إجراءات تمييزية ضد الآخرين... إذا كانت دول أكبر منها بكثير تفعل الشيء نفسه؟
أليس متوقعاً من قيادة عسكريتارية ومتطرفة، كقيادة إسرائيل الحالية، أن تحاول تأجيل ما تراه قنبلة زمنية ديموغرافية... إذا كانت تجربتها في بناء «جدران الفصل» غدت نموذجاً يحتذى؟!