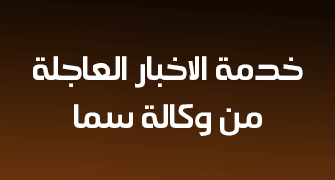صبياً، أي في التجربة البدائية والمبكرة لم أكن مغرماً او معجباً بلعبة كرة القدم، الأكثر شعبيةً أو تفضيلاً لدى تلاميذ الصفوف الابتدائية والإعدادية في الحصص المخصصة للرياضة، ولعلني على غير وعي بالبعد الفلسفي للمسألة لم أكن لأحب ما بدا لي نوعاً من الصراع الذي يشبه الشجار، عبر هذا التدافع الخشن بالأرجل والأقدام في ملعب المدرسة لتقاذف الكرة، وبدلاً من ذلك ربما اكتفيت بالفرجة دون حماس او انفعال، والتأمل بعيداً في الانفعالات الحسية او المجسدة لأشياء الوجود التي ترافق خيالات الطفولة.
ان مجتمع الذكور هو ميدان المنافسات والصراعات وتأكيد الذات الفردية، وصولاً الى تحقيق البطولة او التفوق، وهذا بخلاف التكتيكات الأنثوية او النسوية ومجتمع الحريم كما كان يسمى قديماً، حيث لا نلحظ هذا الميل في مدارس البنات كما في مدرجات الملاعب الرياضية الكبرى ممارسة هذا النوع الخشن من الرياضة، الذي يشبه ميادين الحروب كما هو الحال في كرة القدم. وحيث يميلون في التجمعات النسوية الى التمسك بإظهار روح العمل او المشاركات الجماعية، وتلعب نزعة التوافق والتعاون او التعاضد بديلاً عن المنافسات او الطابع الفردي للذكورية.
وربما بهذا المعنى كانت التسويات او الميول التوافقية تمثل روح الأنثوية، وهي التي طالما عبر عنها السياسيون اللبنانيون بعبارة «لا غالب ولا مغلوب»، وهي الحكمة او المعادل لما يسمى في نظريات الصراع الدولي «بالمعادلة الصفرية»، التي تنتهي الى غالب ومغلوب ورابحين وخاسرين.
ولعلها هذه الرياضة المعاصرة والأكثر شعبية التي لم يمض على ابتكارها أزمان قديمة، تمثل من الناحية الشكلية صورة تمثيلية او احتفالية كمشهد مُمسرح عن الحرب الحقيقية. وظهرت في الأصل او البداية كدافع تحت تأثير المدنية والتقدم الحضاري للاستعاضة عن المبارزة العنفية، التي كانت تمثلها الحروب عبر هذا الشكل المُمسرح او الناعم للتعبير عن الغرائز العنيفة الكامنة في المجتمع الذكوري، والتنفيس عن هذه الغرائز في صورة تواكب تطور المدنية والحداثة، وذلك قبل ان تكتشف الرأسمالية المتوحشة وأنظمة الاستبداد كلاً على حدة، أهمية إعادة توظيف هذه اللعبة في استراتيجيتهم.
وقد حدث هذا التحول بفعل تطور أجهزة الاتصال والثورة المعلوماتية، حين نظرت الرأسمالية الى ازدياد أهميتها كمصدر جديد للاستثمار وجني الأرباح الهائلة، حتى تحول السباق والتنافس على استضافة المونديال الدوري لكأس العالم، الى نوع من الصراع الحقيقي بين الدول.
أما الحكام الطغاة فقد وجدوا فيها اداة سحرية لامتصاص غضب شعوبهم وتحويل انفعالاتهم، وحتى اهتماماتهم بالشأن السياسي المحلي الى نوع من الملهاة، اذا كان من الأفضل مئة مرة ان تحتشد هذه الجماهير في الملاعب وتصدح بالصراخ العالي تشجيعا للفريق المحلي او الوطني الذي تؤيده، بدلاً من الاحتشاد والتظاهر في الساحات والميادين احتجاجاً على سوء الإدارة والحكم.
وفي المرة الوحيدة والأخيرة التي دفعني الفضول فيها الذهاب في القاهرة حينما كنت لا أزال طالباً في جامعتها، الى حضور مباراة لفريق النادي الأهلي الشهير، فإنني لم أستطع إكمال مشاهدة المباراة تحت تأثير الصراخ وقرع الطبول، الذي بدا لي غير عقلاني من حولي.
وقبل يوم الأحد غداً الذي يحبس الأنفاس في نهاية هذا الصراع على الفوز بكأس العالم بين الفريق الفرنسي والكرواتي، قال وزير الاقتصاد الفرنسي ان انتصار فرنسا سوف يكون له تأثير معنوي بالغ الأثر على ثقة الفرنسيين بأنفسهم، ما يعزز التقدم الاقتصادي والنمو للبلاد. فيما تحولت الخسارة المبكرة لأربعة فرق دول عربية الى نوع من الفاجعة القومية.
لكنه في زمن كان لا يزال يتسم بالبراءة والفطرة وبكارة الأشياء، سوف يذكر نجيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة: «بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية» بنوع من الافتتان والإعجاب لأقدم واشهر لاعب كرة قدم في مصر في عشرينيات القرن الماضي، من لي شخصيا الحظ بمشاركته في الاسم أي حسين حجازي، لاعب فريق نادي الأهلي. لكن في عقد الستينات الذي يمثل بحق ما نسميه اليوم بالزمن الجميل، فان رفعت الفناجيلي كان الأشهر بين لاعبي كرة القدم في مصر. أما عالميا فانه كان بدون منازع البرازيلي بيليه، كما كان الأميركي الأسود الذي اعلن إسلامه أي محمد علي، هو بطل العالم في الملاكمة على هذه الحلبة الشهيرة أيضا في ذلك الوقت. أما على المستوى المحلي هنا في غزة فقد كان الثنائي محمود المغربي وإسماعيل المصري نجمي فريق غزة الرياضي.
وقد بدا هذا زمناً على صورة العصر لم تتوغل فيه الرأسمالية الى هذا الحد، الذي تحول فيه نجوم هذه الرياضة الأكثر شعبية في العالم وجاء معظمهم من الأزقة والحواري الفقيرة في أميركا اللاتينية او إفريقيا أو آسيا، الى بضاعة تشترى وتباع بعشرات الملايين من الدولارات.
ولم يعرف بعد هذا العالم الذي لا يزال يسمى بالثالث خارج المركز وفي الأطراف هذا الحد من سيطرة الطغيان والاستبداد، حينما كانت الشعوب في ذلك الوقت تشهد في الخمسينات والستينات هذا القدر النادر من الغليان الثوري والمشاركة الجماهيرية في النضال السياسي ضد الاستعمار. وفي الصورة الإجمالية فقد كانت هذه هي الحقبة المزدهرة في الفن، والتي بدت فيها هذه الاحتفالية المسرحية كما لو انها تعيد لقدم الإنسان هذه المكانة التي تتماهى مع إيقاع الرقص والفرح في حفلات «الدبكة الشرقية». كما في التمريرات القصيرة الكروية التي طالما ميزت شهرة وجمال أداء الفريق البرازيلي، ويماثل بينها البعض ورقصة «السامبا البرازيلية».
وفي الذاكرة لعل مونديال العام 1982 في إيطاليا كان هو الأسوأ استغلالا من جانب إسرائيل، في تزامن توقيتها في ذلك الصيف وعدوانها على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، حين استغلت إسرائيل الانشغال العالمي بالمونديال ومارست هذا القصف الوحشي على بيروت، حيث كان عرفات مع الفصائل الفلسطينية جميعا محاصرين في المدينة. بالرغم من ان الإيطاليين الذين فازوا بكأس العالم في هذا المونديال قاموا مشكورين بلفتة رمزية جميلة بإهداء هذا الكأس للشعب الفلسطيني.
وشيئاً فشيئاً تختلط السياسة بالعاطفة لنقف غالباً بعيداً عن الحياد، وتصبح الرياضة كما لو انها قد عُجنت تماماً بالسياسة. وعلى سبيل المثال فقد كنا مع الارجنتين حينما هزمت بريطانيا، وكان في خلفية ذلك غزو مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت والتي تسمى «بالمرأة الحديدية» جزر الفوكلاند الأرجنتينية، في تحدٍ وقح لمشاعر الأرجنتين والعالم. ولذا كان الهدف الشهير بل النادر والخيالي الذي يشبه السحر الذي سجله مارادونا في شباك الفريق الانجليزي، والذي اعتبره النقاد الرياضيون اجمل هدف في تاريخ كرة القدم، كما لو أنه يعبر عن ثأرنا جميعا من الغرور الاستعماري البريطاني.
وهكذا غدا الأحد الحاسم في موسكو بين فرنسا وكرواتيا، فهل نحن مع كرواتيا كُرمى لرئيستها المرأة العفوية التي أسرت الجميع لعاطفتها تجاه فريقها؟. ام نحن مع فرنسا فريق الديكة وايمانويل ماكرون، لأن فرنسا هي التي يعول عليها قيادة الاتحاد الأوروبي وتماسكه مع ألمانيا، والذي لا يخفي وقوفه بقوة الى جانبنا نحن الفلسطينيين؟.
خواطر في الزمان: الأقدام الذهبية...حسين حجازي
السبت 14 يوليو 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT