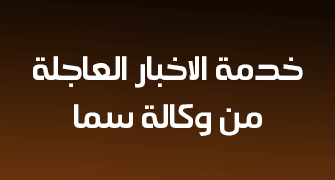في قوانين الطبيعة أو الفيزياء في لعبة الحياة كما في السياسة والعلاقة بين الجماعات، فان الكسر عادة أو هدم الوحدة القائمة غالبا ما يحدث بإيقاع اسرع ووتيرة أسهل، بينما تكون إعادة الإصلاح أو الترميم أو البناء هي المهمة الأصعب وبإيقاع بطيء على محور الزمن.
هل كان هذا هدما وكسرا ما حدث قبل عشر سنوات يوم الرابع عشر من حزيران في غزة لوحدة قائمة؟ ولا زلنا منذ ذلك الوقت نحاول إعادة إصلاح ما حدث دون جدوى؟ ولماذا انقسمنا أو انكسرنا على انفسنا ونحن لا زلنا في مجرى هذا السياق الطويل؟ بل الأكثر تطاولا من الصراع الشاق من اجل نيل حريتنا واستقلالنا وطرد الاحتلال، فهل كان هذا مبررا أو قدرا؟ ولماذا فشلنا حتى الآن في إعادة إصلاح أو ترميم هذا الهدم، وكأن ما حدث هو فعل سرنا إليه كما في قوانين الدراما التاريخية، مستقل عن إرادتنا تماما؟ ولكنه حدث وفق تطور حتمي لا مجال لرده أو وقفه أو اعتراض سبيله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
وواقع الأمر والحال إننا لا نملك جوابا عن هذه الأسئلة وغيرها المطروحة منذ ذلك الوقت على طاولة النقاش، لكن التاريخ ولا مناص من العودة إلى هذا المعلم الصارم او ما يسميه هيغل "محكمة العقل"، لكي نعرف ونعلم انفسنا ونتحقق من إننا في هذا الوضع المكدر للنفس، لم نكن استثناء خاصا او متفردا من طينة او قماشة مختلفة عن جميع الثورات وحركات التحرر في منطقتنا او حول العالم، التي اكتوت بهذه التجربة المرة او الخطيئة التي كانت أشبه باللازمة التي رافقت جميع هذه الحركات، وشهدت هذا العنف او حروب الإخوة الأعداء في ثناياها.
ولقد كانت هذه هي الخطيئة التي رافقت جبهة التحرير الجزائرية، وحزب التجمع الدستوري التونسي حتى قبل الاستقلال، ورأينا ذلك في انقسام الثورة الروسية وحرب التحرر الصينية وفيتنام. وفي انقسامات المعارضة السورية هذه الأيام والأزمة في مجلس التعاون الخليجي، وقبل ذلك في اليمن بين الجنوب والشمال والثورة المصرية على نظام الرئيس حسني مبارك.
بل وان النموذج المتكرر في هذه اللعنة هو الثورة الفرنسية نفسها أم الثورات ومرجعيتها، حين كانت انقسامات الثورة على نفسها هي التي مهدت لظهور الجنرال نابليون بونابرت، والتفوق على الثورة نفسها. وقبل ثلاث سنوات ظهور الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر، والجنرال خليفة حفتر للتفوق على انقسامات الثورة الليبية. وليس بعيدا عن هذين المثالين الحاضرين أمامنا في مصر وليبيا، انقلاب الجنرال هواري بومدين في الجزائر للتغلب على انقسامات جبهة التحرير الجزائرية، وحافظ الأسد في سورية على انقسامات حزب البعث والنخب السياسية.
وان كانت في تونس لم تتخذ هذا الحل لنفس الأزمة، هذا النموذج أي ظهور الجنرالات في الوقت المحدد، ولكن النتيجة هي نفسها. إذ حدث الحسم عن طريق التصفيات الدموية التي قادها الحبيب بورقيبة نفسه ضد من سموا في ذلك الوقت "اليوسفيين" أي اتباع منافسه وخصمه اللدود صالح بن يوسف، الذي كان مواليا للرئيس جمال عبد الناصر والتيار القومي العروبي في مواجهة الحبيب بورقيبة، الذي كان متهما بأنه موال للتيار الفرنسي الفرانكوفوني.
لكن المثال الفلسطيني في مراحل وأشكال الانقسامات التي شهدها، بدءا من الانقسام زمن الانتداب البريطاني بين حزب الحسينيين والنشاشبيين، مرورا بالعام 1974 بين ما سمي آنذاك بجبهة الرفض والبراغماتيين او المعتدلين، وانشقاق ابو موسى وجماعته داخل "فتح" العام 1983 في البقاع اللبناني، الى الانقسام اليوم ومنذ عشر سنوات بين "فتح" و"حماس". كان يطرح ولا يزال نموذجا ومعضلة شديدة التميز والاختلاف.
ولعل مصدر الأزمة المباشر هنا والحاسم هو الظروف الجغرافية، سواء زمن المنفى او الحالة الراهنة اليوم في غياب هذه الوحدة بين غزة والضفة، أما العامل او المصدر الثاني للازمة فهو يتمثل بتوازن الضعف او القيود المتبادلة التي تحول دون قدرة أي طرف على الحسم، حسم الخلاف بالقوة. وثالث هذه المصادر هو ميوعة او سيولة التحالفات في البيئة المحيطة للانقسام، ورابع هذه المصادر هو استبدال نموذج الجنرال هنا الذي يستطيع القفز في لحظة محددة فوق هذا الصراع بممثل آخر، وهو هنا الاحتلال الذي يلعب دور المايسترو في ضبط الإيقاع او الانقسام خدمة لمصالحه الاستراتيجية، وهو أسلوب قديم اخترعه البريطانيون فيما يسمى سياسة "فرق تسد".
وهكذا لأن استطاعت "حماس" يوم الرابع عشر من حزيران حسم الوضع العسكري الميداني على الأرض هنا في غزة لمصلحتها، إلا ان هذا الحسم ظل منقوصا ومحدود الأثر في هذا النطاق او الحيز الجغرافي، وزاد هذا الحسم من تعقيد الانقسام بدل ان يمثل حلا او إنهاء له. وربما ذلك بخلاف هذه المخاطرة العسكرية نفسها التي تتحدى الجغرافية، والتي لجأ إليها عرفات لحسم الانشقاق في "فتح" العام 1983 في معركة طرابلس شمال لبنان، حينما غامر عرفات بركوب البحر تحت جنح الظلام متنكرا للوصول الى طرابلس، وبادر الى هذه المواجهة.
ولكن صحيح ان عرفات لم يحسم هذا الصراع الذي كان طرفه المقابل الرئيسي حافظ الأسد، الداعم الرئيسي للانقسام، إلا انه وعبر هذه المناورة العسكرية تمكن من إبطال مفاعيل الانقسام من الناحية السياسية، وشل تمدده او تطوره وأبقاه معزولا جغرافيا.
ولم ينس عرفات الداهية وهنا يبرز دور القيادة ان يتبع في طريق عودته من طرابلس هذه المناورة بمناورة سياسية بارعة، تمثلت بفك الحصار العربي عن مصر عبر لقائه بالرئيس حسين مبارك لمحاصرة حافظ الأسد، عبر توازن من التحالفات العربية بضم مصر والأردن والعراق والسعودية.
هل الأحداث والشخصيات في التاريخ تعاود الظهور مرة ثانية كما لاحظ ماركس؟ حيث تحضر مصر مرة أخرى ولكن هذه المرة على الحدود الغزية وبشخص الجنرال عبد الفتاح السيسي، وحيث الناس او المجموعات غالبا ما يضطرون وهم في غمرة التصدي مواجهة الظروف، الى صنع او خلق أشياء مستقلة عن إرادتهم. وهل هذه الأشياء التي يخلقونها بصورة مجردة او مستقلة عن إرادتهم السابقة يوم الرابع عشر من حزيران، هي التي يمكن ان يتردد صداها حول هذا الانقسام المغلق أمام أي حل في الحديث عن دولة غزة، حتى وان كانت "حماس" و"فتح" أي طرفي الأزمة لم يريدا ذلك ان يحدث؟.
وربما كان يجدر بنا التأمل او التوقف عند هذه اللحظة التي تبدو كمنعطف عند المؤشرات التالية:
1- مصادقة البرلمان المصري على الاتفاقية بعودة السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، وهل التوقيت جاء مصادفة واذا كان هذا يمثل سابقة لها دلالتها؟.
2- الاستقبال اللافت لوفد "حماس" القيادي في زيارته للقاهرة.
3- الضغط المكثف الذي يمارسه الرئيس ابو مازن في الأسابيع الأخيرة لإقناع "حماس" بالعودة الى التوحد وإنهاء مفاعيل الانقسام، المتمثلة في تأثيرها على الموقف السياسي الفلسطيني الإجمالي من حل القضية الفلسطينية.
4 - وأخيرا الأزمة الخليجية نفسها في بعدها غير البعيد عن السيناريوهات المطروحة، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الإطار الإقليمي العربي.
بعد عشر سنوات على الرابع عشر من حزيران ...حسين حجازي
السبت 17 يونيو 2017 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT