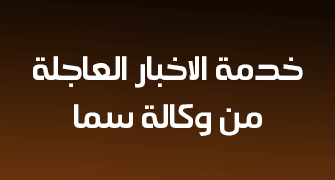ربما يكون الرئيس الأميركي الجديد، دولاند ترامب، منسجماً مع قناعاته في كراهيته للمهاجرين والمسلمين، في رغبته بالدفع بسياسات حمائية للاقتصاد الأميركي تتعارض مع مبدأ مفهوم التجارة الحرة الذي دعمته الإدارات الأميرية السابقة، في رفضه لفكرة أن روسيا هي العدو الأهم لأميركا وفي جعله من الصين عدوها الأكبر، في تأييده لانفصال بريطانيا عن أوروبا، وفي تقليله من أهمية الناتو.
وربما يكون أيضاً منسجماً مع قناعاته في حُبِه "المفرط" لإسرائيل لدرجة التعهد بنقل السفارة الأميركية الى القدس، وتشجيعها على المزيد من الاستيطان برفضه لقرار مجلس الأمن الذي أدان انتهاكها للقانون الدولي، وفي تعهده بإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما يعنيه كل ذلك من وأد لأي فرصة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والدفع بهم الى مواجهة عنيفة ستكون لها تداعيات على منطقة تعاني أصلاً من غياب الاستقرار.
لكن هذه القناعات ربما لا تجد طريقاً لها لأن تتحول الى سياسات رسمية لإدارته لسببين: الأول أن فيها الكثير من المتناقضات التي يصعب الجمع بينها، والثاني أن أعضاء حكومته يحملون أفكاراً لا تنسجم في حدودها الدنيا مع تلك التي يحملها رئيسهم.
كيف يمكن مثلاً استعداء الصين وفي الوقت نفسه إضعاف منظمة الناتو والاستخفاف بأهميتها؟ كيف يمكن إعادة فرض العقوبات على إيران وفي الوقت نفسه إعلان حرب باردة على الصين؟ كيف يمكن بناء علاقات حميمة مع روسيا بدون خسارة الحلفاء في أوروبا؟
ترامب يريد كل شيء وهذا مستحيل. علاقات قوية مع روسيا ستعني في النهاية علاقات ضعيفة مع أوروبا التي لا تقبل بضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا.
عقوبات جديدة على إيران لا معنى لها إذا فتحت الصين وأوروبا أبوابها لها.
إعلان سياسات حمائية للاقتصاد، بمعنى فرض ضرائب على البضائع التي تدخل السوق الأميركي، سيدفع الآخرين بالضرورة لحماية أسواقهم، وهذا يعني أن البضائع الأميركية لن تجد طريقاً مُيَسراً لها في الخارج، وهذا بالنتيجة سيؤدي الى إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة.
ربما لا يوجد إجماع بين الاقتصاديين على أن اقتصاد السوق وما يتبعه من تكريس لمبدأ التجارة الحرة فيه ضرر كبير لبلدان العالم النامية، لكن هنالك إجماعا بينهم أن المستفيد الأول من "عولمة الاقتصاد" هو الدول المتقدمة صناعياً وأولها الولايات المتحدة.
ترامب يريد معاقبة الصين والمكسيك وبنغلاديش وفيتنام وغيرها من الدول التي تستقبل المصانع الأميركية، لكن إعادة هذه المصانع للداخل الأميركي سيرفع كثيراً من أسعار منتجاتها ولن يكون بإمكان المواطن الأميركي شراءها، وهذا سيتسبب في نتائج مماثلة للسياسات الحمائية: إغلاق لمنشآت اقتصادية وبطالة.
غالبية أعضاء فريق ترامب أيضاً لا يشاركونه أفكاره السياسية. جيمس ماتيس، وزير دفاعه، يعتقد بأن تل أبيب وليست القدس عاصمة إسرائيل كما يريد ترامب، وهو يرى أن الاتفاق مع إيران يجب احترامه ومراقبته في نفس الوقت، وهو يرى أن حلف الناتو إستراتيجي لحماية المصالح الأميركية.
ريك تيلرسون، وزير الخارجية والمتهم بعلاقات قوية مع روسيا، يرى أن الأخيرة تعمل على إضعاف المؤسسات الأميركية، وأن تحسين العلاقات معها لا يجب أن تتم على حساب أوكرانيا أو أوروبا.
نيكي هالي، حاكمة ولاية جنوب كالورينا والتي رشحها ترامب لأن تكون ممثلة لإدارته في الأمم المتحدة، على الرغم من أنها تعتقد بأن المنظمة الدولية ليست المكان المناسب لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنها ترى أن المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق تحقيق حل الدولتين وتتفق مع مضمون القرار الأممي الذي يدين الاستيطان.
أجهزة الاستخبارات الأميركية بمختلف أنواعها أيضاً لا تتفق مع ترامب في أي من القضايا الإستراتيجية. جميعها مثلاً، متفق على أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية لمساعدة ترامب على الفوز.
جميعها متفق على أن روسيا ( ومعها الصين) تشكل التحدي الأكبر عالمياً للولايات المتحدة.
جميعها متفق على أن الاتفاق مع إيران منع الأخيرة من المضي في مشروع التحول الى دولة نووية.
وجميعها متفق على أن الحل الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين وعلى أن بقاء هذا الصراع مستمراً مكلفٌ لأميركيا سياسياً وأمنياً.
فوق كل ذلك علاقة هذه الأجهزة مع ترامب فيها الكثير من انعدام الثقة. ترامب يعتبرها عدائية تجاهه ويشكك في تقاريرها، وهي بدورها تشعر بأنه فاقد للخبرة، غير مؤهل سياسياً، وغير قادر على التعلم أيضاً.
وحده، ديفيد فريدمان، مرشح ترامب ليكون سفيراً لإسرائيل، يتفق مع توجهات رئيسه الداعمة للاستيطان، ولنقل السفارة الأميركية الى القدس، والى ترك إسرائيل تقرر وحدها كيفية الحل مع الفلسطينيين.
لكن هل ينطبق هذا على زوج ابنته، جاريد كوشنر، الذي عينه كبيراً لمستشارية وممثلاً له في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نعلم بأن كوشنر منحاز لإسرائيل، لكننا لا نعلم شيئاً موثقاً حتى الآن بشأن مواقفه من نقل السفارة الى القدس، المستوطنات، وحل الدولتين.
في النهاية، إذا أراد كوشنر أن يكون مبعوثاً لعملية السلام فهو مضطر لأن يأتي للمقاطعة في رام الله حاملاً مجموعة من الأفكار التي تساعد على الأقل على حماية حل الدولتين من العبث الإسرائيلي. إن لم يكن لديه شيء يقوله في هذا الموضوع، سيكون من حق الفلسطينيين رفض مقابلته، وتحويله الى مجرد مبعوث من قبل ترامب لحكومة إسرائيل.
في وضع تكثر فيه المتناقضات من الصعب التنبؤ كيف ستكون عليه الحال سياسات أميركا الخارجية في عهد ترامب. في المقابل يمكن الجزم بأن هذه المتناقضات لن تؤدي إلى سياسات مستقرة لأننا سنسمع الشيء ونقيضه من نفس أركان هذه الإدارة. النتيجة ستكون تقزيماً لدور أميركا وإضعافاً لمصالحها عالمياً.
في دولة يحتل الإعلام فيها ساحة الحرب الحقيقية بين النخب السياسية، انعدام الاستقرار في سياسات الإدارة الأميركية، سيعطي الفرصة لأعداء ترامب داخلياً للانقضاض عليه بشكل شبه يومي وتحويل فترة رئاسته إلى وضع لا يطاق، خصوصاً وأن هذا الإعلام كان أصلاً يعتقد بأن ترامب هو مجرد ظاهرة تدعو للضحك ولا يجب أخذها على محمل الجد.
إدارة ترامب: تناقضات لا يمكن الجمع بينها ...محمد ياغي
الجمعة 20 يناير 2017 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT