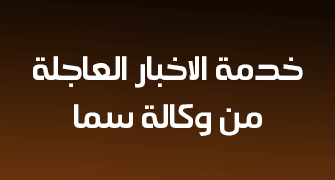كتبتُ أولى مقالاتي في صحيفة يومية كبرى وهامة وأنا لم أزل في الخامسة والعشرين من عمري، قبل ستة وثلاثين عاماً في صحيفة السفير اللبنانية. كان ذلك حدثاً على المستوى الشخصي والمهني استثنائيا بل وخارقاً في زمن الصحافة في ذلك الوقت ببيروت، اذ لم يكن معتاداً او مألوفاً بالنسبة لصحيفة على مستوى رفيع ومنافس من المهنية وليست حزبية، أن تنشر مقالات لكتاب غير معروفين او أقل سناً، وكنتُ أقول دوماً لو أن محرري الصحيفة رأوني شخصياً في هذا العمر لما وافقوا على نشر مقالاتي، إذ إنني أرسلت هذه المقالات عن طريق صندوق البريد وكانت المفاجأة نشرها في اليوم التالي.
ما زلت أذكر مقالي الأول عن طه حسين وكيف بدا الفارق المذهل، والذي لا يمكن وصفه بين شكل الكلمات المكتوبة على الورق بالحبر السائل، وبين رؤية هذه الكلمات مطبوعة بالرصاص الأسود ومخرجة في صحيفة وأي صحيفة؟ ولعلها كانت لحظة أشبه بالانتصار في معركة، وما كان لأحد من المارة ذلك الصباح أن يشعر بحجم انفعالي وحدي، حين نسيت أو غفلت عن نفسي وأنا أقرأ مقالي في عودتي الى البيت، دون أن أنتظر أن أعود إلى البيت. فقد كانت المفاجأة أكبر من توقعاتي أن أُصبح اسماً الى جانب هذه الأسماء الكبيرة التي كنت قارئاً لها حتى الآن.
لكن بعد أربع مقالات ذهبت هذه المرة الى مبنى الصحيفة، وكما يشبه الفاتحين أو المحررين دخلت من بابها الرئيسي، وما زلت أذكر الدهشة والصدمة حين قابلت في الصالون الرئيسي الفاخر رئيس التحرير الأستاذ الكبير طلال سلمان أمد الله في عمره، وكان هناك أيضاً الكاتبة والشاعرة كاتيا سرور والأستاذ محمد فرحات الذي سوف أتزامل معه فيما بعد في صحيفة «الحياة» اللندنية.
وأذكر أن السيدة كاتيا سرور من شدة صدمتها نزعت تلقائياً ولا إرادياً نظارتها وكأنها تريد ان تتحقق مني أكثر، ثم قالت: أهذا أنت؟ لقد حسبناك في سن الخمسين أصلع الرأس بنظارات طبية وكرش، أما طلال سلمان الذي كان صامتاً حتى الآن فقد ربّت على كتفي ثم وجه نحوي الإشارة بإصبع إبهامه كعلامة واضحة تشير إلى أكثر مما تقول.
هكذا سوف أُصبح منذ ذلك الحين كاتباً وصحافياً احترف الكتابة، وكما يحدث في الطقوس المسيحية ما يسمى بالتعميد سنة عن سيدنا المسيح، الذي يقال إن يوحنا أي يحيى قام بتعميده في نهر الأردن، فقد كان تعميدي شخصياً في صحيفة السفير. فهل كان هذا سبباً كافياً لأن أخصص شخصياً هذا الحيز رغم انشغالنا وهمومنا، والتوقف عند هذا الحدث الفاجع والحزين والمؤثر حقاً، توقف هذه الصحيفة يوم 31 كانون الأول عن الصدور. لكنه ليس توقفاً شخصياً وإنما فلسطينياً ومن فلسطين نفسها التي كرست السفير كل مسيرتها طوال الوقت، لأن تكون منبراً وصوتاً لها، من أجل إظهار التعاطف بل والحزن. وقول كلمة وداع لهذه الصحيفة عرفاناً منا نحن الفلسطينيين وتقديراً لدورها في أوقات حالكة.
هذه صحيفة ورقية كبرى تخرج من المشهد الصحافي والإعلامي الثقافي العربي، وكأنها بهذا الخروج ترثي لزمن مر لوقت ولن يعود هو نفسه ثانياً. هو زمن الصحيفة التي بإمكانها كما قال لينين ان تتحول الى مدفعية ثقيلة. وقد كانت السفير منذ تأسيسها العام 1974 زمن الصحافة في بيروت هذه المدفعية، وظلت منذ ذلك الوقت ثاني وأهم وأكبر صحيفتين تستقطبان الرأي العام في لبنان زمن الحرب الأهلية، والصحيفة الثانية هي النهار، التي أسسها الدبلوماسي والكاتب اللبناني غسان تويني، التي تمر هي الأُخرى الآن بأزمة حالية حادة كتلك التي عصفت بمنافستها السفير وأطاحت بها أخيراً.
إن هذا رثاء ولحظة تأمل ممزوج بالحسرة والحنين على زمن يمكن تسميته الآن بعصر الصحافة الورقية المزدهر والذهبي، ولكنها لحظة من أجل التوقف خلالها عند ماضينا، جيلنا نحن الصحافيين والكتاب الفلسطينيين الذين كنا في ذلك الوقت شباناً في مستهل عملنا الصحافي وغدونا الآن شيوخاً. فقد وُلدنا هناك وجئنا من هناك حين كان الفلسطينيون مندهشين يملأهم الإعجاب وربما الغيرة الخفية، من تفوق الصحافة اللبنانية وحداثتها وحتى أساليب الكتابة والتقنية لكتاب ومثقفين. وحيث كان الاعتقاد السائد في الأوساط الصحافية اللبنانية وكأن الفلسطينيين لم يُخلقوا الا للقتال كما كتب ذات مرة جوزيف سماحة أحد أبرز معلقي السفير.
لكن هذا الشعور المركب الذي صارع جيلي للتغلب عليه مع التجربة اللبنانية، ربما هو الذي يظهر الفارق اليوم في المستوى المهني والحداثي الذي تقدمه هذه الصحيفة «الأيام».
في الثانية والأربعين أي في أزمة منتصف العمر او «كوارث الأربعينات» إذا جاز لنا هذا التشبيه، قررت الصحيفة الترجل كما لو أنها الاستراحة الأخيرة، وبدا مشهد النهاية مؤثراً ليلة رأس السنة بإطفاء رئيس التحرير الضوء الذي لم يُطفأ يوماً قبل الآن. وبدا كما لو أن الرجل الذي صنع شيئاً أكبر منه أواسط السبعينات، قد اقتنع وقد بلغ من الكبر بأنه حان الوقت لإسدال الستارة على جزء من تاريخ الصحافة في لبنان، الفصل الأكثر صخباً وجدالاً وصراعاً ولكن ازدهاراً، مفعماً بالشعارات والأحلام.
ومن دون سلالة يمكن أن تورَّث لها الصحيفة مشياً على التقاليد اللبنانية العريقة، حيث الأبناء يرثون الآباء في حكم الحزب والعائلة والميليشيا. فإن هذا الرجل لم يُحضر ابناً لتولي الصحيفة من بعده كما فعل غسان تويني مع نجله جبران تويني، ولكن الذي اغتيل العام 2005 في موجة الاغتيالات التي بدأت برفيق الحريري وطالت عدداً من السياسيين والمثقفين اللبنانيين. وهو ما يطرح نفس السؤال حول مصير صحيفة النهار إزاء ما يتهددها من أزمة مالية وهي أعرق صحف لبنان على الإطلاق وربما أكثرها تميزاً ورصانة في التحرير، والتي طالما كان صديقي وأستاذنا حسن البطل أمد الله في عمره معجباً بهذه الرصانة.
لكن اليوم فإن السؤال حقاً إزاء هذه الأحداث اللبنانية على مستوى تاريخ ومستقبل الصحافة اللبنانية، ماذا تبقى من لبنان القديم نفسه؟ وأي صدى بقي من ذلك التاريخ؟ لبنان عقدي الخمسينات والستينات الذي أُريدَ له ان يكون بمثابة سويسرا الشرق كنموذج مضاد زمن الحرب الباردة في وجه حكم الضباط الأحرار القوميين والبعثيين الموالين لروسيا، او شبكة البنوك والمصارف لشركات النفط في نفس الفترة الكشف حديثاً، ومكان إجازتهم وتنزههم في فنادقها الفخمة وسحر طبيعتها الخلابة؟ أم في ذات سنوات الخمسينات والستينات تنقل رجل المخابرات المركزية على الطريق البري بين بيروت ودمشق، حاملاً شنطة المال على تلك الحبال فوق الرمال لتدبير الانقلابات في سورية، حين كان الصراع على سورية على أشده؟ أم تراه لبنان الصحافة في ذلك الزمن الذي طالما أزعج جمال عبد الناصر؟.
لبنان بعد ذلك في عقد السبعينات وتدبير هنري كيسنجر الماكر الحرب الأهلية؟ ونشهد ذروة هذه الموزاييك من التدخلات الأجنبية وتصفيات الحسابات على أرض لبنان، وحيث كان هناك لكل من اللاعبين ميليشياته وحزبه وصحافته ورجال. وفي القلب من ذلك المقاومة الفلسطينية ولبنان الكوزموبولتي أشبه بكومونة باريس الثوري الخارج عن أي تقاليد يجد ملاذاً فيه كل معارض او مثقف مضطهد أو ملاحق في بلاده، كما وصفها محمود درويش بخيمتنا الأخيرة.
هل كان لبنان يشهد عند هذه الذروة شهقته الأخيرة؟ لكننا تعلمنا من اللبنانيين منذ ذلك الوقت تلك اللعبة التي لا يتقنها سوى اللبنانيين الأكثر ذكاء في الحفاظ على تلك المسافة الرقيقة والخفية ولكن غير المرئية بين مصادر تمويلهم، وحيث كل الصحف اللبنانية تتوفر على هذا التمويل الخارجي ولكن دون أن يكون لذلك أي صدى أو تأثير ملموس على سياستها التحريرية ومحافظتها على المهنية. وإن ما حدث أن العالم العربي لم يتغير وإنما لبنان هو نفسه الذي تغير، حيث لم تعد تستدعي مماحكات اللبنانيين الداخلية التي لا تنتهي أي اهتمام من الخارج.
في وداع صحيفة «السفير» اللبنانية: زمن الصحافة في بيروت ...حسين حجازي
السبت 07 يناير 2017 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT