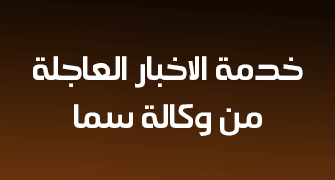مع اندلاع ثورات الربيع العربي في مستهل عام 2011؛ وقفت عدة مفاهيم فقهية تقليدية - كإمامة المتغلب وتحريم الخروج على الحاكم وطاعة ولي الأمر والتخويف من الفتنة - في مواجهة طموح الشباب الثائر، وتم استحضارها من بعض الشيوخ لشرعنة واقع الاستبداد، وتقويض الروح الثورية في الشعوب.
هذا الموروث الفقهي الذي يداهن الحكام المتسلطين، ولا يراعي مصالح الشعوب المقهورة؛ استفز الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني ليقدم قراءة فقهية جديدة في كتابه "فقه الثورة.. مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي"، تبرز إيجابية الدين في التصدي للظلم والفساد، وتحقق مقاصد الدين العليا، متمثلة في العدل والكرامة الإنسانية.
بدأ الريسوني كتابه بالتذكير بأن الفقه الإسلامي عموما هو اجتهاد بشري، فإذا كان الوحي معصوما؛ فإن فهمه والاستنباط منه ليس عملا معصوما، مؤكدا أن الممارسة التاريخية للدول الملكية الحاكمة عبر التاريخ الإسلامي؛ ليست بالضرورة امتدادا لسنة الخلفاء الراشدين، بل إن هذه الممارسة تأثرت بأنماط الحكم السائدة يومذاك، بما فيها الأنظمة التي أسقطتها الفتوحات الإسلامية من هرقلية وقيصرية.
يعالج الكتاب مفهوم "إمامة المتغلب"؛ فيبين أن الفقهاء الذين تعاملوا معه لم يعطوه شرعية في ذاته، بل اعتبروه حلا اضطراريا وفق مبدأ أهون الشرين وأخف الضررين، لكننا الآن في زمان يتيح لنا بتجاربه ووسائله الخروج الكامل من عهود الحكام المتغلبين، حيث بات شائعا في معظم دول العالم أن الحاكم يتولى الحكم لفترة معينة على أساس التزامات دستورية يحاسب إن خرج عليها.
أما مصطلح "أهل الحل والعقد"؛ فيرى الكاتب أنه لا يعدم أصولا شرعية، وإن لم يُنص عليه بهذا الاسم، فإنه ينطوي على مشكلين:
الأول: أنه لم يؤخذ مأخذ الجد، فبقي محصورا في أذهان الفقهاء ومؤلفاتهم وتمنياتهم، وفي أحسن الأحوال قد يوجد نوع من أهل الحل والعقد، ولكن أمرهم كله إلى الحاكم نفسه؛ بما في ذلك اختياره لهم، واختياره بين استشارتهم وعدمها، واختياره بين اتباع المشورة وعدمها.
الثاني: أن فكرة الحل والعقد اتخذت وسيلة للإلغاء الفعلي لدور الأمة ومشورتها، واستبعاد أي أثر لها في تدبير أمورها، فبدل أن تطبق الفكرة وتصبح هي التعبير المنظم عن إرادة الأمة؛ أصبحت مجرد حجة نظرية تلغى بمقتضاها الأمة، بدعوى أن أهل الحل والعقد يقومون مقامها، بينما الواقع هو أن الحاكم بأمره هو الذي يقوم مقام الجميع.
ويعالج الريسوني مسألة اختيار الحاكم؛ فيقرر أنه حق الأمة الذي تمارسه حسب الاستطاعة لكل زمان ومكان، وأن سنة الخلفاء الراشدين جرت على ذلك. وعلى سبيل المثال؛ عند تولية الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ نهض عبدالرحمن بن عوف يستشير الناس؛ حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب.
واستنادا لتقاليد البيعة الإسلامية؛ فإن شرعية السلطة الحاكمة تعتمد على رضا الشعوب واختيارها الحر، طبقا لتطورات نظم الحكم وإجراءاته في الدولة الحديثة، وما استقر عليه العرف الدستوري من توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفصل الحاسم بينها، ومن ضبط وسائل المراقبة والمحاسبة، بحيث تكون الأمة هي مانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة.
وينقل الكاتب عن بيان صادر عن الأزهر في أوج الحراك العربي عام 2011، تفنيده استناد كثير من الحكام إلى الآية الكريمة: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" لتعزيز سلطتهم المطلقة، فيبين أن هذه الآية جاءت في سياق شرطي يتمثل في الآية التي تسبقها مباشرة: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، مما يجعل الإخلال بشروط أمانة الحكم، وعدم إقامة العدل فيه؛ مسوغا شرعيا لمطالبة الشعوب للحكام بإقامة العدل ومقاومتها للظلم والاستبداد. ومن قال من الفقهاء بوجوب الصبر على المتغلب المستبد من الحكام حرصا على سلامة الأمة من الفوضى والهرج والمرج؛ فقد أجاز في الوقت نفسه عزل المستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك، وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها".
الثورة والفتنة
يفند الفقيه الريسوني معارضة بعض العلماء للثورات ووصفهم إياها بأنها فتنة، ويقول إن الفتنة المذمومة شرعا هي الوقوع في أحوال تجر إلى منزلق المعصية والضلال مما لم يأذن به الله، أما ما هو مأمور به فليس بفتنة، ولو استلزم بعض التدافع والخوف والضرر الدنيوي، بل السنة الإلهية الجارية. والحقيقة التاريخية الثابتة؛ هي أن الإصلاح والتمكين له لا يكون إلا من خلال التدافع.
ويخلص الريسوني: "فليس في القيام بشيء مأمور به فتنة، وليس في طلب حق مشروع فتنة، وليس في إنكار منكر محقق فتنة، وليس في دفع ظلم بيّن فتنة، وإنما الفتنة في ظلم الناس، وفعل المنكر، وغصب الحقوق، وفي السكوت على ذلك، وتركه يتراكم ويتعاظم حتى لا يبقي للناس دينا ولا دنيا".
ويعدد الريسوني بعض "حالات الفتنة" في واقعنا المعاصر، مثل الخروج المسلح على الجماعة والحكام الشرعيين، ومبادرتهم بالتمرد والقتال سعيا إلى الإطاحة بهم أو الانفصال عنهم، والفتنة الصادرة عن الحكام الظالمين المفسدين أنفسهم ومن معهم من العلماء المتكسبين، والاقتتال الطائفي أو القبلي أو العشائري أو الحزبي، طلبا للحكم، أو لمجرد الغلبة والعصبية والثأر والانتقام، لكن ليس من بينها الاحتجاجات الشعبية، فالتحركات الجماهيرية الاحتجاجية التي شهدتها دول عربية في 2011 هي ذات مطالب إصلاحية، وكانت الحركة الاحتجاجية واسعة وشاملة لكل مناطق البلاد، ولكل شرائح المجتمع وفئاته.
مفهوم تطبيق الشريعة
يتطرق الكتاب إلى الجدل الذي أثير ما بعد الثورات العربية حول تطبيق الشريعة الإسلامية، ويرى أن منطلق السؤال يتضمن خللا، فأحكام الشريعة هي عين المصلحة الحقيقية للناس أفرادا وجماعات، فلا تعارض بين الشريعة الحقيقية والمصلحة الحقيقية، لأن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، ومبناها على الحِكم، وهي عدل كلها ورحمة كلها، والاستعمال المضيق للشريعة الإسلامية لا ينبغي أن يحجبنا عن المعنى الأصلي والكامل للشريعة، فكل ما يحقق كرامة الإنسان وأمنه وحريته؛ هو من إقامة الشريعة، وكل عمل يرفع عن الناس الظلم والقهر والتسلط والاستبداد؛ فهو من صميم الشريعة.
ويشير الريسوني في هذا السياق إلى أن تطبيق الشريعة مسؤولية المجتمع كله، وليس السلطة وحدها، فالشريعة ليست بالضيق الذي يرهنها ليد القضاة ومحاكمهم أو الرؤساء وحكوماتهم، فإن هم طبقوها فقد طبقت ورفعت رايتها، وإن هم نبذوها فقد عطلت ونكست رايتها، وأهمية السلطة دون أهمية المجتمع، والجريمة الكبرى التي يرتكبها كثير من حكام المسلمين ليست هي عدم تطبيق الشريعة في سياستهم وقوانينهم، وإنما هي تكبيل الشعوب وما فيها من طاقات، وتخويف الناس وصرفهم ومنعهم من القيام بما يمكنهم القيام به من مصالحهم وواجبات دينهم.
ومع ذلك، فإنه - بحسب ما يرى الكاتب- لا بد من الدفع دوما نحو تصحيح التشريعات والسياسات، حتى لا يبقى فيها تعارض مع الشريعة، بل حتى تصبح نابعة منها، وهذا يحتاج إلى تدافع حكيم وتدرج موزون، بحسب سياق كل بلد، وما يمكن فيه، وما لا يمكن.
الخيار الديمقراطي
وفي فصل بعنوان "النظام السياسي في الإسلام والخيار الديمقراطي"؛ يرى الريسوني أنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسي مفصل، ولو كان هناك وجود لهذا النظام؛ لما كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لذلك ترك الإسلام النظم التفصيلية للسياسة والحكم للاجتهاد الظرفي، والتطور الزمني، واكتفى بوضع معالم عامة، وقواعد أساسية.
ويعدد الريسوني هذه القواعد الأساسية، مثل الشورى، والمرجعية العليا للشريعة، وإقامة العدل بين الناس، وهو المقصد الأساسي الذي لأجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، ومن القواعد العامة؛ أن يكون تصرف الإمام منوطا بمصلحة الرعية، وفي ضوء هذه المبادئ الكلية؛ لا يكون هناك تعارض بينها وبين النظام الديمقراطي الذي يقوم على حق الناس في اختيار من يحكمهم وينوب عنهم، والحق في مراقبة الحكام ومحاسبتهم، والتداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات، وحق تأسيس الأحزاب والمنظمات للتعبير الجماعي والعمل الجماعي، والحق في حرية الصحافة وحرية التعبير لعموم الناس، والفصل بين السلطات.
ويناقش الريسوني اعتراضات بعض الدعاة على الديمقراطية، فهناك من يحاجج بأن عند المسلمين ما يغني عنها، وهي الشورى، والجواب هو أن الشورى أساس ونهج وليست نظاما وطريقة، وفي ظل وجود ثروة من التجارب والنظم؛ فلماذا لا نأخذ منها؟
ويعترض آخرون بأن الديمقراطية ولدت في أحضان ثقافة وثنية يونانية، لذلك فهي فلسفة حياة، وليست مجرد نظام سياسي، ويرد الريسوني بأن هذا الإشكال مجرد تكلف، فالديمقراطية ليست شيئا في بطون كتب الفلسفة، بل هي شيء معيش ومشاهَد، وهي نظم وأساليب تتلاءم وتتعايش في مجتمعات وثقافات مختلفة، وهي لم تفرض على الناس دينا، ولا رفضت لهم دينا، فلماذا الرجوع إلى نسبها وأصلها؟ أليس هذا مجرد فضول ليس تحته عمل؟
ويرد الكتاب على "شبهة" أخرى تقول بأن الديمقراطية تعطي السيادة للشعب، فتجعل كلمة البشر فوق كلمة الله، وبحسب الريسوني فإن الرد ميسور على ذلك، "فإن من بدهيات الديمقراطية؛ القبول بما تختاره الشعوب وتتمسك به، ولا أحد يجادل في تمسك المسلمين بالأحكام الثابتة في دينهم".
ويناقش الكاتب جدل الدولة الدينية والمدنية، فيقرر بداية أن الإسلاميين المتحفظين على مصطلح "الدولة المدنية" متفقون على رفض ضدها، وخاصة الدولة الثيوقراطية في التاريخ المسيحي الأوروبي، فالدولة التي يؤمن بها الإسلاميون بكل مدارسهم، بمن فيهم السلفيون، ليس لأحد فيها قداسة، أو عصمة، أو سلطة مطلقة، وليس فيها من يأتي إلى الحكم أو يمارسه بتفويض إلهي، وكل واحد فيها يؤخذ من كلامه ويرد.
ثم يوضح الكاتب أن موطن الخلاف هو خشية المتحفظين من الإسلاميين من إمكانية الاعتراض على أي قانون ذي مرجعية إسلامية، بحجة أننا في دولة مدنية لا دينية. ويرى الريسوني أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فالألفاظ ليست تعبدية، والعبرة بالتفاصيل والنصوص الدستورية والقانونية العملية.
مخاوف غربية
وفي الفصل الأخير من الكتاب؛ يعالج الريسوني المخاوف من أن يؤدي حكم الإسلاميين إلى صدام مع الدول الغربية، ويرى في هذا الصدد أن تخوف الغرب من الإسلام والمسلمين هو حالة تاريخية، ويقر بأن هناك عقدة غربية تجاه الإسلام، فهم لا يريدون رؤيته يحكم، ويعطي التشريعات، ويلهم المواقف والسياسات، أما من الناحية الإسلامية؛ فنحن لا نرفض الغرب بسبب دينه أو علمانيته، بل بسبب جرائمه وسياساته الاستعمارية العدوانية الحديثة، واستمراره في نهج سياسة التسلط والتحكم.
وبالرغم من هذه النظرة الغربية "القاتمة"؛ فإن الكاتب يحرص على إبقاء نافذة أمل؛ فيرى أن الغرب بعد ثورات 2011 آخذ في مراجعات تقييمية، وتغييرات سياسية، ستعيد صياغة موقفه وتعامله مع الإسلام والإسلاميين على نحو يفترض أن يكون أكثر واقعية وتفهما وإيجابية وتسامحا، وهذا يحتم على الإسلاميين اغتنام الفرصة والتعامل المصلحي الإيجابي مع الغرب، فالعلاقات السياسية لا تبنى على العواطف الإيجابية أو السلبية، وإنما تبنى على المصالح المتبادلة.
بقيت الإشارة إلى أن كتاب الريسوني صدر بداية عام 2012، في ظل موجة تفاؤلية اجتاحت الشعوب العربية بتبديد ظلمات الاستبداد وبزوغ فجر الحرية والديمقراطية، لذلك فإنه لم يتناول التعقيدات التي أضيفت إلى المشهد العربي بعد ذلك، والتي تمثلت بتعسر الثورة السورية، والانقلاب على خيارات الشعوب في مصر واليمن، لكن رغم ذلك تبقى للكتاب قيمته في التأسيس لمشروع فقهي يتجاوز "الموروثات السلبية" التي شرعنت الرضوخ للظلم والاستبداد، وإيجاد فقه يناسب هذا العصر ومتغيراته؛ بما يحقق النفع للأمة، ويحقق لها ذاتها وكيانها.