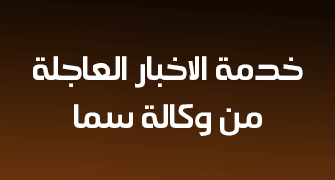رام الله - يحكي المفكر الراحل السيد هاني فحص، عن مساره الذي بدأه من بلدته الصغيرة جبشيت وولعه باللغة العربية منذ الصغر قبل أن يختار المشيخة التي ساعدته فيها دراسته بالنجف، مرورا بتجاربه السياسية والنضالية والتي أثارت شغفه فيها من طفولته قضايا مصيرية مثل العدوان الثلاثي وفترة الرئيس المصري عبد الناصر في مصر، وكذلك فلسطين ومعاناة الفلسطينيين إبان قيام دولة الاحتلال، بالإضافة لقضايا الوحدة العربية التي كانت تمثلها مصر وسورية، وهو الذي كان يقول إن "الروح الكلية التي تحكم التاريخ، والفضاء الرحب للتعدد والاختلاف. كنت أرى ديني فيها، إنسانياً مشتاقاً للتغيير والعدالة، يتسامح مع الكفر بشرط العدل".
ويشرح الراحل السيد هاني فحص في حواره الذي أجرته الباحثة اللبنانية ثناء عطوي لفائدة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث معه في شهر كانون الأول 2013، طريقة تحوله من الحس الثوري والسياسي إلى الاهتمام الديني والمشيخة التي تحولت بدورها عنده إلى جدل فكري، بقوله: "لم أتحمس للديني، مع عمق إيماني، تحمست للحياة والحضارة، وتحمست لدور الدين فيها. وقد وصلتُ إلى النجف فلاحاً فالتاً من أية سلطة، لا سيطرة لأحد عليّ، كانت الفوارق الطبقية كثيرة وقاسية بين طلاب الحوزة، فعقدت التصور وولّدت عندي قلقاً معرفياً كان وراء سعيي للمعرفة للتعويض عن الحرمان أو الفقر، وحوّلني ذلك إلى مشاغب فكري، وطرح عليّ أسئلة لا تنتهي (..) وأنا في الحوزة. قرأت دوستويفسكي، وتولستوي وكافكا وإدغار آلان بو وسارتر ونابوكوف وبابلو نيرودا وأدونيس وغارودي وكولن ولسون".
ويضيف الراحل، "كنت ابن الجميع، ولا أزال أتواصل مع الجميع، وأقرأ روايات قرأتها قبل خمسين سنة، حتى أستاذ الصف الابتدائي لم أنسه، وحتى الشوكة التي وخزتني في القرية لا أزال أحنّ لها. قليل من الكتب، والكتاب لم يترك أثراً في وعيي مع أو ضد. ولذلك، أبدو أني أعيش في الماضي، ولكن لا أحاول أن أحمله إلى الحاضر، أراه من خلال اشتراط الحلم بالذاكرة".
حافظ الراحل على تمسكه بالقضية الفلسطينية حتى النخاع ورفض أي مساومات تمس عمق القضية لكن بأسلوب حي وواقعي بعيدا عن الدماء والتشدد ولأجل ذلك قال في حواره، "لا عدو لي إلا إسرائيل، لكن عداوتي ليست على النسق العربي المحكوم بالمبالغات التي تنتهي إلى فداحة في التنازلات، أنا أقبل بدولتين وأقبل بدولة واحدة. أقبل بدولة واحدة، وأرجحية لليهود فيها. أوافق على أن يبقى رئيس الدولة الواحدة، حتى آخر العمر يهودياً. لا أريد أن أحل المأساة الفلسطينية بمأساة يهودية أخرى. القضية الفلسطينية هي قضية حق الشعب الفلسطيني أولاً، لها بُعد عربي وديني، لكنها قضية الفلسطينيين بالذات، وتديينها أو أسلمتها هو أسرلة لها، هذا لا يعني أن معناها خالٍ من الدين، إنه غني جداً بالمشترك الروحي الديني وتحت مظلة التوحيد الإبراهيمي، وهذا ما يمكن الاستفادة منه من أجل خلاص القدس وفلسطين من التهويد. إن التنمية هي الحل، وهي المقاومة الحقيقية".
"أيام الثقافة" وبالتنسيق مع "مؤمنون بلا حدود"، وجريدتها الفكرية الثقافية "ذوات"، تنشر مقتطفات من الحوار:
* كيف أصبحت رجل دين (شيخاً)؟
ـ ما "مشيخني" وجعلني أذهب إلى الحوزة الدينية أمران، هما: اللغة العربية، وعاشوراء من حيث اتصالها باللغة كحساسية إبداع، والشهود الحقيقي والشهادات إبداع. منذ طفولتي وأنا أتمتع بحساسية لغوية، بإيقاع المفردة والصورة، تولّد عندي عالم بديل أعيشه كأنه حقيقي، مجاز اللغة عندي أجمل من الحقيقة اللغوية الجميلة. كنت أقرأ وأكتب ما يشبه الشعر ومواضيع الإنشاء بطريقة لافتة، وكانت اللغة كأنها شأن المشايخ وحدهم، فأطلقوا عليّ لقب الشيخ وأخذتها بجدّ.
بعد أن اجتزت المرحلة الابتدائية سنة 1958 أقنعتُ أمي بأنه ليس من الضروري أن أتعلم، وأنه ينبغي أن أذهب للعمل في بيروت. وكان والدي قد جاء في هذه الفترة إلى المدينة للعمل أيضاً في ورش البناء مع المعلم الذي هو صهره، فوجدتها فرصة، لكني لم أعرف كيف وماذا سأعمل؟ اشتغلتُ في مصبغة لتنظيف الملابس وكيّها لأيام، واشتغلتُ في فرن لأيام كذلك، وفي أماكن عدة فوجدت الأمر صعباً، عدتُ ومكثت في البيت، ثم حاولت تعلّم مهنة الخياطة لعدة أشهر من العام 1959 لدى الخياط سهيل داغر في بيروت، ثم صبحي نحلة في النبطية، مع عودتي إلى الدراسة بمبادرة من خالي حبيب. كنت أمضي وقتي مع جارتنا العجوز أم علي حرب في الرويس من الضاحية الجنوبية لبيروت، أراقبها، وهي تزرع الأرض (خس وبقدونس وفجل وهندباء)، أسلّيها وأقرأ لها كل ما حفظت، ومن بينها قصة عاشوراء التي حفظتها جيداً، وشاركت في تمثيلها في مسرحية حضرها أهل القرية كلهم. كنا نسعى للاحتفاء بعاشوراء في القرية، حتى لا يذهب الناس إلى مدينة النبطية، ويشاهدوا احتفال الدم الذي يجري كل عام في هذه الذكرى. كان السيد محسن الأمين هو المؤسس لهذا الاجتهاد الذي حرّم جرح الرؤوس منذ العقود الأولى من القرن العشرين، وفسّقه كثيرون، وكفّره البعض على ذلك، وأصرّ - ولأول مرة في تاريخ الشيعة - يصرّ مرجع على الإصلاح والتجديد ويبقى مرجعاً، وربما كان بعض الفضل في ذلك راجع إلى مكانته وسط التعدد الديني في دمشق.
* ألم تكن لديك أحلام غير الجنة؟
ـ لم يكن هناك فلاح من قريتي إلا وحلمه الجنة؛ لأن المتوفر من عناصر الحياة ضئيل جداً وصعب. كنا نحلم بالمدينة ولو بقينا على هامشها، لأن الجنة التي في وعينا تشبه المدينة، وخاصة بيروت ودمشق. كنا نعرف النبطية التي لا تختلف كثيراً عن القرية إلا شكلاً، كمدينة من خارجها من بعيد، غالباً ما كنا نذهب إليها سيراً على الأقدام إلى المدرسة أو سوق يوم الاثنين، أو نمرّ منها إلى بيروت عند الضرورة، القرى المجاورة لم نكن نعرفها إلا في حدود ضئيلة، لأن ركوب السيارة مكلف والطرق البرية وعرة وفيها أفاع ووحوش. كان عالمنا محدوداً جدا، ولولا المذياع لما عرفنا بعض ما يجري من حولنا. حتى اليوم الجنة لا تزال حلماً، لكن تشكلات وعينا لها وتصورنا عنها تغيّر... صارت وصرنا أعقد.
* ماذا كنت تعرف عن السياسة؟
ـ كنت أهتم في طفولتي بالعدوان الثلاثي وعبد الناصر ومصر والسويس، إضافة إلى فلسطين التي كان نازحوها أمام أعيننا في أمكنة تشبه العراء، عرضة للصقيع والحشرات والعوز والغربة، تلك مفردات كانت تشغل رأسي، ثم استفزّتنا الوحدة العربية بين مصر وسورية، وتعاملنا معها وكأنها حل نهائي لقضايانا، وفجعنا بالانفصال. رُحنا نجمع المال بالقرش، حتى نذهب ونرى عبد الناصر، ذهبنا إلى قصر الضيافة في سورية، ورأيناه في عيد الوحدة، ورددنا أمامه "يا عروبة مين حماك غير البعث الاشتراكي"؟ قبل أن يوقع البعث على وثيقة إعدام الوحدة مع قادة الانفصال... كان المذياع يومياً في حياتنا، إذاعة القاهرة والبرنامج الثاني وصوت العرب، كانت عبارة عن سينما ومسرح ومكتبة مجانية ومكان لمناقشة أطروحات الدكتوراه، عرفت يوسف إدريس ونجيب محفوظ وصلاح عبد الصبور وصلاح جاهين عبر المذياع، وسمعت جلسات نقاش الكتب والمسرحيات، ولا يزال المذياع أنيسي حتى اليوم.
* كيف استطعت أن تجيّر حماستك الثورية نحو الديني؟
ـ لم أتحمس للديني، مع عمق إيماني، تحمست للحياة والحضارة، وتحمست لدور الدين فيها. وقد وصلتُ إلى النجف فلاحاً فالتاً من أية سلطة، لا سيطرة لأحد عليّ، كانت الفوارق الطبقية كثيرة وقاسية بين طلاب الحوزة، فعقدت التصور وولّدت عندي قلقاً معرفياً كان وراء سعيي للمعرفة للتعويض عن الحرمان أو الفقر، وحوّلني ذلك إلى مشاغب فكري، وطرح عليّ أسئلة لا تنتهي. صيّرتني هذه الفوارق بسيطاً على قلق وطموح مبكر، حاضرتُ في كلية الفقه وأنا عندي 18 سنة. وجدت في النجف أبعاداً جذابة، فهي مكان مشبع بالحرية. في النجف نختار أساتذتنا، نختار زملاءنا، نختار كتابنا وساعات الدرس، نختار ألا ندرس. كانت هناك حرية إلى حد ما سمّوه الفوضى المنظمة. التأسيس الحوزوي هكذا، من المسجد في بدء الدعوة إلى النظامية في بغداد إلى الزاوية في ليبيا والزيتونة في تونس والقرويين في المغرب...إلخ، والمؤسف أن هذه الحرية لم تستغل بشكل عقلاني وشجاع ومثابر في التجديد، ما جعل التقليد في مأمن، ومنحه قدرة على المواجهة الشرسة أحياناً لأفكار التجديد المستعجلة والملتبسة، وهذا جعلني أتابع وأقرأ كأني بعيد عن الحوزة وأنا في الحوزة. قرأت دوستويفسكي، وتولستوي وكافكا وإدغار آلان بو وسارتر ونابوكوف وبابلو نيرودا وأدونيس وغارودي وكولن ولسون ..الخ.
* بنيت عالماً مختلفاً عن رجال الدين عموماً؟
ـ الهوية صيرورة وليست كينونة، لم أستطع مرة أن أعرّف نفسي، ولا أزال أعشق التحرر من التعريف، لأن المعرفة تتوقف إذا حبستها في تعريف صوري. عندما أعرّف نفسي أصبح كائناً أرسطياً؛ أي ساكناً إلى حد الأسطرة، بينما أنا كائن جدلي، هيغيلي إلى حد ما. وأول تقرير كتبته في الفلسفة في كلية الفقه كان عن "الفوارق المنهجية بين الجدل الهيغيلي والجدل الماركسي". كنت أدرس في الحوزة نهاراً وفي الثانوية ليلاً لأشهر، وصاروا يسمونني جبران لكثرة ما كنت أقرأ وأكتب نصوصاً رومانسية قلقة ومتسائلة. حاولت مرة العودة إلى لبنان من شدة الحنين، والمفارقات التي فاجأتني في حياة الحوزة، لكني تراجعت لرغبة والدي الكبيرة في تحصيل علومي الدينية في النجف بهدف الجنة أيضاً.
في "الحوزة"
* أسست عائلة وأنت في الحوزة؟
ـ يصبح الزواج في الحوزة معادلاً للدين والجنة والعلم. كنا من دون نساء بلا نظام نفسي ولا جسدي، ولولا كثرة الماء لما كانت نُظفت أجسادنا. كنا نحسد المتزوجين من رفاقنا على الحب والنظافة، كنا نعيش في صحراء لا ظل فيها، ومن هنا كان ظل الزوجة يشدنا روحياً وجسدياً، وكان حجاب المرأة المسيطر على المشهد اليومي يزيدنا لوعة وشوقاً إليها وتفكيراً بها ... وحلماً، وارتكبنا كوارث في الطبخ فشعرنا بالمرأة كضرورة حياة. عدتُ إلى لبنان بنية الزواج بعد سنة، لكني وجدت من أحببتها متزوجة، وبالمناسبة فقد أحببت أكثر من عشرين صبية قبل ذهابي إلى النجف؛ فمن لا يحب في القرية يكون أقل من عصفور. تقدمت للزواج من شقيقتها فرفضتني، والسبب أنه لا يوجد سينما في النجف، فعدت من دون زواج. في زيارتي اللاحقة، تزوجت وأنا في سن الـ 19، وهي كانت في سن الـ 14. المرأة تكمّل الطبيعة الجميلة في القرية، وتكمّل احتمالات الخصب، هي حاجة روحية عميقة... وقد وقعت روحي في زوجتي على عقل وروح تجاوزت عمر الجسد.
* هل ممنوع على المرأة أن تدرس في الحوزة؟
ـ لا أعرف، أو أعرف أنه لا مانع ولكن كان هناك مانع، واليوم يحصل ذلك كثيراً في قم، ونادراً في النجف، لكن ليس لغرض علمي، بل سياسي، وإن كانت المرأة قد اهتدت إلى حريتها في معاقرة المعرفة وعنائها المغري. لكن لم يكن يوجد ولا امرأة معنا. ألف عام من تاريخ الحوزة، لم تكن هناك امرأة واحدة، علماً أن الحوزة أسسها الطوسي (محمد بن الحسن، ت 460هـ)، وهو عندما جاء من بغداد بعد أن طرده السلاجقة وهدّموا مكتبته وبيته، جاءت معه فتاة عالمة (كريمته)، ولم يتكرر ذلك. المدينة هي عقل المرأة. أما القرية، فهي قلبها، وفيها يتكوّن عقلها على قياس قلبها، لا على قياس حقوقها، والمدينة أمر يختلف كثيراً وعميقاً عن المساحة وعدد السكان والبناء العمودي والصخب اليومي ... المدينة امرأة تحتضن وتجمع جميع أولادها بعدل في الحب والحليب، وبصرف النظر عن تفاوتهم في الجمال والقوة والمال والبرّ بها.
* أشرفت على مجلة "النجف" مدة سنة، كيف اتجهت إلى الصحافة؟
ـ الصحافة الفكرية غير الصحافة اليومية، ولذلك ليس دقيقاً القول بأني انتقلت إلى الصحافة، هذا حصل قبل سنوات في لبنان، عندما كتبت مقالات في الشأن اليومي لأسباب معيشية. وكان في كلية الفقه منبر كنت أتلو منه خطابات في الشعر والأدب والتاريخ، وكنت أكتب قصة ونقداً أدبياً، وعندما أرادوا أن يجددوا المجلة، اختاروني مشرفاً تنفيذياً على العمل فيها كلها. استمرت المجلة سنة قبيل النكسة (67) وبعدها، وكان العدد الأول عن فلسطين، وبعده جرى التركيز على الحداثة واللغة العربية من دون أن تغيب فلسطين. أسهمت المجلة في التأسيس لحالة ثقافية، واتهمني أشخاص من حزب الدعوة بأن المجلة مشبوهة، وتحمل الصفات التالية: أولاً، أن اسمها مكتوب بالكوفي؛ أي أنها قومية عربية، ثانياً أن اسم المجلة على اليسار يعني أنها يسارية، ثالثاً أننا بدلنا الغلاف وأصبح "لوزانج" شبكة معينات، ما يعني ديالكتيك، رابعاً أننا صدّرنا العدد الأول باللون الأسود والخطوط البيضاء، وهذه سوريالية أو وجودية.
بعد ذلك شاركت أنا والسيد محمد حسن الأمين في إصدار أول مجلة أدب حديث في العراق، اسمها "الكلمة"، صدر العدد الثاني منها وعلى الغلاف صورة غيفارا بالأحمر "حي في كل رصاصة". بقيت المجلة تصدر لفترة طويلة، وكان فريقها مؤلفاً من حميد المطبعي، موسى كريدي، عبد الإله الصايغ، عزيز السيد جاسم، حسين مردان، زهير الجزائري، جان دمو، رزاق أبو الطين، زهير غازي زاهر، موفق خضر سعيد، وغيرهم.
* كنت متأثراً بشخصية غيفارا؟
أعجبتني فيه روح التضحية وما في داخله من حلم بالعدالة. بكيت عليه عندما مات وعلقت صورته في المنزل، من يحب الإمام علي يقدّر نضال غيفارا، ومن يحب الحسين سيحب غاندي، ومن يقرأ زين العابدين يتلذذ بقراءة نيرودا وأراغون والسياب ومحمود درويش. هذه الروح الكلية التي تحكم التاريخ، والفضاء الرحب للتعدد والاختلاف. كنت أرى ديني فيها، إنسانياً مشتاقاً للتغيير والعدالة، يتسامح مع الكفر بشرط العدل. الكلاسيك حماني، لأنه كان على علم وتقوى ومطمئناً إلى نيتي وليس الحداثة النجفية التي كانت ضعيفة وغير عميقة... وهي غير محاولات التغيير من الداخل كتجربة (منتدى النشر) المعروفة في العراق.
حركة فتح وأبو عمار
* كيف قرأت الحرب الأهلية في لبنان؟
لم أكن مقتنعاً بالحرب، واعترفتُ بمسؤوليتي مبكراً سنة 93 في مؤتمر في تعنايل. قلت: إن الدم على طرف جُبّتي نتيجة موقف خطأ أو السكوت عن أمر معين. حركة فتح وحزب الكتائب والحركة الوطنية جميعهم كانوا شركاء حرب. كنا ضد الحرب، ولم يذهب شاب إلى هذه الحرب الأهلية وأخبرني فرضيت، ولم يعد شاب من هذه الحرب وباركته. لم أرَ أماً من أمهاتنا راضية بالحرب. أسسنا مع بطرس لبكي وروجيه عساف وإبراهيم الشويري وجورج ناصيف ومعين حمزة وأحمد علامة ونايف سعادة والراهبة المارونية نبيهة عفيف والأب الماروني مكرم قزح والكاثوليكي الأب سليم غزال، "لجان إطفاء" في المناطق لتخفيف الاحتقان، وكانت تجربة مختلفة ومهمة... كانت تأسيساً في ظروف الحرب لحوار أهلي وعيش مشترك عميق.
*ترفض الحرب الأهلية، وتناضل في صفوف حركة فتح؟
ـ التحقت سنة 1974 بحركة فتح، كنت أعلّم في مؤسسات الإمام الصدر في المعهد الشرعي، حيث كنا ندرب الشباب على القتال وفك السلاح وتركيبه برضا الإمام الصدر بناء على التزامه بالمقاومة، كانت "فتح" فضاء واسعاً، ولا مرة تلقينا أمراً ولا مرة جاءنا تعميم تنظيمي، ولا التزمنا برأي أو موقف. كانت حركة شعب، وكان لنا إطارنا التنظيمي المرن، نحن الذين تربينا خارج "فتح" عقائدياً، كنا نُصدر مجلتنا ونوزعها سراً عن تنظيم "فتح" أيضاً، وعندما لا يعجبنا هذا القيادي نذهب إلى غيره، وإذا اختلفنا مع أبي موسى مثلاً، نذهب إلى أبي الوليد أو جواد أبو الشعر، وهكذا. خضنا أول عملية سنة 1973 قبل أن ننخرط في صفوف "فتح"، كنا نذهب ليلاً بعد أن نفطر ونصلي، نستقلّ سيارة أجرة، ونتكدّس على بعضنا البعض سبعة أو ثمانية أشخاص، ننزل إلى منطقة برج الشمالي للتدريب، ونذهب إلى العرقوب، لكني لم أكن عنفياً ولم أقتل أحداً... لم يطلب منا ولو طلب لما قبلنا بالقتال في الحرب الأهلية مع معارضتنا الشديدة جداً للجبهة اللبنانية، ونقدنا الشديد للحركة الوطنية والمقاومة.
* كيف توطدت علاقتك مع منظمة التحرير، ومع أبي عمار تحديداً؟
ـ بدأت العلاقة منذ وجودي في النجف، من مكان يجلس فيه الناس ويراقبون فلسطين. جاءت النكسة، فأحبطنا وبكينا ورحنا نفتش عن فرصة، إلى أن بدأت إذاعة "صوت فتح" تتحدث عن عمليات فدائية. شكلنا لجاناً، وبدأنا نجمع من مصروفنا الضئيل ما نرسله للثوار عبر طالب في جامعة بغداد (الدكتور محمد حُوّر)، كان مسؤولاً طلابياً في "فتح". اشترى كثيرون منا مذياعاً صغيراً، لنبقى على تواصل مع الثورة، كنا نجلس في حوش المنزل أو الحوزة، نتابع الشيفرات، من "أبو الليل إلى أبو أحمد، ومن فلان إلى فلان..." ثم جاءت معركة الكرامة، وكنا قد استكشفنا قبلها أجواء مراجعنا في النجف حول دعم القضية الفلسطينية. بعدها، أحيت النجف ذكرى الرصاصة الأولى سنة 1969، وكان من أضخم المهرجانات، وفي العام الثاني عندما أردنا الاحتفال بذكرى معركة الكرامة والأخضر العربي، منعنا "حزب البعث"، وكادوا يرموننا في السجون، فأحييناه سراً.
جئت إلى لبنان من دون توجه محدد، اقتربت جداً من "فتح" لسبب أساس، هو أنني منذ البداية لم أستطع أن أكون حزبياً، لكن من دون أن أكون معادياً للحزبيين. وجدت "فتح"، مثل النجف فيها حرية إلى حد الفوضى، وفيها أبواب كثيرة للدخول وأبواب قليلة للخروج، لا أحد يحكمنا. بعد أن دخلت في حركة مزارعي التبغ، أصبحت شخصاً معروفاً أكثر، فتنبهت "فتح" لنشاطي. في هذه اللحظة توقفت وقلت لا بد من تصويب خياراتي. قررنا أنا والسيد محمد حسن الأمين ومجموعة من الشباب أن نؤسس مشروعاً مميزاً، يشبه التنظيم المستقل، يجمع بين الوطني اللبناني والفلسطيني والقومي والإنساني والوحدة والحرية والجنوب. كتبنا نصاً وأرسلناه إلى أبي عمار عبر المرحوم هاني الحسن، قصدنا "فتح" تحديداً، لأنها فضاء واسع يحمينا، وتتعامل معنا براغماتياً على الأقل من دون ضرورة للاختزال الأيديولوجي. استدعانا بعدها أبو عمار إلى لقاء وأبدى موافقته، وأعطانا الضوء الأخضر للبدء بالعمل، وأطلقنا على التيار اسم "التوجه".
توثقت علاقتي بحركة فتح وأبي عمار وأبي جهاد أيضاً الذي كان في ذلك الوقت يستقبل القوى الإيرانية المعارضة؛ يدربهم ويُشركهم في القتال، وقد سقط منهم شهداء. كنت بدوري على علاقة بالقيادات الإيرانية في الخارج، وأهمهم جلال فارسي. أصبحت أدعى إلى مواقع الإيرانيين، ونقيم حوارات حول لبنان وفلسطين، وبدؤوا يتابعون أفكاري ويرسلونها إلى النجف. كان تركيز الإمام الخميني حينها على إيران، وكانت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية من أسباب غضبه واعتراضه. جاءني جلال فارسي سنة 1977 وطلب مني أن نشبّك العلاقات جيداً، اتفقنا أن نطلب من أبي عمار توجيه رسالة تعزية إلى الخميني بوفاة نجله في ظروف وجهت الشك إلى السافاك، كتبت الرسالة أنا ووقّعها أبو عمار وحملتها إليه، وجرى حوار طويل وعميق مع الإمام الخميني نُشر بالفارسية والعربية، تناولنا فيه قضية فلسطين ولبنان والمنطقة العربية. بعد ذلك تحولت عملياً إلى ضابط ارتباط بين أبي عمار والخميني. لم أفقد دوري على المستوى المحلي، ولم أقبل أي موقع رسمي في "فتح"، بقيت مستشاراً في قضايا محلية عدة.
* هل نشأت صداقة بينك وبين أبي عمار؟
ـ كانت بيني وبين أبي عمار مودة خاصة جداً وعميقة، كانت علاقتي مميزة مع أبي جهاد أيضاً. أبو عمار يُربك من يختلفون معه أو يتفقون، كان رجلاً إشكالياً في كل شيء، حتى اللغة العربية التي جعلنا نحب أخطاءه فيها ونتفكه بها ونتذكرها وكأنها شعر، ما عدا فلسطين، بل إن إشكالياته كلها كانت، حتى الخطأ كان من أجلها. لم أرَ نرجسياً خفيف الظل في نرجسيته مثله، لكن نرجسيته كلها في خدمة فلسطين، كأنه يختزلها في ذاته، ويضخم هذه الذات في حضرتها، كان في نرجسيته إبداع، كان صعباً ومرناً إلى أقصى الدرجات. فيه شيء قَبلي عشائري، وفيه حداثة حادة، فيه استبداد تفصيلي وديمقراطية عامة، لكنك لن تكون معه على يقين أبداً. أبو عمار حامض وفيه حلاوة خاصة، ولا خلاص منه إلا به. شفيق الحوت ـ رحمه الله ـ بقي يتحدث لساعات عن أبي عمار ناقداً، ثم أردف قائلاً بسخرية: ولكننا نحن نتكلم، وهو يصنع التاريخ.
* من هو أبو جهاد؟
ـ أبو جهاد نمط آخر، جبل ثلج في داخله نار. هو براغماتي فلسطيني، مثل أبي عمار، يواجه الأمور بتأن وبرودة أعصاب مذهلة، وباله في فلسطين على الدوام، زرت تونس مرة والتقيت عدداً وافراً من القيادات الفلسطينية، ولكني لم أرَ فلسطين وانتفاضتها الأولى كما رأيتها في عينيه وحديثه معي وطلباته مني... كان أبو جهاد عملياً ومباشراً، يحب السر ويكره الأضواء إذا كانت قوية وباهرة.
* بعد نجاح الثورة الإيرانية توجهتم إلى إيران برفقة وفد فلسطيني ـ رفيع على رأسه أبو عمار للتهنئة، ماذا عن هذه الزيارة؟
بقي أبو عمار يعذبنا ثلاثة أيام، ثم أبلغنا أننا قد نسافر إلى إيران في طائرة شحن، بعد يومين من الانتظار دق بابي عند الفجر من ليلة صقيع في كيفون، فكان فتحي رفيق عُمر عرفات، وأبلغني بأننا سنذهب إلى الشام الآن. صعدنا في سيارة فولفو ستايشن، سألته أين أبو عمار؟ فأومأ لي أنه هو من يقود السيارة. وصلنا إلى الشام، وجاء الرئيس أبو مازن وحامد أبو ستة وهاني الحسن وآخرون، قال لنا: إننا سنذهب نحن من دونه، فسألته ومن سيرئس الوفد؟ ابتسم وقال: أنت إذا أردت. ثم قال سأرافقكم إلى المطار، دخل برفقتنا إلى صالون الشرف، بعد ذلك صعد معنا إلى الطائرة. المهم دخلنا الأجواء الإيرانية من دون علم الأجهزة بهوية الوفد، وذلك بقرار من أبي عمار خوفاً من بقايا نظام الشاه و"الموساد" والسافاك. كشف الإيرانيون الطائرة، فأرسلوا طائرات "فانتوم" لرصدنا وحاصرونا، وألحّوا على معرفة أسماء الوفد الزائر. في هذه اللحظة، وضع أبو عمار "الفيلد" العسكري على رأسه واستلقى، وراح يطل منه ليجيب عن أسئلتنا وأسئلة الأجهزة الإيرانية. قال لنا: أبلغوهم أننا وفد فلسطيني رفيع المستوى ولا تعطوهم أي اسم حذراً من بقايا السافاك في سلاح الطيران وغيره، كما قال لنا، لكن الإيرانيين علموا أن أبا عمار هو من كان على متن الطائرة بعد اتصال بين بيروت والشام وإيران.
هكذا عادت الطائرات تحيينا، وواكبتنا حتى أرض المطار، وخلال دقائق تحول مطار طهران إلى حشد من الجماهير. استقبلونا بحرارة وكسروا زجاج صالة الشرف من شدة حماستهم، واستقبلنا على أرض المطار الشيخ معزي مبعوثاً من الإمام الخميني، ومن هناك توجهنا مباشرة إلى مقر الإمام في مدرسة فرح وعلوي، حيث أقمنا في طابق، والخميني في طابق. كان المقر مزاراً لجماهير إيران التي كانت تريد أن ترى الخميني وتسمعه، ومع وصول أبي عمار زادت الأعداد وارتفعت الحماسة والهتاف "اليوم إيران وغداً فلسطين" (امروز إيران فردا فلسطين)، و"تحية للخميني سلام إلى عرفات" (درودبر خميني سلام بر عرفات).
* كان اللقاء الأول الذي يجمع الخميني بعرفات؟
ـ كان أول لقاء بين الخميني ومسؤول عربي، كان الجو حاشداً بالعواطف والتبريكات والأحلام. جرت لقاءات شبه عامة، وثلاثة لقاءات خاصة، انحصرت بين الخميني وأبي عمار وجلال فارسي مترجماً، وتركزت على الطرق اللازم اتباعها لحماية الثورة. ولأن أبا عمار قد قرر بالتشاور مع أبي مازن وهاني الحسن أن يكون الأخير أول سفير لمنظمة التحرير في طهران، كان أبو عمار يُطلع الحسن على تفاصيل محادثاته مع الخميني وينقلها لنا على طريقته.
بعد ذلك ظهرت التعقيدات ونَمَت الخلافات بسرعة من دون إفساد الودّ والقضية، والسبب المباشر أن الفلسطينيين لم يكونوا متصورين أن تديّن الإيرانيين تفصيلي وشامل وأساس في بناء العلاقة مع الآخرين، ما تغير لاحقاً بعد ظهور ضرورات الدولة الأقوى من ضرورات وخيارات الدين، وكان الإيرانيون يفترضون أن قداسة فلسطين والقدس، لا بد أن تكون منعكسة عليهم؛ أي أنهم لا بد أن يكونوا ملائكة، هكذا توفر السبب ليظلم كل منهما الآخر عندما يتكاشفون... بالإضافة إلى أنه وبسرعة ظهر اختلاف عميق بين أهداف كل من الطرفين في علاقته بالآخر، كل يريد الآخر كله في مشروعه الوطني... فبدأ التباعد الذي وصل إلى حد القطيعة أحياناً.
إسرائيل عدوّي
* أما زلت ثابتاً على عدائك لإسرائيل؟ وكيف تنظر إلى القضية الفلسطينية اليوم؟
ـ لا عدو لي إلا إسرائيل، لكن عداوتي ليست على النسق العربي المحكوم بالمبالغات التي تنتهي إلى فداحة في التنازلات، أنا أقبل بدولتين وأقبل بدولة واحدة. أقبل بدولة واحدة، وأرجحية لليهود فيها. أوافق على أن يبقى رئيس الدولة الواحدة، حتى آخر العمر يهودياً. لا أريد أن أحل المأساة الفلسطينية بمأساة يهودية أخرى. القضية الفلسطينية هي قضية حق الشعب الفلسطيني أولاً، لها بُعد عربي وديني، لكنها قضية الفلسطينيين بالذات، وتديينها أو أسلمتها هو أسرلة لها، هذا لا يعني أن معناها خالٍ من الدين، إنه غني جداً بالمشترك الروحي الديني وتحت مظلة التوحيد الإبراهيمي، وهذا ما يمكن الاستفادة منه من أجل خلاص القدس وفلسطين من التهويد. إن التنمية هي الحل، وهي المقاومة الحقيقية .
ثقافة وفنون
* لماذا العلاقة متوترة دائماً بين الديني والثقافي؟
ـ التوتر ميزة للديني والثقافي معاً، التوتر الديني يشغل الدين، والتوتر الثقافي يجدّد الثقافة، ويساعد على تبادلها. لكن الديني محكوم بالميل إلى اليقين، إلى الاستقرار على حال والتعميم والسكون، ولا يتحمّل القلق الدائم، بينما الاستقرار هو مقتل الثقافي، وهو مضطر أن يقيم في الشك، وتغيير الخطاب وفقاً للمستجد والمتغير العلمي أو الواقعي أو الاجتماعي. من سكونية الدين كضرورة دينية، وحركية الثقافة، يأتي التوتر الخلاق، ولولاه يستقيل الديني من كل الأسئلة، لأن الثقافي حين يكفّ عن السؤال يصبح دينياً بمعنى طغيان الثوابت على المتغيرات، وتصبح الحياة ذات بعد واحد؛ أي موتاً يشبه الحياة.
*هل تسمع فيروز اليوم؟ أليست الأغاني من الأعمال الحرام؟
ـ ليس صحيحاً، كل ما هو مفيد أو جميل حلال، وحديثاً اشتريتُ 60 أغنية لمحمد عبد الوهاب وغيره. الأغاني الراقية تشعرني بروحانية عالية، وأنا أبحث عن الروح في الطرب، لا أخالف الشرع، ورأيي أن بعض الأصوات الطربية أحنّ وأكثر روحانية من أصوات بعض المنشدين وقارئي الأدعية، بطريقة تبعثر ما فيها من رقة وروح وجاذبية، وتحولها إلى لوائح مطالب شخصية وأنانية من الله. هذه أمور خلافية عند الفقهاء، ما يحرّمها هي اللحظة والمزاج والثقافة، كما تتحكم فيها مزاجية مرجعية مضطرة إلى ترسيخ التقليد، لأن التجديد يؤثر سلبياً على سلطة المرجعية عموماً.
* اهتمامك بالمسرح مثير للاهتمام؟
ـ بدأت حياتي ناقداً أدبياً، كتبتُ في مجلة مواقف قصة قصيرة، وكتبت نصوصاً مسرحية حوارية وإيمائية، قرأت يوسف إدريس وشكسبير وسعد الله ونوس وشتاينبيك وتوفيق الحكيم، وأخذني كل ذلك إلى إصدار كتاب حول المسرح، قدم له روجيه عساف، تحدثت فيه عن التمسرح كما حكاه يوسف إدريس، ونفذه مسرح الحكواتي.
* من يعجبك من المخرجين المسرحيين؟
ـ روجيه عساف أولاً، ويعجبني جواد الأسدي جداً، لكنه متوتر ومكثف فوق ما نتحمله. ولا أنسى يعقوب الشدراوي وكرم مطاوع وآخرين.
* ما تراك كنت لو لم تكن شيخاً؟
ـ كنت أصبحت وكيل مدرس ابتدائي في مدرسة حكومية، أتقاضى مئتين وخمس ليرات في الشهر، وأشارك أمي في زراعة التبغ، وأتزوج امرأة فلاحة تقرأ وتكتب ولو قليلاً، وأبني منزلاً صغيراً أو أضيف غرفة إلى منزل الأسرة. أعيش في قريتي، وأحصل على الثانوية السورية (الموحَّدة) بالانتساب كما فعل أبناء جيلي من فلاحي وعمال الجنوب، وأنتسب إلى الجامعة العربية في بيروت، وأتخصص في الأدب العربي، لأصبح معلماً ثانوياً، وأكون أقرب إلى الله والناس، وقد أكون مشروع شهيد في العرقوب بعد نكسة 1967 وبداية المقاومة. أنا لا أحرّض على الشهادة. أما إذا حصلت، فإني أجلّها.