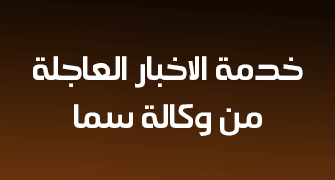عندما تقرأ رواية ما، تعيش مع صاحبها، يصبح هو فرداً من أفراد الأسرة وتصبح هي واحدة من أفراد عائلة كتبك، تنضاف إلى مكتبتك التي تحتوي الغث من المؤلفات والسمين من أمهات الكتب ... وتضيف إلى دائرة معارفك شيئاً أو بعض شيئ. والرواية أو أي نوع من أنواع الكتابة الذي لا يستفزّك – سلباً أو إيجاباً – لا خير فيه. وهذه الرواية "بلاد البحر" استفزّتني ... وقد جاء اسمها ربما من قيساريا أو يافا أو عكا أو حيفا، تلك المدن الرابضة على كتف البحر. فوالد الراوي يؤكد وكتفاه تهتزان: "نعم بلادنا على البحر .. بلادنا على البحر". (ص 205). والبحر هنا هو التراث والتاريخ والماضي والحاضر والمستقبل الذي يشد الكاتب، لا يغرف منه غرفاً عشوائياً، إنما انتقائياً. يدرس التاريخ .. يصفيه، (يفلتره) ثم يدمجه بالحاضر بطريقة سلسة، حتى أنك أحياناً لا ترى نفسك إلا وقد تداخل الماضي بالحاضر، أو تناسلت الأسطورة من الواقع والخيال والحلم الملتصقين عضوياً بهذا الواقع. وقراءة هذه الرواية غير متعبة، وإن كانت مكتوبة على نفس واحد، بدون ترقيم أو عناوين داخلية، لأن أسلوبها رشيق ونقلاتها خفيفة أنيسة كخفة طائر الدوري. يأخذك الكاتب إلى الماضي (عصر المماليك)، يعود بك إلى الحاضر يحلّق بك وبه وأنتما بين مخالب طائر الرخ الأسطوري، ومن عل يريك جغرافية فلسطين وتضاريسها الطبيعية ومدنها وقراها وخربها ومخيمات لاجئيها ... يحلّق حتى ترى مصر وسورية الكبرى، ثم يفلتك الرخ ويرقعك على أرض الواقع . يجبرك بشكل ايحائي أن تلج دروب المستقبل! بعيونك أنت كمثقف عضوي، لا بعيون ذلك المثقف العربي الذي "يقرأ تاريخه بعيون المنهج الذي تعلّمه في الغرب" (ص 82) .
تمّت كتابة هذه الرواية سنة 2006، مرّ عليها حتى الآن حوالي ثماني سنوات. لم يتغيّر شيء ! ما زال موضوعها قائما، وكأنها كتبت الآن ! فكل شيء يراوح مكانه.
نستمع فيها إلى ثلاثة أصوات متداخلة: صوت أبي الفداء الذي عايش آخر فترة المماليك وطرد الفرنجة من آخر معاقلهم بمدينة عكا، وصوت الوالد الذي عايش فترة الانتداب البريطاني والاحتلال الصهيوني، وصوت الكاتب أو أحمد مسعود الذي ذاق ذل الاحتلال وما زال. تتداخل هذه الأصوات الثلاثة تحت ظلال الأجواء السحرية "الواقعية" المضمخة بالأسطورة.
1.أبو الفداء : وهو إنسان العصر الوسيط حيناً وطائر الرخ الأسطوري حيناً آخر أو بساط الريح، به تبدأ الرواية. يحلّق فوق أرض فلسطين التاريخية، فنرى بعينيه مرج ابن عامر حوض ميرمية، والناصرة بنت الشام زهرة خرفيش ليلكية، لا زهرة إيرس الناصرة التي اشتهر بها الجليل.. و"الشام يا مولاي تحملها أجنحة الملائكة، وباركها الله في كتابه، وجعلها قبراً للظُلام والجبابرة." (ص 38) . والكاتب هنا يؤنسن المكان، مرّة أخرى، فيجعل من سفح الوادي كتفاً ولوادي العبهر فماً ولبحر قيسارية جسداً لامعاً وكأنه يقول: ( الدنيا بلا ناس ما بتنداس ) أو أن المكان بدون سكّان خواء. ولنلاحظ أن أبا الفداء ذو نفس إسلاموي، يصف غزوات الفرنجة وحكمهم بمئة عام ثقيلة على أمة الإسلام. أين المسيحيون العرب وذودهم عن البلاد كتفاً إلى كتف مع إخوتهم المسلمين العرب؟ وفي الوقت ذاته يؤكّد الكاتب أن "المسيحية الغربية لا تشبه المسيح ولا علاقة له بها" (ص 198) . لكن أبا الفداء يصرّ على الحاكمية الإلهية مثل المودودي أو التسيّد الإلهي مثل الجلفانيين (بالجيم المعطّشة المصرية) : "سلطة الله فوق سلطة الحاكم، وسلطة الحاكم فوق سلطة الناس، وما بين الحاكم والناس أهل الحل والعقد. هذه ديمقراطية من نوع مختلف." (ص 87). أليست هذه شريعة الوهابية وأبي الأعلى المودودي الأب الروحي لحركة الإخوان المسلمين؟ يقف السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون في عكا أمام جنده محاولاً أن تكون لغته العربية سليمة: "يا جند الإسلام .. هذا اليوم يومكم .. هذه المدينة التي أمامكم هي آخر ما بقي للغزاة في بلاد الإسلام .. سنخلّص العباد من شرورهم وخبثهم .. الله يراكم ويحميكم .. ستكملون ما بدأه من سبقكم .. وستذكرون إلى أبد الآبدين... الله أكبر.. " (ص 218) . كلنا ندرك أن الدافع الديني مهم، لكننا ندرك أيضاً أن الحروب الصليبية اتخذت من الدين ستاراً لأطماعها الاستعمارية . فهل علينا مقاومته تحت ستار الدين أيضاً؟ خصوصاً في العصر الحديث! ومن هنا علينا التأكيد والعودة على التأكيد على دور مسيحيي الشرق العرب في وقفتهم مع إخوانهم المسلمين العرب وغير العرب ضد هذه الحروب والهجمة الاستعمارية. خاصة في ظل الحرب الدائرة اليوم تحت ستار الدين على الأقباط في مصر وعلى مسيحيي سورية ولبنان .. وفلسطين، حرق الكنائس في غزة وحرق الإنسان العربي المسيحي في أرجاء الثماني وأربعين بالخدمة المدنية والتجنيد لجيش الاحتلال الصهيوني. يقولون عكا وخمة بفرنجتها، أما مصر فوخمها من الإخوان المسلمين وسورية من الوهابية والإخوان وكل مشتقاتهما المتعصبة تعصباً أعمى والبعيدة عن روح الإسلام السمح بعد الأرض عن السماء . وبحر الجليل قرئ وكتب من جديد وما عاد المسيح يمشي عليه الهوينا ... في عصر أبي الفداء رزحت البلاد مئة عام تحت حكم الفرنجة، لكن مئة الكاتب أدهى وأمر .. وأشد الأوجاع الحاضرة .. وهو يكتب عن التاريخ لكي ينسى لحظته ! والتذكر جزء من الحياة .. التذكر هو الماضي .. وتاريخ الأمم هو مستقبلها ! (ص 43) . من غير المعقول أن نجابه الحركة الصهيونية بنفس الأدوات التي جابهنا بها الحملات الصليبية ! وقد اختلفت لغة العصر.
2.الوالد : فلاح يبخن الأرض وما فيها من نبات وأشجار وما عليها من حيوان . حيوانه المفضّل هو النيص، حوله حاك الحكايات والأساطير . فهو مثلنا يبكي وينوح، مثلنا يرجو ويأمل، مثلنا يغضب، يرمي إبره على عدوّه فيصيبه، يجوب البراري في الليل فقط تجذبه الثمار والجذور وهو بكّاء، وكثيراً ما يصطاده الإنسان ثم يطلق سراحه لبكائه الذي يزلزل القلوب، النيص كائن نبيل، وحيد، متفرّد، ألمه عميق وحقده أعمق! (ص63). والنيص يشبه هذا الوالد الذي يتقمصه في كثير من الأحيان، فهو البكّاء الوعري، يتحوّل في الليل إلى نيص يطارده الصيادون فيما هو يطارد رائحة بحر قيسارية التي تكون أقوى في الليل. يقول لا تنسى يا ولدي قيسارية! "إذا كنت تحب هذه الأرض فعليك أن تقرأها دائماً .. تقرأها بيديك وقلبك وعينيك وفمك" (ص 124). أما الوالدة فكانت تحلم كثيراً "وما يحلم به الإنسان يتحقق. لا شيء عصيا عن الحدوث" (ص 206). "والبلاد تحدد بالأحلام" (ص 211) وكانت تغني أغاني حزينة قديمة عن أراضي وسكان قاقون الذين هُجّروا إبان النكبة، وتحكي الحكايات التي لا تنسى، رغم كونها أُميّة. وعندما توفاها الله روّدت لها نساء يتّشحن بالبياض على طريقة طولكرم ودير الغصون . والترويد هو التحنين بلهجة الجليل.
3.الكاتب أو أحمد مسعود : أنت تسأل : لماذا الإنسان لا يؤنسن عدوه ويحتقره؟ هولاكو بضخامته ودقته وملامحه التي تشبه ملامح الأفعى في قيظ آب وهو رجل كبده متقيّح، خفيف اللحم، ولا أحشاء له، له وجه سحلية، بلفور ولورنس "العرب" لوطيان ... هل لأن الظالم يسلب منا حتى مشاعرنا الطيبة؟ هل لأنه يحتقرنا فنرد عليه بالمثل؟ والشتيمة في محلّها حسنة! أم أن المهزوم عادة يشتم؟ "أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل"! يقرأ الكاتب في كتاب الذل: الاحتلال .. ويحدّثنا عن موبقاته وممارساته وعن القتل والاعتداء والاغتصاب الذين يحتاجون إلى أوهام كبيرة، وعن اليأس الذي يدفع إلى الخيال وعن الخيال الذي يؤدي إلى الوهم وعن الوهم الذي يدفع إلى القتل... يحدّثنا عن أوسلو ويحاول تبريره : "الاتفاقات الرديئة قد تقود إلى نتائج جيدة، حسابات القوي لا تتحقق دائماً..." (ص 151). وينزلق في خطاب سياسي (بعكس الخطاب الروائي) سلطة فلسطينية ضعيفة تعني دجاجة تبيض ذهباً لإسرائيل.. والغرب الذي صاغ اتفاق أوسلو لم يعد يرى في الفلسطيني ثائراً.. ربما كل هذا صحيح، لكنه خطاب سياسي مباشر على حساب الخطاب الروائي . وواقع الحال في المناطق المحتلة 67 يعيدنا إلى الوراء أكثر من مئة عام .. إذا لم تكن ذئباً أكلتك الكلاب .. وإذا لم تكن ذا عشيرة أو تنظيم على شكل عشيرة فعليك السلام.. فغياب سلطة القانون يدفعك إلى الارتماء في أحضان القبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو العائلة . (ص 162،153) صحيح أن الاحتلال هو الهم الأكبر، لكننا لا نستطيع ومن غير المعقول أن نعلّق كل أخطائنا وخطايانا على مشجبه! فرئيس محاصر ومدينة لاهية لا يستويان، تلك مدينة لا يُغفر لها بعرف الكاتب ! وقائد ميداني "مؤنجز"، لا يغفر له حين يُعكرت ويجمع أموالاً طائلة ويتزوّج امرأة أخرى.. وسكرتيرة تكشف عن سيقانها وتقود أثخن شنب وتلمس مسؤولها - بالمعنيين اللمس والمس- وتصبح الآمرة الناهية بمكتب حكومي، شيء معيب . ويتابع الكاتب قراءته في كتاب أسرار الدولة ليقول: "القانون – هذا الغائب المشتهى- لا يفرض بالأسلحة فقط ... عندما تنهار الدولة ينهار المجتمع، وعندما ينهار المجتمع تنهار الدولة . المجتمع يبني الدولة، الدولة لا تبني المجتمع." (ص 155) . والآن ماذا لدينا في المناطق المحتلة؟ سلطة محاصرة بالاحتلال والمواثيق الدولية من جهة، ومحاصرة من شعبها حيث لا يمكنها الوقوف أمام طموحاته من الجهة الأخرى.. اتفاقات رديئة وشعب لا يقبل. "يوم الحساب ضرورة عقلية وليس دينية فقط" (ص 257) ربما! ولكن يوم الحساب الدنيوي أكثر عقلانية... ويوم يقرأ الكاتب في كتاب أسرار الدولة، تدور عليه الدوائر، يتهم بالجاسوسية والعمالة، لأنه "فضح الطابق".
قلت منذ البداية أن في هذه الرواية تكنيكا جديدا بتداخل الأزمنة واختلاطها عبر أصواتها الثلاثة .. لكن بين هذا وبين خلط المفاهيم والتعميم بون شاسع .. صحيح أن الحملة الصليبية العاشرة عملت على تغيير وعينا بحيث صرنا نحتقر ثقافتنا مثلهم. فهل حقاً نحن نحتقر ثقافتنا قشة لفة؟ وهل "مثقفنا مغتصب في محاولاته الدائبة للتوفيق والتلفيق ما بين ماض تليد وحاضر كالعمى"؟ (ص 263-262) أم أن بعض مثقفينا هم كذلك؟ هل حقاً أقنعونا أن تحرير المرأة – لا الرجل – هو شرط ضروري للتقدم، وأن هجر الزراعة والحرف جزء من الإندماج في العالم ؟ أنت تعتقد أن تحرير المرأة والرجل معاً مرتبط عضوياً بالتقدم، وانت تعتقد أن الإسلام السلفي لا يتلاءم مع روح العصر، وأن الدين شيء والسياسة شيء آخر وأننا لن نتطوّر ونلحق بروح العصر بدون الفصل بينهما. أنت تعتقد بذلك دون أن يقنعوك "أن الإسلام مرجعية لا تتلاءم ومرجعيات المجتمع الدولي...الفرنجة الجدد" كما يقول الكاتب. لأن الفصل بين الدين كمعطى إلهي والدولة كمعطى بشري شرط التقدم.
خبر : "بلاد البحر" رواية لأحمد رفيق عوض والكتابة على سطح الماء !
الأربعاء 19 فبراير 2014 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT